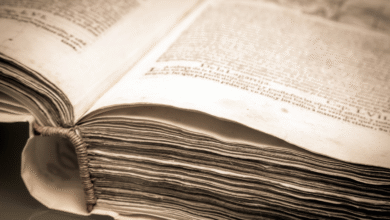وموعظة للملحدين
إن المشكلة مع الملحدين أنهم – حسب قولهم – لا يؤمنون بشيء لا تدركه الحواس، أو لا يمكن لمسه وإخضاعه للفحص المجهري الدقيق.
ونسوا أن العقل الذي به يفكرون ويستنتجون ويحللون وينتقدون.. هو نفسه ليس شيئًا مادياً ملموساً، فلا يمكنك مثلاً رؤية الأفكار وهي تهوي لتستقر في دماغك، أو وضع يدك عليها لتحليل ماهيتها تحت مجهر مختبرك؛ ومع ذلك يؤمنون بقدرة عقولهم “الخارقة” بل يجعلونها حكماً وفيصلاً يفرقون به بين ما هو صحيح وخاطئ، فهو إلههم المعبود الذي له الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء.
إنهم يسبحون عكس التيار، ويبغون إسقاط الشمس الساطعة بسهم من السفسطة العقيمة والجدال المتكلف الذي لا طائل من ورائه: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (الصف:08). إنهم في صراع مرير مع أنفسهم، يكتوون بناره ويحترقون بلهيبه المشتد المستعر، فالملحد جلاد قاسٍ اختار نفسه ضحية لسياطه المؤلمة، إنه يحاول جاهداً كتمان صرخات فطرته الثائرة، فطرة تنادي بصوت الإيمان المستقر داخل كل نفس فلا يمكن إسكاته: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾(الروم:30).
خومهما طال كتمان هذا النداء الفطري: فإنه حتما سيخرج عن سيطرة جلاده ليهتف بالحقيقة الخالدة: حقيقة وجود مسبب لهذا الكون العظيم؛ هو الذي سواه من عدم وأنشأه في أحسن تقويم وأدق تصميم، ذلكم الخالق هو “الله” بما له سبحانه من حكمة بالغة وحسن تدبير وقدرة لا حدود لها.
وفي الحقيقة لا يمنع الملحد من التصريح بوجود ربه سوى الكبر والتعالي، والعزة بالإثم، وحب التفرد والتميز؛ إنه كالمنتحر الذي يضع حداً لحياته حتى يلفت الأنظار من حوله، بل هو أسوأ حالاً منه، حيث أقدم “المسكين” على قتل ضميره وإحساسه فهو يعاني ألم الموت قبل أن يموت، أي أنه في انتحار يومي مستمر يوجه فيه إلى صدره طعنات مسمومة بخنجر العناد والتمرد.
ولذلك تراهم يطالبونك دائما بأمور مستحيلة يتهربون بها ممن يحاصرهم بالحجة ويكشف عوارهم وفساد مذهبهم، فيقولون: ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (النساء: 153) فيطالبونك بتحويل الغيبيات إلى مرئيات؛ وهذا عين الجبن والفرار من سطوة الحق وصولته: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾(الروم:21).
فمصيبتهم ليست في الجهل وغياب الدليل، وإلا لهان الخطب وسهل إرجاعهم إلى الجادة؛ ولكن الأمر أخطر بكثير: فما يصدهم عن الهدى بعد إذ جاءهم فكر معوج مختل يرى العبودية لله تخلفاً، والاستسلام له دناءة ورجعية وسداً لباب العقل والتفكير والتقدم العلمي؛ فالدين في نظرهم رمز الظلامية والتقهقر، وعنوان السذاجة والتأخر، بينما الإلحاد عندهم دليل التقدم والتحضر، ومظهر اليقظة الفكرية والتفوق الثقافي والحضاري.
ولذلك فهم يفسرون حاجة الإنسان الفطرية إلى الإله بأنها نتيجة لعجزه قديماً عن التحكم في ظواهر الطبيعة والكون وتفسيرها بطريقة علمية، فيعبر عن خوفه وخضوعه لسيد هذا الكون بعبادته وتقديم القرابين إليه؛ أما وقد تطورت حياة البشر في العصر الأخير، فلا يوجد ثمة داع إلى ذلك “الإله” بفضل التقدم الهائل الذي أحرزه العلم الحديث والذي أغنى في نظرهم عنه، وبالتالي يصبح وجوده بالنسبة إليهم مجرد فكرة وهمية، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيراً.
ولكن اللغز الذي حير عقولهم وزلزل كيانهم وجعل بعضهم يستيقظ ويتراجع: هو الموت؛ هذا الحدث الرهيب المهيب الذي لا بد لكل حي من ملاقاته، ولا يمكن لأي أحد الفرار منه، فليبحثوا له عن تفسير، وليحاولوا إيجاد طريقة للإفلات منه: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (النساء: 78) ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ (الجمعة:08)؛ وقد تحداهم الله سبحانه بإرجاع الروح قبيل خروجها من الجسد لحظة الاحتضار، حتى يبين لهم مدى ضعفهم وقلة حيلتهم:﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) ﴾ (الواقعة). أي: فإن كنتم محقين في دعواكم أنه ليس ثمة حساب ولا بعث، فأعيدوا الحياة إلى من انتهى أجله، وامنعوا الموت من أخذ أرواحكم بغير إذنكم.
إن حلول الوفاة عليكم قسراً وقهراً: لدليل قاطع على وجود قوة أعلى تستحيل مواجهتها والوقوف في وجهها، وليست إلا قوة الله جل جلاله؛ إنه الرب القدير الذي تذل له رقاب المتكبرين، وتنحني له جباه المتجبرين. فإن كان العلو على الله والجحود به أمضى سلاحكم، فلستم أشد من فرعون في ذلكم: فقد ادعى أنه الرب الأعلى، وطغى في الأرض وبغى، وكفر بآيات موسى كلها ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ (النمل:14).