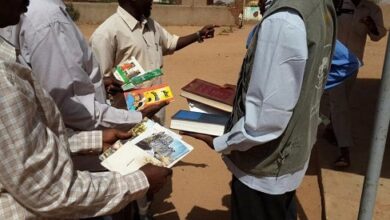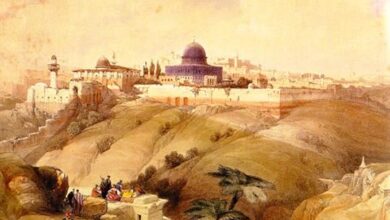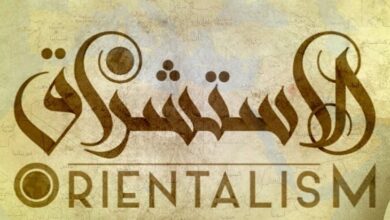نبذة مختصرة عن كيفية الرد العقلي على من أنكر أو شك في وجود الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فمما لاشك فيه أن الحديث كثر عن الإلحاد، الذي هو إنكار وجود الله تعالى، أو الشك فيه، وما يتبع ذلك من الإنكار للأديان والنبوات، والوحي والشرائع، والبعث، وسائر أمور الغيب.
فقد قال الكفار لرُسلِهم لما دعَوْهم إلى عبادة الله وحده: ﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: 9].
فكان جواب رسلهم: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: 10]، فيكون جوابنا على الملحد هو نفس جواب الرسل عليهم السلام: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: 10]، هذا استفهام إنكار؛ أي: لا شكَّ في الله.
قال ابن كثير – رحمه الله -: “وهذا يحتمل شيئين:
أحدهما: أفي وجوده شك؛ فإن الفِطَرَ شاهدةٌ بوجوده، ومجبولة على الإقرار به؛ فإن الاعتراف به ضروري في الفِطَر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه ﴿ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: 10]، الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق؛ فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء، وإلهه، ومَلِيكه.
والمعنى الثاني في قولهم: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ ﴾ [إبراهيم: 10]؛ أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات، ولا يستحق العبادة إلا هو، وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زُلْفَى”1.
فرد شبهات هؤلاء الملاحدة يكون:
أ – بالأدلة النقلية: (القرآن)، و(السنة الصحيحة).
ب – وبالأدلة العقلية الصريحة؛ فقد ضمَّن عز وجل كتابه من الأدلة العقلية في أمر المعاد ما هو بين لعامة العباد؛ فاستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها استدلال عقلي حسي، فهو حسي؛ لأنه مشاهد، وهو عقلي؛ لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تمامًا؛ فإن الله تعالى يحيل على العقل في مسائل كثيرة، مثل: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: 65]، فكيف يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا وكتابُ اليهود والنصارى لم ينزل إلا من بعد إبراهيم عليه السلام؟! فهذا خلاف العقل، فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليلًا، ولكن بشرط ألا يخالف الشرع.
وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: “بيان الاحتجاج بالعقل؛ لقوله: ﴿ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: 65]، فكيف تحاجُّون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده؟! وهذا خلاف العقل، ويتفرع على هذه الفائدة: أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص؛ فالناس في الاستدلال بالعقل طرَفان ووسط: طرف غلا فيه حتى قدَّمه على السمع، وذلك بالنسبة للفقهاء من أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص..وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدَعون السمع، مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهاتٍ، وليس براهين ودلالات، لكنهم ينظرون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه، ويقتضي نَفْيَ كذا فينفُونه، ولا يرجعون في هذا إلى السمع، ومن ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، كل من نفى صفة أثبتها الله لنفسه بشبهة عقلية، فإنه داخل فيمن يغالي في الاستدلال بالعقل.
الطرف الثاني: من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية، وقال: ليس للعقل مدخل في إثبات أي حُكم أو أي خبر، فأنكروا القياس، وهذا مثل أهل الظاهر، أنكروا نهائيًّا، وقالوا: لا يمكن أن نرجع للعقل في شيء..
ومِن الناس مَن هم وسط: رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع؛ لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة، مثل: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 44]، ومثل هذه الآية: ﴿ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: 65]، واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها استدلالٌ عقلي حسي؛ فهو حسي؛ لأنه مشاهَد، وهو عقلي؛ لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تمامًا.
فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليلًا، ولكن بشرط ألا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول: إنه ليس بعقل؛ لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدًا، لكن إذا ظن أن العقل يخالفه، فإما أن تكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمعُ غير ثابت، وإما أن يكون العقل غير صحيح، ملوَّثًا بالشبهات والشهوات”2.
ومن هنا يكون الجواب على الملحدين بالأدلة العقلية:
فقد تقرر في العقول أن الموجود لا بد من سبب لوجوده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: “وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجِد”3، وهذا يدركه كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء، وهو الذي يعرف عند العلماء باسم: (قانون السببية)، هذا القانون يقول: “إن شيئًا من الممكنات لا يحدُثُ بنفسه من غير شيء؛ لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، “ولا يستقلُّ بإحداث شيء”؛ لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئًا لا يملكه هو4.
ويقول ابن عثيمين – رحمه الله -: “فأما دلالة العقل، فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها، أو وُجِدت هكذا صدفة؟
فإن قلت: وُجِدت بنفسها، فمستحيل عقلًا ما دامت هي معدومة! كيف تكون موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذًا لا يمكن أن توجِدَ نفسها بنفسها، وإن قلت: وُجدت صدفة، فنقول: هذا يستحيل أيضًا، فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون، فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار، وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدًا”5.
ومنذ سنوات تكشَّفَتِ الرمال في صحراء الربع الخالي – إثر عواصف هبت على المنطقة – عن بقايا مدينة كانت مطموسة في الرمال، فأخذ العلماء يبحثون عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذي بنيت فيه، ولم يتبادر إلى ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وُجِدت بفعل العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة، لا بفعل الإنسان.
ولو قال بذلك واحد من الناس، لعدَّه الناس مخرفًا يستحق الشفقة والرحمة، فكيف لو قال شخص ما: إن هذه المدينة تكونت في الهواء من لا شيء في الأزمنة البعيدة، ثم رست على الأرض؟ إن هذا القول لا يقلُّ غرابة عن سابقه، بل يفُوقه.
لماذا؟ لأن العدم لا يوجِد شيئًا، هذا أمر مقرَّر في بدائه العقول، ولأن الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه.
والمدينة على النحو الذي نعرفه لا بد لها من موجِد، والفعل يَشِي ويُعرِّفُ بصانعه؛ فلا بد أن تكون المدينة صناعةَ قوم عقلاء يحسنون البناء والتنسيق 6.
ويقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بأوضح عبارة، حيث قال: “إن حدوث الحادث بلا محدِث أحدَثه معلوم البطلان بضرورة العقل، وهذا أمر مركوز في بني آدم، حتى الصبيان، لو ضُرب الصبي ضربة فقال: مَن ضربني؟ فقيل: ما ضربك أحد، لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل.
ولهذا لو جوَّز مجوِّز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدِث لذلك، لكان عند العقلاء إما مجنونًا، وإما مسفسطًا؛ كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية، وكذلك معلوم أنه لم يحدِث نفسه، فإن كان معدومًا قبل حدوثه لم يكن شيئًا، فيمتنع أن يحدِث غيره، فضلًا عن أن يحدِث نفسه”7.
ولنضرب أمثلة نوضح بها كيف استخدم الأئمة العلماء وغيرهم الأدلة العقلية في إثبات وجود الخالق:
أ – قال بعض الأعراب، وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير؛ فسماءٌ ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟8.
ب – وحُكي عن الإمام أبي حنيفة: أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أُخبرت عنه؛ ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة، فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل، فقال: وَيْحَكُمْ! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟! فبُهت القوم، ورجعوا إلى الحق، وأسلموا على يديه9.
ج – وحكي عن الإمام مالك: أن الرشيد سأله عن ذلك؛ فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات10.
د – وحُكي عن الشافعي: أنه سُئل عن وجود الصانع، فقال: هذا ورق التوت، طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرًا وروثًا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد11.
هـ – وحُكي عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حِصن حصين أملس، ليس له باب ولا منفذ، ظاهرُه كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير، ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة12.
و- وقال الإمام الخطابي: “ثم أمَر في آية أخرى بالنظر فيهما – أي في خلق السموات والأرض – فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: 101]، يعني – والله أعلم – مِن الآيات الواضحات، والدلالات النيرات، وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك، واعتبرتها بفكرك، وجدته كالبيت المبني المُعدِّ فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب، مستعملة في المرافق، والإنسان كالملك للبيت المخول ما فيه، وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعًا حكيمًا، تام القدرة، بالغ الحكمة”13.
ز- قال ابن كثير: “فإن مَن تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها، ووضعها في مواضع النفع بها محكمة – علِم قدرة خالقها وحكمته وعِلمه وإتقانه وعظيم سلطانه”14.
وسُئل أبو نواس عن ذلك فأنشد:
تأمَّلْ في نبات الأرض وانظُرْ … إلى آثارِ ما صنَع المَلِيكُ
عيونٌ مِن لجينٍ شاخصاتٌ … بأحداقٍ هي الذَّهب السَّبيكُ
على قُضب الزَّبرجد شاهداتٌ … بأن اللهَ ليس له شريكُ
وقال ابن المعتز:
فيا عجبًا كيف يُعصى الإل … ـه أم كيف يجحَده الجاحدُ
وفي كلِّ شيءٍ له آيةٌ … تدلُّ على أنَّه واحدُ15
وهنا نذكر كيفية الرد على الملاحدة من خلال الأدلة العقلية التي نبه عليها القرآن الكريم، فلو نظرنا إلى قول الله عز وجل: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: 35].
نجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: “وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار؛ ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فِطرية بديهية مستقرة في النفوس، لا يمكن لأحد إنكارها؛ فلا يمكن صحيحَ الفطرة أن يدَّعيَ وجود حادث بدون محدِث أحدثه، ولا يمكنه أن يقول: هذا أحدَث نفسَه”16.
ومِن هذا المنطلق يقول الشيخ السعدي – رحمه الله -: “وقد تقرر في العقل مع الشرع: أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور:
إما أنهم خُلقوا من غير شيء؛ أي: لا خالق خلقهم، بل وُجدوا من غير إيجاد ولا موجِد، وهذا عين المُحال.
أو هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضًا محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم.
فإذا بطَل هذان الأمران، وبان استحالتهما، تعيَّن القسم الثالث: أن الله الذي خلقهم، وإذا تعيَّن ذلك، علم أن الله تعالى هو المعبود وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلُحُ إلا له تعالى”17.
وبنحو ذلك يقول الشيخ الشنقيطي – رحمه الله -: “ومن أمثلة السَّبر والتقسيم في القرآن: قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: 35]، فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح، الأولى: أن يكونوا خُلقوا من غير شيء؛ أي: بدون خالقٍ أصلًا، الثانية: أن يكونوا خلَقوا أنفسهم، الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم، ولا شك أن القسمين الأولين باطلان، وبطلانهما ضروريٌّ كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه؛ لوضوحه، والثالث هو الحق الذي لا شك فيه: أنه هو جل وعلا خالقهم، المستحقُّ منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا”18.
وقال أيضًا: “ومثال ما كان الحصر والإبطال فيه قطعيين قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: 35]؛ لأن حصرَ أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيه؛ لأنهم إما أن يُخلَقوا من غير شيء، أو يخلُقوا أنفسهم، أو يخلُقهم خالق غيرُ أنفسهم، ولا رابع ألبتة، وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك فيه؛ فيتعيَّن أن الثالث حق لا شك فيه، وقد حُذِف في الآية؛ لظهوره، فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعيةٌ لا شك فيها”19.
فحينئذ يكون العقل دالًّا دلالة قطعية على وجود الله.
قال ابن عثيمين – رحمه الله – في بيان كيفية الرد على الملاحدة: “نرد على هؤلاء بما ذكره الله تعالى في سورة الطور: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: 35، 36]، فنسألهم أولًا: هل هم موجودون بعد العدم، أو موجودون في الأزل وإلى الأبد؟ والجواب بلا شك أن يقولوا: نحن موجودون بعد العدم؛ كما قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: 1]، فإذا قالوا: نحن موجودون بعد العدم، قلنا: مَن أوجَدكم؟ أوجدكم أبوكم أو أمُّكم أو وجدتم هكذا بلا موجِد؟ سيقولون: لم يوجِدْنا أبونا ولا أمُّنا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ * نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: 58 – 61]، إذا قالوا: وُجدنا من غير موجِد، نقول: هذا مستحيل في العقل؛ لأنه ما من حادث إلا وله محدِث، وحينئذٍ يتعيَّن أن يكون حدوثهم بمحدِث، وهو الله عز وجل الواجب الوجود، وكذلك يقال في السموات والأرض: نقول: مَن أوجَد السموات والأرض؟ هو الله عز وجل، لكن السموات والأرض كانت ماءً تحت العرش، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود: 7]، فخلق الله عز وجل السموات والأرض من هذا الماء؛ قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء: 30]؛ أي: فصلنا ما بينهما، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأنبياء: 30]، فهذا جواب على هؤلاء الملاحدة، فإن أبَوْا إلا ما كانوا عليه، فهم مكابِرون، ويحق عليهم قول الله تعالى في آل فرعون: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل: 14]”20.
ومعلومٌ أن من النظر العقلي استنتاج وجود من وجود، وهذا معروف، قال الشيخ الشنقيطي – رحمه الله -: “مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود خالق هذا الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة، الدالة على أن له خالقًا مدبرًا هو الرب المعبود وحده؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 190]، فبيَّن أن وجود هذا الكون دليلٌ على وجود صانعه، فهو وجود يلزم منه عقلًا وجودُ خالقٍ مدبِّرٍ، هو الرب المعبود”21.
وهنا أختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – الذي أشار فيه إلى العلاقة بين الدليل السمعي والعقلي في إثبات الخالق سبحانه، ونحو ذلك، حيث قال: “بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات الصانع، ودلائل ربوبيته وقدرته، وبيان آيات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النُّظَّار22“23.
فائدة حول قول الملاحدة: إن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون! والأجوبة على ذلك كثيرة جدًّا، ومعروفة، ولا سيما في أقوال المعاصرين، لكن أعجبني ما وقفتُ عليه من كلام نفيس للإمام ابن القيم – رحمه الله – يرد فيه على هذه الفِرْيَة، فقد فنَّدها بأوضح عبارة، وبطريقة تتلقاها العقول السليمة بالتسليم، فقال: “على أنك لو تأملت قولك: طبيعة، ومعنى هذه اللفظة، لدلك على الخالق البارئ لفظُها، كما دل العقول عليه معناها؛ لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة؛ لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه؛ كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة؛ فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه، ومعلوم أن طبيعةً مِن غير طابع لها محال؛ فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه، والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلقٌ من خلق الله مسخَّر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء، وكما شاء، فيسلُبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء؛ ليرى عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء، و﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: 82]، وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته؛ فكيف يحسُنُ بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها، ويحيل الصنع والإبداع عليها، ولم يزلِ الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 54]؟!”24.
قال الشنقيطي – رحمه الله -: “وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف”25.
ولا مانع مِن أن يضاف إلى هذا الرد النفيس: ما أورده الدكتور عمر سليمان الأشقر – رحمه الله -: “قالوا: الطبيعة هي الخالق، وهذه فِرْيَةٌ راجت في عصرنا هذا، راجت حتى على الذين نبغوا في العلوم المادية، وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بها، فقالوا: الطبيعة هي التي توجِد وتُحدِث.
وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجَدته وأبدَعته؟
إذا قالوا: نعني بالطبيعة الكون نفسه، فإننا لا نحتاج إلى الرد عليهم؛ لأن فساد قولهم معلوم مما مضى، فهذا القول يصبح ترديدًا للقول السابق: إن الشيء يوجد نفسه؛ أي: إنهم يقولون: الكون خلق الكون؛ فالسماء خلقت السماء، والأرض خلقت الأرض، والكون خلق الإنسان والحيوان، وقد بينا أن العقل الإنساني يرفض التسليم بأن الشيء يوجِد نفسه، ونَزيد الأمرَ إيضاحًا فنقول: والشيء لا يخلق شيئًا أرقى منه؛ فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لا تملِك عقلًا ولا سمعًا ولا بصرًا، فكيف تخلُقُ إنسانًا سميعًا عليمًا بصيرًا؟! هذا لا يكون.
ويرى فريق آخرُ أن الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون، وهذا تفسير الذين يدَّعون العلم والمعرفة من القائلين: إن الطبيعة هي الخالق، فهم يقولون: إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيِّرُه وتنظم أموره في كل جزئية، والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين، مثله كمثل الساعة التي تسير بدقة وانتظام دهرًا طويلًا، فإنها تسير بذاتها بدون مسيِّر.
وهؤلاء في واقع الأمر لا يجيبون عن السؤال المطروح: من خلق الكون؟
ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بها، هم يكشفون لنا كيف تعمل القوانين في الأشياء، ونحن نريد إجابة عن موجِد الكون، وموجِد القوانين التي تحكُمُه.
يقول وحيد الدين خان في “الإسلام يتحدى”: “كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطر، لكننا اليوم نعرف كل شيء عن عملية تبخُّر الماء في البحر، حتى نزول قطرات الماء على الأرض، وكل هذه المشاهدات صور للوقائع، وليست في ذاتها تفسيرًا لها؛ فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه الصورة المفيدة المدهشة، حتى إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية.
إن ادعاءَ الإنسان – بعد كشفِه لنظام الطبيعة – أنه قد كشف تفسير الكون ليس سوى خدعة لنفسه؛ فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة الأخيرة.
إن الطبيعة لا تفسر شيئًا (من الكون)، وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير.
واقرأ هذه المحاورة التي يمكن أن تجري بين رجل نابهٍ وأحد الأطباء الأفذاذ في علمهم:
السائل: ما السبب في احمرار الدم؟
الطبيب: لأن في الدم خلايا حمراء، حجم كل خلية منها: 1/700 من البوصة.
السائل: حسنًا، ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء؟:
الطبيب: في هذه الخلايا مادة تسمى (الهميوجلوبين)، وهي مادة تحدث لها الحمرة حين تختلط بالأكسجين في القلب.
السائل: هذا جميل، ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل (الهميوجلوبين)؟
الطبيب: إنها تصنع في كبدك.
السائل: عجيب! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد وغيرها، بعضها ببعض، ارتباطًا كليًّا، وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه الدقة الفائقة؟
الطبيب: هذا ما نسميه بقانون الطبيعة.
السائل: ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيادة الطبيب؟
الطبيب: المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية والكيماوية.
السائل: ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائمًا إلى نتيجة معلومة؟ وكيف تنظم نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء، ويعيش السمك في الماء، ويوجد إنسان في الدنيا، بجميع ما لديه من الإمكانات والكفاءات العجيبة المثيرة؟
الطبيب: لا تسألني عن هذا؛ فإن عِلمي لا يتكلم إلا عما يحدُث، وليس له أن يجيب: لماذا يحدُث؟
يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب وراء هذا الكون: إن مثل الكون كمثل آلة تدور تحت غطائها، لا نعلم عنها إلا أنها تدور، ولكن لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه الآلة بدوائر وتروس كثيرة، يدور بعضها ببعض، ونشاهد حركاتها كلها، هل معنى هذا أننا قد علمنا خالق هذه الآلة بمجرد مشاهدتنا لما يدور بداخلها؟ كيف يفهم منطقيًّا أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الآلة جاءت من تلقاء ذاتها، وتقوم بدورها ذاتيًّا؟! لو لم يكن هذا الاستدلال منطقيًّا، فكيف إذًا نثبت بعد مشاهدة بعض عمليات الكون أنه جاء تلقائيًّا ويتحرك ذاتيًّا؟”26.
وفي الختام أقول: إنه ينبغي على المسلم أن يقف مع قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [آل عمران: 60]؛ أي: الشاكِّين في شيءٍ مما أخبرك به ربُّك، وقد أخذ الشيخ السعدي – رحمه الله – من هذه الآية قاعدةً شرعية هامة، حيث قال: “وفي هذه الآية دليل على قاعدة شريفة، وهي أن ما قامت الأدلة على أنه حقٌّ وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شُبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواءٌ قدَر العبدُ على حلها أم لا، فلا يوجِب له عَجْزُه عن حلِّها القدحَ فيما علِمَه؛ لأن ما خالف الحق فهو باطل؛ قال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ [يونس: 32]، وبهذه القاعدة الشرعية تنحلُّ عن الإنسان إشكالاتٌ كثيرة يوردها المتكلمون، ويرتِّبها المنطقيون، إن حلَّها الإنسان فهو تبرُّعٌ منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه”27.
فهذه المعاني هي محور ردنا على تيارات الإلحاد، فهي تزيد المؤمن إيمانًا على إيمانه، وهي طريق إلى الهداية، وإزالة الشُّبَه – بإذن الله تعالى – لِمَن تأمَّلها وأحسَن تلقِّيَها، وهي حجةٌ على المعاند المكابر، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- تفسير ابن كثير (4/ 482). ↩︎
- تفسير سورة آل عمران (1/ 379 – 380). ↩︎
- مجموع الفتاوى (3/ 8). ↩︎
- مستفاد من “العقيدة في الله” لعمر سليمان الأشقر (ص/ 73). ↩︎
- شرح العقيدة الواسطية (ص/ 56). ↩︎
- العقيدة في الله (ص/ 73 – 74). ↩︎
- الجواب الصحيح (3/ 203). ↩︎
- تفسير ابن كثير (1/ 197). ↩︎
- تفسير ابن كثير (1/ 197). ↩︎
- تفسير ابن كثير (1/ 197). ↩︎
- تفسير ابن كثير (1/ 197). ↩︎
- تفسير ابن كثير (1/ 197 – 198). ↩︎
- ذكره عنه البيهقي في “الاعتقاد” (ص/ 33 – 34) بقوله: “وهذا فيما قرأته من كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله”، وكتاب الخطابي هذا هو: “شعار الدين”، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في “بيان تلبيس الجهمية” (1/ 501) بقوله: “وقد ذكرنا ما ذكره الخطابي من كراهة طريقة الأعراض، وأنها بدعة محظورة، وقد قال في أوائل كتابه “شعار الدين”، ثم ذكر في (ص/ 506) ما ذكره البيهقي عن الخطابي”، والله أعلم. ↩︎
- تفسير ابن كثير (1/ 197). ↩︎
- تفسير ابن كثير (1/ 198). ↩︎
- مجموع الفتاوى (9/ 212). ↩︎
- تيسير الكريم الرحمن (ص/ 816). ↩︎
- أضواء البيان (3/ 494). ↩︎
- أضواء البيان (3/ 495). ↩︎
- فتاوى نور على الدرب (1/ 63 – 64). ↩︎
- العذب النمير (1/ 443). ↩︎
- أي: من المتكلمين والفلاسفة. ↩︎
- درء تعارض العقل والنقل (1/ 93). ↩︎
- مفتاح دار السعادة (1/ 262). ↩︎
- أضواء البيان (1/ 16). ↩︎
- العقيدة في الله (ص/ 79 – 82). ↩︎
- تيسير الكريم الرحمن (ص/ 133). ↩︎