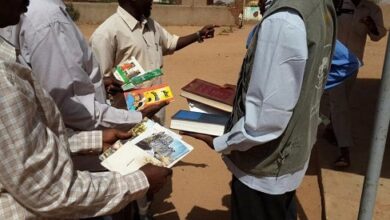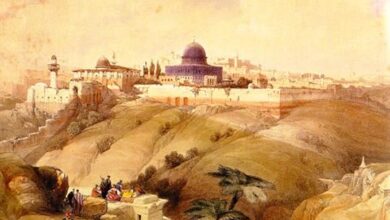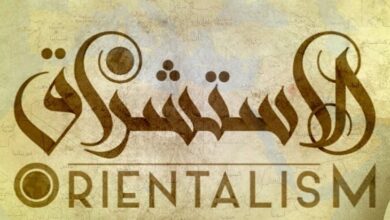لماذا يرتدون إلى النصرانية؟ (1)
المرءُ يَتصوَّر الإنسانَ يُلبَّس عليه في قضية أو جُزئية، فيتوهَّم فسادَ الأصل، فيرفضه كليَّةً؛ لكنَّه لا يتصوَّر أن يقبل غيرَه من الأصول الفاسدة رأسًا على عقبٍ لمجرَّد فسادِ الأوَّل.
هكذا يُساق كثيرٌ من المرتدِّين إلى النصرانية.
نراهم لا يَهتدون بحُكم الجهل تارةً، وبحُكم التلبيس عليهم تارةً أخرى، وبحُكم الطبيعة النفسيَّة المضطربة تارات، نراهم لا يهتدون لكلِّ تلك الموانِع لفَهْم الشُّبهة أو لحلِّها، فيفرُّون مِن الإسلام، ويلوذون بالنصرانية، لا لأنَّ النصرانية أجابتْ عن شُبههم، أو وضعتْ لها الحلولَ المناسِبة، بل لأنَّ الإسلامَ – كما يتصوَّرون – عَجَز عن إقناعِهم!
إذًا الرِّدَّة إلى النصرانية ليستْ لذات النصرانيَّة، وإنَّما هربًا مِن الإسلام، هربًا مِن الإسلام لخصْمٍ قائم بقوَّة في غالبية المجتمعات المسلِمة يَنصِبُ شِباكَه لضعيفي العِلم والإيمان والعقل والنفس، مُتوهِّمًا تحقيقَ مكاسب بضمِّ تلك النماذج المريضة.
محيط شبهات المنصِّرين: والمتابِع للشُّبهات التي يَطْرَحها المنصِّرون حولَ الإسلام يَجِدها لا تخرج عن قضايا جزئية لا تستقلُّ ولا تقترب مِن أصلٍ من الأصول التي بُني عليها الإسلام، بل تحوم حولَ أحكام شرعيَّة فرعيَّة.
وذلك أنَّ تناول الشرع للقضايا الأصوليَّة تناولٌ مِن قبيل المُحْكَم، الذي لا يتطرَّق إليه أيُّ الْتباس بين المسلمين جميعًا – عامِّهم وخاصِّهم – وأمَّا تناوله للمسائلِ الفرعية، فإنَّه تناولٌ قد يكون فيه خفاءٌ على العوام والدهماء، في حين يَهتدي إليه أهلُ العلم والإيمان.
ثم إنَّ العقل يَقْضي بردِّ المتشابه إلى المُحْكَم، وبردِّ الفرْع إلى الأصل، لا العكس، كما يفعل الذين في قلوبِهم وعقولهم ونفوسهم أمراضٌ، مِن المنصِّرين والمتنصِّرين سواء.
يقول ربُّنا – تبارك وتعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الألْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7].
فالآيات المُحْكَمات هي البيِّنات الواضِحات، التي لا تحمل غيرَ وجهٍ واحد لا لَبْس فيه أو خَفاء، والآيات المتشابهات التي تحمل أوجهًا مختلِفة، فأهلُ العلم والإيمان يَردُّونها بإيمانهم إلى المُحْكَمة أولاً، ثم يَهتدون بعِلمهم إلى حقيقتِها وحِكمتها الشرعيَّة.
وأمَّا أهل الزَّيْغ فيتخبَّطون في فَهْم المتشابهات خبْطَ عشواء، ثم يردُّونها إلى أهوائِهم بعيدًا عن المنهجِ العِلمي الصحيح.
وهذا عينُ ما يفعله المنصِّرون، ويقتنع به المتنصِّرون.
فنحن لا نكاد نَقِفُ ألبتَّةَ على شُبهات جديَّة حولَ عقيدة الأُلوهيَّة في الإسلام، وأنَّ الله – تعالى – واحد لا شريكَ له في العبادة، أو أنَّ القرآن ليس مِن عندَ الله تعالى، وهكذا سائرُ القضايا والأصول الأمّ في الإسلام، لا يخوض فيها مُشكِّكًا في صحتها غيرُ مكابرٍ قد بلَغ به العنادُ والجحود مَبلغَه.
في حين نجد المنصِّرين والمشكِّكين يَصبُّون كلَّ جهودهم في طرْح الشبهات حولَ مسائلَ فرعيَّة لا يُحسِن فَهْمَها، ويقف على الحِكمة من تشريعها كلُّ أحد.
فيتناولون على سبيلِ المثال مسائلَ وأحكامًا متفرِّقة خاصَّة بالمرأة، ويعمدون إلى:
- لَيِّ مدلولاتها.
- جمْع الآراء الشاذَّة حولها.
- الافتراء في توجيهها.
فيَزعمون أنَّ الإسلام يُحقِّر مِن شأنِ المرأة؛ لأنَّه يَحْتفي بالذَّكَر منذ ولادته أكثرَ مِن الأنثى، فيعقُّ عنه بشاتين، وعن الأُنثى بشاة واحدة، ويَفرِض عليها وصايةً حتى في القَبول لشريكها، ولا يُورِّثها كما يُورِّث الذَّكَر، وهكذا، يجمعون عدَّةَ مسائل في بابٍ واحد، ويتناولونه بلا طرْح مُنصِف، أو فَهْم صحيح، أو جمْع كامِل.
وبهذا يَخرُجون بنتيجةٍ واحِدة، وهي أنَّ الإسلامَ ظَلَم المرأة، فيُصادف هذا فتاة جاهِلة تتطلَّع لمزيدٍ مِن الانفلات الأخلاقي والأدبي، أو امرأة أوْرَثها ظلمُ أهلها لها أو زوجها نفسيَّةً ضعيفة، أو أغراضًا وأهواء كامِنة، يصادف هذا أو ذاك، وتكون المحصِّلة في النهاية واحِدة، وهي تنصيرُ هؤلاء الأشخاص الذين اختلفَتْ أمراضهم، واجتمعتِ النتيجة الواحدة في حقِّهم.
فهل يعني – تنزلاً – اشتباهُ الفرْع (كنظرةِ الإسلام للمرأة) هل يعني ذلك فسادَ الأصل (أصول العقيدة والشريعة في الإسلام)؟
بمعنى: كيف يُجيب المتنصِّرون عمَّا يعتقدون في الإسلام ككلٍّ في دواخلهم؟
ولننظر كيف يَعْبَث المنصِّرون بعقول أتباعهم:
إنَّ الإسلام جاء بما لا يُخالف العقلَ أو الفِطر، فهو عندما يسنُّ للمسلِم أن يعقَّ عن الغلام بشاتين وعنِ الأنثى بشاة واحدة، فلأنَّ فرَح الناس عادةً بالذَّكَر أعظمُ مِن الأنثى، هذا شيءٌ مجبولون عليه، لا يُنكِره حتى المنصِّرون أنفسُهم، وهو مع ذلك لا يظلم المرأةَ في شيء، كما كانتْ تفعل اليهود، إذ لم يكونوا يعقُّون عن الأنثى، فجاء الإسلامُ بما لا يُخالِف فِطْرةَ الناس عادةً، كما لا تُظلم في نظامِه المرأة.
على أنَّ جماعةً مِن أهل العلم لا يَرَوْن التفريقَ بين الذَّكَر والأنثى في العدد، وعلى أنَّ العلماء جميعًا يُصحِّحون عقيقةَ مَن عقَّ عن الغلام بشاةٍ واحدة، وعلى أنَّ المسلم كذلك غيرُ مُلْزَم بشاة واحدة للأنثى، بل له أن يَزيد شاةً أخرى أو أكثر، ولا يُكْرَه، بل ربما استُحِبَّ.
وهكذا يتلاعَب المنصِّرون بالعقول في سائرِ ما يَعرِضون من شُبهات، فيُقدِّمون نتائجَ مبناها على سوءِ الفَهْم والقَصْد، في مسائلَ قد تشتبه على جُهَّال الناس مِن كلِّ الطبقات، بما فيها مَن تدَّعي الثقافة والمعرِفة.
والسؤال الآن: وماذا عن النصرانيَّة التي ينقلِب إليها المرتدُّون؟
هل قامتْ على أصولٍ تضمن للمرتدِّ قناعتَه العقليَّة والقلبيَّة؟ وهل وجد المرتدُّ إجاباتٍ شافيةً عن محلِّ شُبَهِه القديمة في الإسلام؟
يعني: هل اطمأنَّتْ نفسُ المرتدِّ للدِّيانة النصرانية بحيث يَقْبَلها على بيِّنة ونور تامَّيْنِ؟ وهل خَلَت عنِ الشبهات التي وجدَها قديمًا في الإسلام، والتي بسببها – كما يزعم – انقلَب إلى النصرانية؟
سؤالان، نكشف عنهما في تتمَّة المقال – إنْ شاء الله تعالى.
والحمد لله ربِّ العالمين.