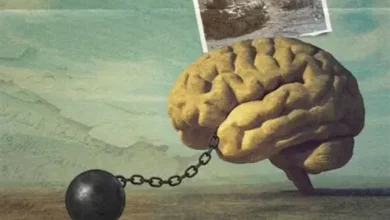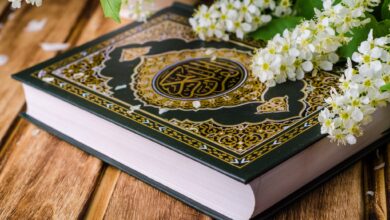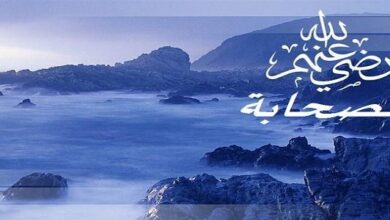طعن المستشرقين في رواة الأحاديث
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:
إنَّ طعن المستشرقين في السُّنة النبوية يُمثِّل منظومةً متكاملةً بدأت بالطعن في صاحب السُّنة نفسِه سيِّدِنا وحبيبِنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، مع الطعن في النص الصادر عنه، ومدى صحَّة نسبته إليه، ولكي تكتملَ الدائرةُ أو توشك على الاكتمال، كان لابد من الطعن فيمَنْ حملوا الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رواة الحديث بدءًا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومرورًا بالتابعين ومَنْ تبعهم، ووصولًا إلى آخِرِ السلسلة المباركة في السَّند.
وبهذا يكونون قد طعنوا في المتن والسند معًا، وهما عماد علم الحديث، فيكون الباب مفتوحًا للولوج إلى الطعن في علم الحديث، ومنهج المُحدِّثين كما سيأتي ذِكره.
ولنبدأ بطعنهم في السَّند، وفي رواةِ الأحاديث؛ حيث أثاروا شُبَهًا وأباطيلَ، ومنها:
أولًا: زعمهم أنَّ الصحابة وتابعيهم وضعوا الأحاديث:
كثر القول في رواة الأحاديث النبوية في كتابات المستشرقين ووسائلهم الأخرى، ووضعوا فئةً من هؤلاء الرواة الثقات موضع الشبهة والتشكيك في رواياتهم؛ لتأثرهم بالأحوال السياسية أو الاقتصادية التي كانوا يعيشون فيها.
يقول “زيهر”: (ولا نستطيع أنْ نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخِّرة وحدها، بل هناك أحاديث عليها طابع القِدم، وهذه إمَّا قالها الرسول أو هي من عمل رجال الإسلام القدامى1. وقال أيضًا: (وقد اعترف أنس بن مالك؛ الذي صاحَب الرسول عن قرب عشر سنوات، عندما سئل عمَّا يُحدِّث عن النبيِّ؛ هل حدَّثه به فعلًا؟ فقال: “ليس كل ما حدَّثنا به سمعناه عن النبي، ولكننا لا نُكذِّب بعضَنا”)2.
وقال أيضًا: (ونظرًا لما وقع في أيديهم – أي: العلماء – من ذلك – أي: من الأحاديث – لم يكن ليسعفهم في تحقيق أغراضهم، أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبًا فيها ولا تُنافي الروح الإسلامية، وبرَّروا ذلك أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد والبعد عن سنن الدِّين)3.
وكثر حديث المستشرقين واتِّهامهم لعلمين كبيرين من أعلام الرواية: هما الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، والإمام الزهري رحمه الله.
ومن أوائل مَن افترى على هذين العَلَمين المستشرق “جولد تسيهر” وقد اعتمد في ذلك على الخلافات التي نشبت بين المسلمين بعد الخلافة الراشدة، والفتن التي مزَّقت الصفَّ الإسلامي، فاستغلها أمثال “تسيهر” وغيره؛ ليطعنوا في أهم مصدرٍ من مصادر التشريع الإسلامي، وذلك بالطعن في رجال سنده.
يقول المستشرق الهولندي “جوينبل”: (إنَّ الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من الأمور المُسلَّمة عند الجميع في أول الأمر، ولهذا نجد أنَّ الثقة بأبي هريرة كانت محل جدلٍ عنيف بين كثير من الناس)4.
ومن الكذب الذي افتراه “جولد تسيهر” على أبي هريرة رضي الله عنه، قوله: (وقد شجَّعته ملازمتُه للنبي [صلى الله عليه وسلم] على أنْ يروي عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر مما رواه غيره من الصحابة، وتُقدَّر الأحاديث التي تُضاف إليه بخمسمائة وثلاثة آلاف حديث، ولا ريب أنَّ عددًا كبيرًا منها قد نُحِلَ عليه.
ونجد بين الذين رووا عن أبي هريرة كثيرًا من أكابر الإسلام، وقد اختلق الناسُ قصةً تُبرِّر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع في الخطأ، تلك الذاكرة التي استطاع أنْ يستوعب بها عددًا عظيمًا من الأحاديث، فقالوا: إنَّ النبي [صلى الله عليه وسلم] لفَّه بيده في بُردةٍ بُسِطت بينهما أثناء حديثهما، وبذلك ضَمِنَ أبو هريرة لنفْسِه ذاكرةً تَحفظ كلَّ ما سمع، وتُروى هذه القصةُ أيضًا دليلًا على صداقته الوثيقة بالنبي، وتُظْهِر طريقة روايته للأحاديث التي ضَمَّنها أتْفَه الأشياء بأسلوبٍ مُؤثِّر على ما امتاز به من روح المزاح، الأمر الذي كان سببًا في ظهور كثير من القصص.
ويظهر أنَّ علمه الواسع بالأحاديث التي كانت تحضره دائمًا قد أثار الشَّك في نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة، والذين لم يتردَّدوا في التعبير عن شكوكهم بأسلوب ساخر.
وقد اضطر أحيانًا أن يدفع عن نفسه تقَوُّلَ الناس – كل هذه الظروف تجعلنا نقف من أحاديث أبي هريرة موقف الحذر والشك، وقد وصفه “شبرنجر” بأنه: “المُتطرِّف في الاختلاق ورعًا”.
ويجب أنْ نلاحظ أيضًا أنَّ كثيرًا من الأحاديث التي تَنسبها الروايات إليه، إنما قد نُحِلَت عليه في عصرٍ متأخِّر)5. ثم ضرب هذا الكذَّاب الأشِر؛ “جولد تسيهر” مِثالًا لما يزعم أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه يكذب في الحديث – وحاشاه – فقال الأفَّاك: (فمن ذلك ما رواه “مسلم” من أنَّ النبيَّ [صلى الله عليه وسلم] أمر بقتل الكلاب إلاَّ كلب صيد أو كلب ماشية. فأخبر “ابنُ عمر” أنَّ أبا هريرة يزيد: “أو كلب زرع”. فقال ابن عمر: “إنَّ أبا هريرة كان له أرض يزرعها”. فملاحظة “ابن عمر” تُشير إلى ما يفعله المُحدِّث لغرضٍ في نفسه)6.
ولفظ الحديث: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ؛ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ). فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: (أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا7.
فقد ادَّعى “جولد تسيهر” أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه اختلق هذه الزيادة من عند نفسه لغرضٍ في نفسه؛ لأنه صاحِبُ مصلحة، وإلى ذلك أشار ابن عمر رضي الله عنهما.
وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله على ذلك بما يُزيل الإشكال، ويرد الشُّبهة،فقال: (قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَيْسَ هَذَا تَوْهِينًا لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة، وَلا شَكًّا فِيهَا، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ وَحَرْثٍ اِعْتَنَى بِذَلِكَ وَحَفِظَهُ وَأَتْقَنَهُ، وَالْعَادَةُ أَنَّ الْمُبْتَلَى بِشَيْءٍ يُتْقِنُهُ مَا لا يُتْقِنهُ غَيْرُه، وَيَتَعَرَّفُ مِنْ أَحْكَامه مَا لا يَعْرِفُهُ غَيْرُه، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَة؛ وَهِيَ “اِتِّخَاذُه لِلزَّرْعِ” مِنْ رِوَايَة اِبْن الْمُغَفَّل، وَمَنْ رِوَايَة سُفْيَان بْن أَبِي زُهَيْر عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَهَا أَيْضًا مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَة اِبْن الْحَكَم، وَاسْمُه عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي نُعْم الْبَجَلِيّ عَنْ اِبْن عُمَر.
فَيَحْتَمِل: أَنَّ ابنَ عُمَر لَمَّا سَمِعَهَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَتَحَقَّقَهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَوَاهَا عَنْهُ بَعْد ذَلِكَ، وَزَادَهَا فِي حَدِيثه الَّذِي كَانَ يَرْوِيه بِدُونِهَا، وَيُحْتَمَل: أَنَّهُ تَذَكَّرَ فِي وَقْتٍ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَوَاهَا، وَنَسِيَهَا فِي وَقْتٍ فَتَرَكَهَا. وَالْحَاصِل: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة لَيْسَ مُنْفَرِدًا بِهَذِهِ الزِّيَادَة، بَلْ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَة فِي رِوَايَتهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ اِنْفَرَدَ بِهَا لَكَانَتْ مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً مُكَرَّمَة)8.
فهذا هو الإنصاف والعدل، والتحقيق العلمي المصحوب بحسن الظن في رواه الأحاديث، ولا سيما من أمثال أبي هريرة، والذي عجز عنه أعداء الإسلام من المستشرقين وأشباههم في أنْ يصلوا إلى معشاره9.
ومن أهم الشبهات والافتراءات التي أثارها “جولد تسيهر” عن الإمام الزهري رحمه الله، ادِّعاؤه بأن الزهري كان يضع الأحاديث، فقال: (ولم يكن الأُمَويُّون وأتباعُهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لِوُجَهات نظرهم، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم، وقد استغل هؤلاء الأمويون أمثالَ الإمامِ الزهري بدهائهم في سبيل وضع الأحاديث)10.
ويزعم أيضًا: (إن عبد الملك بن مروان مَنَعَ الناس من الحج أيام فتنة ابن الزبير، وبنى قبةَ الصخرة في المسجد الأقصى؛ ليحُجَّ الناس إليها، ويطوفوا حولها بدلًا من الكعبة، ثم أراد أنْ يحمل الناس على الحجِّ إليها بعقيدة دينية، فوجد الزهريَّ وهو ذائع الصِّيت في الأمة الإسلامية مستعدًا لأنْ يضع له أحاديث في ذلك، فوضع أحاديث؛ منها حديث: “لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى“11. ومنها حديث: “الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة فيما سواه“12 وأمثال هذين الحديثين، والدليل على أنَّ الزهري هو واضع هذه الأحاديث، أنه كان صديقًا لعبد الملك، وكان يتردد عليه، وأنَّ الأحاديث التي وردت في فضائل بيت المقدس مرويةٌ من طرق الزهري فقط)13.
إن هذه الفِرية ردَّدها هذا المستشرق واقتنع بها كثير من أبناء المسلمين، هي فرية قديمة حديثة تبنَّتها الرافضة للطعن في كل روايةٍ وردت في العهد الأموي أو ممن كانوا تحت الولاية الأموية، إلاَّ أنَّ التاريخ ينفي هذا التشكيك في أعظم شخصية إسلامية كالإمام الزهري الذي اتصف بالحزم والثبات في المواقف، وكان من أوائل الذين خدموا السنة النبوية بروايتها وتدوينها، بيد أن أقلام هؤلاء الأعداء لا تترك أحدًا من المخلصين من رجالات هذه الأمة إلاَّ وطعنته في منهجه وشخصه؛ حتى يتحول التاريخ الإسلامي – في أذهان أجيال المسلمين – إلى مجرد صراع ونفاق وكذب، وبالتالي يكون هذا الدين كلُّه مبنيًا على أوهام وخرافات، ولكن هيهات أن يدرك هؤلاء الأعداء أهدافهم ومآربهم؛ لأنَّ الله تعالى حفظ هذا الدين؛ بحفظ الكتاب والسنة على أيدي هؤلاء الأمناء الثقات أمثال الإمام الزهري رحمه الله، فمهما كاد المستشرقون وأذنابهم فلن يصلوا إلى الغبار الذي كان تطؤه أقدامهم الطاهرة14.
والهجوم على المحدِّثين والطعن في أمانتهم وإخلاصهم وصدقهم أمر متوقَّع من المستشرقين، ومَن سار على نهجهم بعد ذلك، وخاصة أولئك الذين لهم دور بارز في رواية الحديث وحفظه ونشره؛ أمثال أبي هريرة رضي الله عنه والزهري رحمه الله وغيرهما، والهدف من وراء ذلك واضح؛ وهو إفقاد الثقة لدى المسلمين بالحديث الشريف، فالمستشرق “جولد تسيهر” اتَّهم – من غير سند – علماء المسلمين جميعًا بالوضع في الحديث، وهكذا كان “شاخت” الذي ألصق التهم الباطلة بعلماء المسلمين من محدِّثين وفقهاء؛ مثل ادِّعائه بأنهم كانوا يخترعون آراء وينسبونها إلى المتقدِّمين على شكل أحاديث، وأنها وضعت من قبلِهم في القرنين الثاني والثالث، وأنه لا يوجد حديث فقهي صحيح واحد15.
وإذا كان هؤلاء المستشرقون يَنقِمون من أبي هريرة رضي الله عنه قوَّةَ حفظِه وعدمَ نسيانِه؛ فنحن نقول لهم: ما الغريب في أنْ يحفظ أبو هريرة هذه الأحاديث، وما العجيب في أنْ يمتلكَ قوَّةً حافظة، والعلمُ والواقعُ يؤيِّدان ذلك ولا يُعارِضانه؛ فالعلم أثبتَ أنَّ السَّعة التخزينية للذاكرة الإنسانية تتَّسع لتتمكَّن من حفظ أمور كثيرة ومتنوِّعة من الأحداث والأقوال، والواقع يُثبت أنَّ هناك من المسلمين حتى في وقتنا الحاضر مَن استوعبتْ ذاكرتُه حِفظَ القرآنِ الكريم، وكتبِ الحديث السِّتة، حَفِظوها عن ظهر قلبٍ بسندها ورواتها.
ومن ثَمَّ، فإنَّ ما يجوز وقوعه في زمنٍ مَّا، لا يُستبعد وقوعُه في زمنٍ آخر، وامتلاك أبي هريرة رضي الله عنه هذه المَلَكة أمر لا نشكُّ فيه، فإذا أضفنا أنه انقطع فقط لهذه المهمة وتفرَّغ لها كان الكلام مُتَّسقًا؛ إذْ إنه كان من أهل الصُّفَّة الذين نزلوا ضيوفًا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه من الطائفة التي ندب اللهُ تعالى إليها للتفقُّه في الدِّين في قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]. وما ينطبق على أبي هريرة رضي الله عنه ينطبق على غيره من حفَّاظ ورواة الحديث؛ كالزهري وغيره.
وتبقى نقطةٌ أُخرى، وهي أنَّ هؤلاء المستشرقين ينتمون إلى حضارة مادية مَحضَة، وتتحكَّم فيهم فلسفة نفعية بحتة؛ لذا فهم يحكمون بشكل مادي على الأشخاص، متناسين الجانب الروحي والعقدي، الذي يُشكِّل جوهر الإنسان المسلم، والذي يمكنه في سبيل معتقده أنْ يُضحِّي بروحه وحياته، والذي يُطلب منه أنْ يلتزم آدابَ الإسلام وأخلاقَه؛ من صدقٍ وأمانةٍ وإخلاصٍ وغيرها، وهذه الأمور ممَّا لا يضعها هؤلاء في حساباتهم؛ لذا يضعونها جانبًا غير آبهين لها، في حين أنَّ الإنسان كلٌّ متكامل بين الروح والمادة.
ثانيًا: الطعن في “سند الحديث”:
لم يسلم سند الحديث من طعن المستشرقين، ومن ذلك: ما قاله “شاخت”: (إنَّ أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي، ومعلوم لدى الجميع أنَّ الأسانيد بدأت بشكلٍ بدائي، ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث، وكانت الأسانيد لا تجد أدنى اعتناء، وأيُّ حزبٍ يريد نسبة آرائه إلى المتقدِّمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد)16.
وها هو المستشرق “ميور” ينتقد طريقة اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث؛ لاحتمال الدَّس في سلسلة الرواة.
وذكر “كايتاني” أنَّ الأسانيد أضيفت إلى المتون فيما بعد بتأثير خارجي؛ لأن العرب لا يعرفون الإسناد، وأنها استعملت ما بين عروة وابن إسحاق، وأن عروة لم يستعمل الإسناد مطلقًا، وابن إسحاق استعملها بصورة ليست كاملة.
ويرى “هوروفتس” أنَّ العرب أخذوا فكرة الإسناد عن المدارس التلمودية عند اليهود17.
ومن المتوقَّع أن يكون الإخفاق من نصيب المستشرقين في دراساتهم لظاهرة السند؛ لعدم اتِّخاذهم المجال والحقل المناسب لها، حيث اختاروا كُتبًا ليست هي مظانَّ الأسانيد؛ مثل كتب السيرة والفقه والتاريخ، وكان بإمكانهم النجاح فيها والتوصل إلى نتائج علمية وواقعية، لو كانت نيَّاتهم – ابتداءً – صالحة، ولو كانوا جادين في ذلك لاتَّخذوا من كتب الحديث ميدانًا لدراستهم، ومن منهج المحدثين مسلكًا لها.
وقد بدأ استعمال السند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله بعض الصحابة بنقل الأحاديث النبوية في ذلك الوقت، والتزم الرواةُ بذلك في العهد الراشدي، وفي عهد التابعين ومَنْ بعدهم التزم المحدِّثون السند، وتشدَّدوا في أمره أكثر فأكثر، وأحاطوه بكل عناية واهتمام، وكانوا يبذلون جهودًا مضنية في البحث عن الأسانيد، ويتتبَّعون الرواة ويرحلون إليهم للتثبُّت من السند، فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: (إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد)18.
ولا نُبالغ إذا قلنا: إنهم تعمَّدوا أنْ يتجاهلوا جهودَ علماء الإسلام في تحقيق الحديث وسندِه، وتمييزِ السَّندِ المُتَّصل عن غيره، وذلك وَفق قواعدَ محكمةٍ ومنهجٍ مُطَّرد، تجده في كتب الحديث متوافقةً مع كتب الرِّجال، شرقًا وغربًا، والاطرادُ في المنهج ووحدتُه واتِّساقُه، مع بُعد المكان بين واضِعيه ومُطبِّقيه دليل على قُوَّته، فمعلوم أنَّ علماء الحديث اختلفوا في الأقطار، وتفرَّقوا في الأمصار، ولكن رغم هذا كان منهجُهم واحدًا، ممَّا يدل على قوَّتِه وسلامتِه.
والعجب كل العجب من هؤلاء المُتعنِّتين؛ إذ يُنكرون هذا العلم الخالص لعلماء الإسلام الذي شهد لهم به أبناؤهم وإخوانهم من بني جلدتهم، محاولين التلبيس على العالَم أجمع، ضاربين عُرْضَ الحائطِ الحيادَ العلمي والموضوعية في البحث؛ من أجل الوصول إلى أغراضهم الدَّنيئة وأهدافهم الخبيثة.
- العقيدة والشريعة في الإسلام، (ص 49). ↩︎
- المصدر نفسه، (ص 55). ↩︎
- المصدر نفسه، (ص 59). ↩︎
- دائرة المعارف الإسلامية، (7/ 336). ↩︎
- دائرة المعارف الإسلامية، (1/ 418-419). ↩︎
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، (ص 193). ↩︎
- رواه مسلم، (2/ 670)، (ح 4102). ↩︎
- شرح النووي على صحيح مسلم، (10/ 236). ↩︎
- انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، (2/ 87). ↩︎
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، (ص 206). ↩︎
- رواه مسلم، (1/ 566)، (ح 3450). ↩︎
- الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 398)، (ح 1133)؛ ومسلم، (2/ 1012)، (ح 1394). ↩︎
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، (ص 191). ↩︎
- انظر: الاستشراق وموقفه من السنة النبوية، (ص 43). ↩︎
- انظر: المستشرقون والحديث النبوي، (ص 300). ↩︎
- المستشرق “شاخت” والسنة النبوية، محمد مصطفى الأعظمي (ص 104). ↩︎
- انظر: موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية، (ص 40-41). ↩︎
- معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص 40). ↩︎