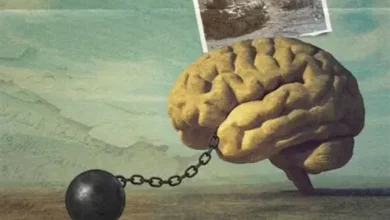حول فقه النوازل
إن فقه النوازل مِن أدقِّ مسالك الفقه وأعوَصِها؛ حيث إن الباحث فيه يَطرق موضوعات لم تُطرَق من قبل، ولم يرد فيها عن السلف قولٌ؛ بل هي قضايا مستجدَّة، يغلب على معظمها طابع العصر المُتميِّز بالتعقيد والتشابك، والمتميِّز بابتكار حلول عِلمية لمشكلات متنوعة قديمة وحديثة، واستحداث وسائل جديدة لم تكن تخطر ببال البشر يومًا من الدهر – والله أعلم.
وهذه وتلك مما أنتجتْه عقول كفَرة لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الآخِر، ولا يَرعون للخُلق أو العِرض أو الدِّين قَدرًا، وذلك في غيبة الأمة المسلمة عن قيادة الحياة البشرية، وخُنوسها – تأخُّرها – إلى مؤخَّرة الرَّكْب؛ بل توقُّف مسيرتها؛ بل تراجُعها إلى الوراء.
وهذه الأمور جعلت مُعالَجة القضايا الجديدة التي أفرزتها الحضارة الغربية، وانتقلت إلى بلاد الإسلام مسألةً صعبةً خطيرة، تتطلَّب جهدًا مضاعَفًا، وتحريًا طويلاً، ودراسة عميقة للأقوال والأدلة؛ حتى يتميَّز الحق ويَنبلِج صباحه، خاصة وأنه في كثير من الأحيان يُشكِل فهم المسألة وتصوُّرُها تصورًا صحيحًا؛ إذ قد تكون متعلقة بالنواحي الطبية – مثلاً – أو الاقتصادية المتخصِّصة، أو السياسية، أو غيرها، مما يُحتاج معه إلى وجود المسلم المتخصِّص الذي يَملك تصوير المسألة تصويرًا صحيحًا، وكشف أبعادها لغير المختصين.
وهذا لا يسوِّغ النكوص وكثرة التهيُّب مِن طَرْق هذه القضايا؛ بل هي مِن ألزم ما يجب طَرقُه؛ لأنها تتعلق بحياة الناس ومعاشهم، وتَعرض لهم في مختلف أحوالهم، ولا بدَّ فيها من الفُتيا، ورفع الإشكال عن المسلم الحريص على الالتزام بالشرع، وتحرِّي حكم الله – سبحانه وتعالى.
والإعراض عن بحث هذه المسائل – بحجَّة الورَع – هو في الحقيقة نُكول عما أخذه الله – سبحانه وتعالى – على العالِمين من ضرورة البيان وعدم الكتمان، ومِن المُقرَّر أن: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يَجوز؛ فهذه قاعدة أصولية مبسوطة في كتب الأصول.
إذًا فقد اجتمع في مسألة النوازل أمران:
أولهما: صعوبة الفُتيا فيها؛ ولقد كان السلف يتدافَعون الفُتيا؛ حتى قال عبدالرحمن بن أبي ليلى – فيما رواه الدارمي -: “لقد أدركتُ في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، وما منهم من أحد يُحدِّث بحديث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا يُسأل عن فُتيا إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفُتيا”، وفى “التاريخ الكبير” للبخاري أن سعيد بن المسيب كان لا يُفتي فُتيا إلا قال: “اللهم سلِّمني”.
وثانيهما: لزومها؛ فهي مِن المواضع التي يلزم فيها الاجتهاد والفُتيا بما يَنتج عنه لزومًا كفائيًّا، وإذا كان المرء لا يرى نفسه أهلاً لذلك، لكن رآه غيره مِن العارفين كذلك، فليس من حقِّه التنصُّل والتهرُّب والفِرار؛ يقول ميمون – أبو حمزة رحمه الله -: “قال لي إبراهيم: يا أبا حمزة، والله لقد تكلمتُ، ولو وجدتُ بدًّا ما تكلمتُ، وإن زمانًا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء”، وقد أخرَج ذلك الدارمي، وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، ومع قوله هذا، فقد كان يُفتي، ويقول: “احتيج إليَّ، احتيج إليَّ”؛ كما في “الطبقات الكبرى” و”حلية الأولياء” و”صفة الصفوة”.
فكل باحث يَمتلك القدرة على البحث، والتوصُّل إلى القول الراجح، يلزمه من ذلك ما يلزمه، وإن كان رأيُه في نفسِه كرأي هذا التابعي الجليل في نفسه أو أشدَّ.
وقد تتعيَّن الفُتيا وتَلزم فردًا أو أفرادًا هم خيرة أهل الزمان، أو مِن خِيرتهم، وإن كانوا هم يرون أنفسهم دون ذلك، وإن كان فيهم وفيهم؛ فلكلِّ زمان رجاله.
والإسلام يَحكم جميع الأزمنة، وله في كل واقعة حكم، ولا تستقيم أمور الناس بدون فُتيا، خاصة وأنه في مثل الزمان الذي يقلُّ فيه الخير، ويقل الأخيار، يَكثُر المُتكلِّمون بلا علم، والمُفتون بلا دليل، والمُقتحِمون بلا ورع، فإذا سكَت مَن هو أهلٌ للكلام، وتكلم مَن شأنُه السكوت، فعلى العلم والإسلام السلام!
ومِن هذا المُنطلَق أُحاول تحديد بعض المعالم التي تُعين على موافقة الصواب – بإذن الله – فأقول:
أولاً: لا بد من تصور المسألة تصورًا صحيحًا واضحًا كافيًا قبل البدء في بحث حُكمِها، والحكْم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره، وكم أُتِيَ الباحث أو العالم مِن جِهة جهله بحَقيقة الأمر الذي يتحدَّث فيه! فالناس في واقعِهم يَعيشون أمرًا، والباحث يتصوَّر أمرًا آخَر ويَحكم عليه.
وإن كان الأمر له أبعاد لم تَظهر ولم تأتِ بعد، فالباحث يتخيَّل شيئًا، والذي يَحدث شيء آخر لا علاقة له به.
فلا بدَّ مِن تفهُّم المسألة من جميع جوانبها، والتعرُّف إلى جميع أبعادها وظروفها، وأصولها وفُروعها ومُصطلحاتها، وغير ذلك مما له تأثير على الحكمِ فيها.
ويَستعين في ذلك بالمراجِع المتخصِّصة الموثوقة، كما يستعين بأهل الخبرة الثِّقات، الذين يَحلُّون له ما استغلق عليه فهمه من مدلولات الأمر أو مُصطلحاته، أو مُتعلقاته؛ حتى لا يَبقى عنده فيه أي لَبسٍ.
ومِن خلال القناعة الناتجة عن بعض المُتابعات الواقعية، يتأكَّد أن كثيرًا من الخطأ في الفُتيا مردُّه إلى التصوُّر في تحقيق ما ذكرتُ، أو إلى أمر آخَر من جنسِه، وهو فهم السؤال فَهمًا غير مُطابق للواقع، ولا لغرض السائل، وقد يكون السؤال يَعني شيئًا، والجواب إنما هو على شيء آخَر مُباين له تَمامًا.
ثانيًا: ينبغي الحِرص على معرفة “السوابق التاريخيَّة” القريبة أو البعيدة التي تمسُّ المسألة من قريب أو من بعيد، فيَبحث: هل وقع في التاريخ الإسلامي ما يُستأنَس به في حلِّها؟ وهل عُرضت على أحد من العلماء في أي عصرٍ مسألةٌ شَبيهة بها؟! ولذلك كان العلماء يقولون – كما في “جامع بيان العلم” -: “لا يكون فقيهًا في الحادث من لم يكنْ عالِمًا بالماضي”.
والاطِّلاع على التاريخ مُفيد في مثل هذا، وكم مِن مسألة يظنُّها الباحث جديدةً حادثةً، فيَتبيَّن – بعد – أنها ليسَت كذلك، وقد وقعَت أو نحوها في بلدة كذا، وأفتى فيها العلماء!
ولو حقَّق المرء ودقَّق، لوجَد كثيرًا مِن الحوادث والنوازل لها جُذور عريقة في التاريخ، تُعدُّ هي الأصول أو السوابق التاريخيَّة لها.
وأَضرب على ذلك مثالاً واحدًا في مسألة التأمين، فقد يظنُّها الكثيرون مسألة مُعاصِرة ليس في تُراث الفقه الإسلامي، ولا في ماضي المسلمين ما يَشهد لها، أو يُرشِد فيها، ولكن الباحثين يُثبِتون أن له جذورًا تاريخيَّة، خاصَّة ما يُسمى بالتأمين البَحري، وذلك في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي؛ بل أرجعه بعضهم إلى القرن الثاني عشر؛ هذا مِن حيث وجوده في العالم، أما عن اتِّصاله بحياة المسلمين، فيكفي أن نعلم أن هناك نصًّا في كتاب “المغني”؛ للإمام ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله – يتعلَّق بموضوع التأمين البحري، وانظر “المغني” (4: 565) من طبعة المنار، ثم نصٌّ آخَر في “حاشية ابن عابدين” في الفقه الحنفي، وهو في كتاب الجهاد باب المستأمن، وانظر في هذا “التأمين البحري”؛ لجمال عياد، وبحث “التأمين”؛ للدكتور مصطفى الزرقا.
ثالثًا: بعد تصوُّر المسألة ومعرفة سوابقها، يَستجمِع ما يُمكن أن يكون دليلاً فيها بالمَنع أو الجواز، ويَنظر في الأصول والقواعد العامَّة المُقرَّرة التي يُمكن أن تكون المسألة إحدى جزئياتها؛ إذ النص الواحد، أو القاعدة الواحِدة قد يَدخُل تحتها من الفروع والمسائل القديمة والجديدة ما لا يَنتهي عند حدٍّ.
وينظر في فتاوى العلماء المُعاصِرين، أو الهيئات العِلمية الموثوقة التي سبق أن تناولت المسألة بالبحث، وأصدرت بشأنها رأيًا – فرديًّا أو جماعيًّا – ويُناقش هذه الآراء على ضوء الأدلة والقواعد التي اجتمَعت لديه؛ حتى يطمئنَّ إلى رأي في المسألة.
وبعد هذه المرحلة، يَستفيد الباحث كثيرًا من مناقشة العلماء والمُختصين، وتداول الرأي حول القضيَّة؛ وإنما يَحسُن النقاش المباشر في هذه المرحلة؛ لأن الإنسان حين يُناقش دون تكوين رأي محدَّد، يَستحسِن – أحيانًا – فِكرة مِن الأفكار المطروحة، ويَميل معها، وحين يقطع في البحث مرحلةً أخرى، يتغيَّر رأيه، فيحتاج إلى المُناقشة مرة أخرى، وهكذا.
كما أن النقاش قبل تكوين رأي، يدعو إلى إلغاء شخصية الباحث، وذوبانها في شخصيات الآخَرين، خاصة حين يكونون – من حيث الجملة – أوسَعَ منه عِلمًا، وأوضَح بيانًا.