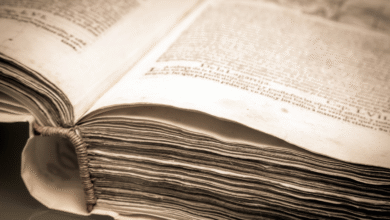حكم التوسل بغير الله (2)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رُسل العالمين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالتوسل بغير الله يناقض التوحيد للأسباب الآتية:
أولاً: يرجو المتوسلُ بغير الله خيرًا مِمَّن لا يملِك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، فضلاً عن غيرِه؛ وقد قال – تعالى -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: 18].
وقد جعل الله اللجوءَ إلى ما لا يضرُّ ولا ينفع، واتخاذَهم شفعاءَ من دون الله – عبادةً كما ترى، كما أنكر اللهُ على الصانعين بمثل هذه الأفعال بقولِه: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [يونس: 18]، ونزَّه اللهُ نفسَه أن يُعبد بمثل ذلك، وجعله كذلك شركًا بقولِه: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: 18].
وعليه جرى ذلك الحُكم في آيات القرآن كلِّها التي وردت في اتخاذ الشفعاءِ من دون الله؛ إذ حكم اللهُ عليهم أنهم عبدوا من دون الله آلهةً، وأشركوا في عبادته – سبحانه – كما قال – تعالى -: ﴿ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾ [يس: 23]، وقال – تعالى -: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأحقاف: 28]، وقال – تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: 3].
ثانيًا: فيه صرفُ المتوسلِ بغير الله رجاءَه وتوكُّلَه واستعانتَه لغيرِ الله، وربما صرَف – كذلك – الخوفَ والإنابة وسائرَ الأعمال التعبدية؛ سواءٌ كانت قلبية أم قولية أم فعلية، وهذا هو الشركُ الواضح الذي لا غبارَ عليه؛ وقد قال – تعالى -: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5]، وقال: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: 13- 14].
وقال – سبحانه -: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [الرعد: 14].
ثالثًا: فيه تشبيه المتوسِّل بغير اللهِ الخالقِ بمخلوقٍ يحتاج إلى مُعينٍ ووزير، وقد نفى اللهُ عن نفسه ذلك، وقال: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: 22]؛ أي: مِن مُعين، والله – سبحانه – غنيٌّ عن ذلك كلِّه، وفي الحديث عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: قال الله – تبارك وتعالى -: ((أنا أغنى الشُّركاءِ عن الشرك، من عمِل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتُه وشِرْكَه))؛ رواه مسلم، وفي رواية ابن ماجه: ((فأنا منه بريءٌ، وهو لِلَّذي أشرك)).
وهذا إذًا يُعتبر أقبحَ ما وقع فيه المتوسِّل بغيرِ الله، وإن لم يكن سببٌ آخر يُنهى عن التوسَّل بغير الله بسببه غير هذا لكفى.
فالله – سبحانه – قال لك في القرآن يا عبدَ الله: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: 60]، وقال – سبحانه -: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: 186]، فلماذا تريد أن يكونَ اللهُ بعيدًا عنك وهو يقول لك ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾؟! ثم الله – سبحانه وتعالى – سهَّل لك إجابةَ دعوتك؛ فلماذا تُصعِّب على نفسك، وتكلِّف نفسك ما لم يكلِّفك الله؟!
وهذا التشبيه وإن لم يصرِّح المتوسِّل بغير الله به بلسانه، أو حتى لو لم يدُرْ بنفسه ذلك – فإن لسان حاله وواقعه يقول ذلك؛ إذ إن الله – سبحانه – كريمٌ، وهو أكرم الأكرمين، ولم يحتجب عنَّا، بل هو أقربُ من أحدنا مِن راحلته، فلماذا نُبعِّده عن أنفسنا، ونكلِّف أنفسنا العناءَ والشقاءَ لا نحتاجه، بل نوقعها في البدعة والشرك والعياذ بالله؟!
وما أحسنَ قولَ القائل:
واللهُ يغضِبُ إن تركتَ سؤالَه … وبُنَيُّ آدمَ حين يُسأَلُ يغضبُ
ولَمَّا سمع النبي – صلى الله عليه وسلم – بعضًا من أصحابه يدعو اللهَ بصوت مرتفع، نهاهم عن ذلك وقال لهم: ((أيها الناس، اربَعُوا على أنفسِكم؛ فإنكم لا تدعونَ أصمَّ ولا غائبًا))، وأنزل الله في إثرها: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: 186].
وقد قال – تعالى -: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: 55].
فإذا كان اللهُ لا يحب مَن يرفع صوتَه بالدعاء، وجعله مُعتَدِيًا بذلك، فما ظنُّك بمن لا يدعو ربَّه إلا أن يتحوَّلَ إلى مَن يتقرَّبُ به إلى الله، ويَنسب له الفضلَ والجاه عند الله؛ ليجيب اللهُ دعاءَه – حسب زعمه – لا شك أن هذا أبغضُ عند الله مِن هذا المعتدي المشارِ إليه في الآيةِ.
فيا عبدَ الله:
إذا كان ربُّك وحده هو الذي يجيب دعوةَ المضطر، وهو وحده يرفع عنك الضَّرر، ووحده يكشف السوءَ عن المشتكي البلايا وحده، إذًا فلماذا تلجأُ إلى غيره، أو تدور هنا وهناك، وقد قال ربك – سبحانه وتعالى -: ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62]؟!
قال صاحب التسهيل لعلوم التنزيل:
﴿ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: 59] على وجه الردِّ على المشركين، فدخلت “خير” التي يرادُ بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم، مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوا أصلاً، ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السمواتِ والأرض، وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات، وأعقب كلَّ برهان منها بقوله: ﴿ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ﴾ [النمل: 61] على وجه التقريرِ لهم، على أنه لم يفعل ذلك كله إلا اللهُ وحده، فقامت عليهم الحجةُ بذلك، وفيها أيضًا نِعم يجب شكرُها، فقامت بذلك أيضًا”.
رابعًا: التوسل بجاهِ وفضل ذوات الأشخاص المكرَّمة – كالأنبياء والملائكة – إلى الله، بدعةٌ، ما أنزل الله بها من سلطان، ووسيلة إلى الغلو والشرك بالله، لم يشرعْه النبي – صلى الله عليه وسلم – بل كان يقول – بأبي هو وأمي -: ((إذا سألتَ فاسأل اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعن بالله)).
وهذا من توجيهات النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – في مثلِ هذه المسألة، وما يقال في مسألةِ التوسل هذه يقالُ في مسألة الاستغاثة؛ بل هي أشدُّ وأصرح في الشرك بالله، والعياذ بالله.
ولو كانت طريقةُ التوسل بذات النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – أجدرَ بالإجابة عند الله، لحرَص عليها الصحابةُ – رضوان الله عليهم – ولنُقلت إلينا أخبارُهم في ذلك, ولَمَّا لم يُنقَلْ إلينا شيءٌ من ذلك؛ بل جاء عكس ذلك، علِمنا أن ذلك بدعةٌ في دين الله لا تجوز، بل هي وسيلةٌ إلى الشِّرك والغلو في دين الله.
ولكنَّ التحقيق في هذه المسألة هو أن نفصِّلَ ونبيّن الضابطَ في مسألة التوسل البدعي هذه، التي اعتبرناها وسيلة إلى الشرك، فأقول: إذا كان المتوسِّل بغير الله يتوسل بجاهِ وفضل ذوات الأشخاص المكرمة – كالأنبياء والملائكة – إلى الله، فهي بدعةٌ ووسيلة إلى الشرك، على ألا يتخذَ المتوسل ذلك طريقه وديدنَه التي يدعو بها ربه، أما إذا اتخذ ذلك طريقَه، ودندن بها صباحًا ومساءً، فقد وقع في الشرك المحذور، وصرَف توكُّلَه ورجاءَه واستعانتَه إلى غير الله، واعتقد أن الضرَّ والنفع الذي كان لا يجلبُه إلا اللهُ في هذا المَلَكِ والنبيِّ الذي توسَّل به.
والضابط في هذه المسألة هو هذا الذي بينتُه لك آنفًا، وكل ما ذكرته لك في هذا المقال من الأسباب ضوابطُ لذلك؛ فتأمل!
والدليل على ما قلته لك آنفًا هو أننا نستشفُّ من كلمة: “اتخذ” التي ترِد في آيات القرآن كثيرًا – خصوصًا في هذه المسألة – بمعنى: استمرُّوا بهذا الفعل – أنها كانت لهم طريقةً ومنهجًا متّبعًا حتى عبدوهم بسائر أنواعِ العبادات المختلفة، والتي كان أخطرها أن يرجوا من مخلوق جَلْبَ نفعٍ أو دَفْع ضرٍّ، ويتوكلوا عليهم، ويستعينوا بهم …….إلخ، والله أعلم.
وخذ قاعدة مهمة في العقيدة، وهي:
“كلُّ من أشرك شركًا أصغر، واعتقد صاحبُه في الذي أشرك فيه أنه يجلبُ له نفعًا أو يدفع عنه ضرًّا، فقد انقلب شركُه شركًا أكبرَ يُخرج عن الملة”.
فعلى سبيل المثال لا الحصر: رجُل كان يُكثر الحلف بالنبيِّ – صلى الله عليه وسلم – وجرى على لسانه ذلك؛ فهذا شركٌ أصغرُ، ولكن إذا اعتقد أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – ينفعُ كما ينفع ربُّه، ويضرُّ كما يضر ربُّه، فقد أشرك شركًا أكبر.
مثال آخر: رجُل يكثر من قوله: ما شاء اللهُ وشئتَ، أو لولا الملاَّحُ حاذقًا لغرقنا، ونحو ذلك من الأقوال – فهذا شركٌ أصغرُ، ولكن إذا اعتقد صاحبُ هذه المقولة في المخلوق أنه ينفعُ كما ينفع الرحمنُ، ويضر كما يضرُّ – فهو مشركٌ شركًا أكبرَ، وقِسْ على ذلك.
أما المتوسلون بجاه وفضل ذوات الأشخاص بمن يسمونهم أولياء، فهذا هو ما يأباه العقلُ السليم والنقلُ الصحيح، وإنما هذا جهل وغباء؛ إذ هؤلاء الذين يتوسَّلون بهم ليسوا بمعصومين، ولسنا ندري سرائرَهم وقلوبهم وإخلاصَهم، فكيف يُتعلَّق بهم؟! ثم لماذا تميز هؤلاء عن غيرهم من سائر الأمة؟ ولِم لَم يتوسلوا بأبي بكر وعمرَ، وهما المشهود لهما بالجنة وأفضلُ هذه الأمة على الإطلاق؟!
وقد نتج عن هذا التوسل بهؤلاء الميتين المساكين – الذين هم بأمسِّ الحاجة إلى دعائهم لهم بالرحمة والمغفرة إن كانوا موحِّدين أصلاً – الغلوُّ والإطراء، والعبادة، والتمسح بالقبور، والطواف بها كما يطاف بالكعبة، والعكوف على القبور، والنذر لأصحابها حتى ألَّف أحدُهم كتابًا أسماه: “مناسك حج المشاهد”، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: “الرد على البكري والإخنائي”، فإنا لله وإنا إليه راجعون!
خامسًا: التوسل – بحدِّ ذاته – عبادةٌ من العبادات، شرعها اللهُ لنا لنتقرب به إلى الله بما شرَعه، فمَن صرفها لغير الله فقد أحدث في الدِّين، وابتدع أو شرع شرعًا جديدًا مما لم ينزلِ الله به سلطانًا، فأشرك بذلك أو صار طاغوتًا – والعياذ بالله – بحسب عمله بهذه البدعة ودعائه إليها، وقهرِه على الناس؛ إذ قد تتحوَّل البدعةُ الصغيرة إلى بدعة مكفِّرة بل طاغوت، نسأل الله السلامةَ والعافية؛ قال – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 35].
قال ابن جرير الطبري – رحمه الله -: وحقِّقُوا إيمانكُمْ وتصديقَكم ربَّكُم ونَبِيَّكم بالصَّالحِ مِن أعمالِكم، “وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ”، يقول: واطلبوا القُربةَ إليه بالعملِ بما يُرضيه.
و”الوسيلة”: هي “الفعيلة”، من قول القائل: “توسَّلت إلى فلانٍ بكذا”، بمعنى: تقرَّبت إليه، ومنه قول عنترة:
إنَّ الرِّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ وَسِيلَةٌ … إِنْ يَأْخُذُوكِ، تكَحَّلِي وتَخَضَّبي
يعني بـ: “الوسيلة”، القُرْبة، ومنه قول الآخر:
إِذَا غَفَلَ الوَاشُونَ عُدْنَا لِوَصْلِنَا … وَعَادَ التَّصَافِي بَيْنَنَا وَالوَسَائِلُ
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: “وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“، قال: المحبَّة، تحبَّبوا إلى الله، وقرأ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: 57].
وحدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبدالله بن كثير قوله : “وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“، قال: القُربة؛ اهـ.
وذكر – رحمه الله – أحاديثَ كثيرة لهذا المتن الأخير بأسانيدَ مختلفة.
قلت – الكاتب -: وهذه القربةُ عامة، فلا نحصرها بعدد معين، وإنما هي تشمل الإيمانَ كله، وكلمةَ التوحيد بصفة خاصة، وما اشتملت عليه هذه الكلمة؛ من التوسل بأسماء الله الحسنى، وغيره، بل وتشمل جميعَ العبادات والطاعات، وفِعْل الخيرات.
والله – سبحانه وتعالى – أعلمُ، وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.