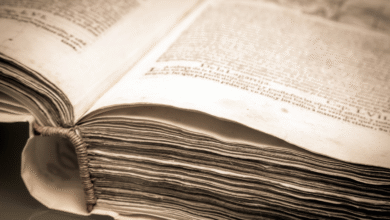تمرد على الفطرة: مقتطف من كتاب “الله بلغة العلم”
ليس مِن الهيِّن معالجة مواضيع إنسانية ذات أبعاد فلسفية مُلتبسة كمَوضوع الإلحاد؛ إذ يتطلَّب من متناوله الإلمام بأسبابه والدوافع النفسية والاجتماعية التي تَعتمل في قرارة الملحد؛ إذ لا شكَّ أن الكفر بالله، والتنكُّر للأديان وما قدَّمته: تنكُّرٌ لذاكرة الإنسان، وتغاضٍ عن تاريخ الإنسان المتديِّن بطبعِه.
وإنه لمن الصعب التعاطي لمثل هذه الظواهر التي يُمكن اعتبار موضوع ضمنها – كالإلحاد – شيئًا طارئًا على الضمير الإنساني، وليس مِن فطرة الإنسان؛ لأنه مخلوق متديِّن.
ومِن الممكن للباحث في أغوار تاريخ الحضارات الإنسانية الغابرة، أن يجد مثلًا حضارةً بدائيةً بلا سياسة، أو حضارةً بلا عمران يعرِّف بتلك الحضارة المُندثرة، لكن من المُمتنِع جدًّا أن يجد الباحث حضارة خالية من الدين ومَعابد المتدينين؛ حيث إن الدين هو المُعطى المُطلَق لتنظيم حياة الأفراد على ظهر الكرة الأرضية، مهما اختلفت دياناتهم؛ لأنهم يوالون هذا المطلق الذي يدينون له بمطلق الأبدية والأزلية الحية العالمة، والدين هو المنظِّم الذي تذوب أمامه كل الخلافات، إذا لم يتجرَّد مِن الإنسانية التي ينادي بها ويُضحِّي من أجلها ويقهر بزوالها أو يحاصر.
كيف لا؟ واختصار معركة الإيمان والإلحاد يُحدُّ بصراع بين قيمتين، تقول أولاهما – وهي الإيمان – للإنسان مخاطبةً عمقَه: كن إنسانًا مسؤولًا عن كل كبيرة وصغيرة تفعلها، وتُحاسب نفسك وتؤنِّب ضميرك إذا ما اقترفتَ جرمًا، لا تقبَل تجاوز الضوء الأحمر في شارع الحياة، تعلم مثلًا إذا رغبت في الزنا أنَّك أنت الآخر لا ترضى ولا تقبل أن يزني أحد بأختك أو بنتك، فلمَ تقبَلُ أنت أن تَزني بأخت أو بنتِ آدمي ما؟
وتقول ثانيتهما – وهي الإلحاد -: افعل ما شئتَ فلا حسيب عليك، واقتل إنسانيتك بعد اغتيالك لدينك وضميرك اللذين يُبعدانك عن الحرام والجرم، فكل شيء حلال، ولن يحاسبك أحد؛ لأنه لا إله في قلبك ولا ضمير ولا دين، هذا هو الإلحاد وهذا وعْده، يبشِّر أهله بأن يُطلقوا كل فضيلة في الحياة، يقول نيتشه – فيلسوف الوقاحة -: “تخلَّص مِن الضمير ومن الشفقة والرحمة، اقهر الضعفاء، واصعد فوق جُثثهم”.
هذا هو حاصل الصراع بين الإيمان والإلحاد؛ إذ الإيمان يُحذِّرك مِن الرقابة الإلهية جراء الإقدام على فعل شيء، رقابة تَعدُك بأن تُجازى عن استحضارها خير الجزاء، تأمرك بكل فضيلة وخير ووقوف عند حدود الله، وفي الآن نفسه تُنذرك عند التغاضي عنها بأنك لن تُفلِت مِن العقاب عن اقترافك للمُنكَر والإقدام على الرذيلة؛ لأنَّ هذا هو المعيار الكوني للفضيلة والعدالة.
فالوازع الديني والإحساس بمراقبة الله تعالى يَختصران الطَّريق أمام الدول والنظُم القانونيَّة نحو ضمان مجتمع مسؤول، لا يَتجاوز حمى العدالة، ولا يَخترق طيفه بدغل نحو ما ليس له، مُجتمع يكون أفراده في كامل استحضار الجزاء بالخير عن الخير وبالشرِّ عن الشرِّ، ويزِنُون كل ما يأتونه من الأفعال بميزان الفضيلة والعدالة، مُجتمع يعيش ضمن خلية يحنو بعضها على بعض، ويمدُّ البعض يد العون للآخر، يَحيون بالحق ومن أجله، طبعًا إذا قوي الحضور الإلهي في ذهن كل فرد على حدة.
أما إذا تجرَّد المجتمع من الدين ومن الدينونة الفطرية لله تعالى، فإنَّ الفرد قد يَدين لقوة القانون، لكن لن يُضيِّع فرصةً تسنَح له لتجاوز القانون من أجل غرضه أو نيته السيئة المبيَّتة، وسيتحيَّن المناسبة لاختراق العدالة إذا رأى في اختراقها مصلحة ذاتية أنانية، لكنَّ صاحب الفطْرة الحية المُمتدَّة بالدين يعلم يقينًا أنه لو تحايل على القانون أو الشريعة ثم قضى نزوته نحو الشَّهوة غير المسؤولة مثلًا أو نحو الظلم، فإنه قد يَسلَم من قبضة القانون، لكنه لن يُفلت من قبضة العدالة الإلهية.
فمُعالجة مثل هذه المواضيع، يستلزم زادًا علميًّا وإيمانيًّا قويًّا؛ إذ لا يُمكن التطرُّق لظاهرة الإلحاد دون التعاطي العِلمي والدراسة الرصينة لكل جوانب الظاهرة النفسية والاجتماعية والثقافية والعِلمية، كيف لا؟ وكهَنة الإلحاد يعتبرون أنفسهم روَّاد العلم والفكر، ومُعتصمين بالنظريات العلمية، طبعًا ليس من نافلة القول أن نشير بالدراسة إلى هؤلاء الذين اعتنقوا الإلحاد لا تعاطيًا مع نظريات علمية أو بحوث أو دراسات. ، لكن استجابة فقط لنزعة ذاتية ترنو إلى تخليص صاحبها من قيود الدين التي تضحي من أجل أنسَنَة ابن آدم.
والذين أنكَروا الدين بسبب سخطهم على أوضاعهم ومُجتمعاتهم، وقعوا في عدمية غائرة، وطرحوا الضمير والدين والمسؤولية وكل شيء.
وقد سميتُ هذا الكتاب: “الله، بِلُغَة العِلم”؛ أي: إن العلم طريق من الطرق التي تقرِّب إلى الله جل جلاله، ودليل من الأدلة عليه تعالى وعلى وجوده وحكمته تحذف، طبعًا إذا أخذ العلم طريقه بتواضُع، يُحلِّل ويبحث صاحبه ما كان إليه سبيل، ولا يتغوَّل وضْع أياديه في كل شيء، المستطاع والمستحيل، الممكن والممتنع.