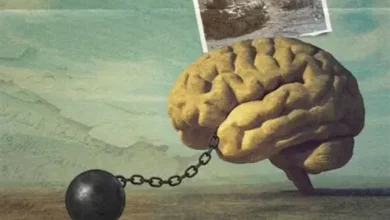الهوية الإسلامية والمؤامرة عليها (4)
أولاً: الهُوِيَّة الدينية ومحاولات طمس معالمها:
كان سعيُ الأعداء لطمس معالم هويتنا الدينية، ذات الصبغة المتميِّزة عن سائر الهويات في مخبرها ومظهرها، والتي تغرس في نفسِ المسلم روحَ الاعتزاز والتأبِّي على الظُّلم والاحتلال – هو الهدفَ الأهم، والغرض الذي يرون في تحقيقه نيل مرادهم، وإطفاء غيظ صدورهم، ولكي يُحققوا هدفهم؛ كان عليهم أن يعدوا خطة ذات اتِّجاهات متعددة، إلاَّ أنَّها تسير في خطوات منسجمة مع بعضها البعض.
كان من أهمها:
أولاً: أن يسيطروا على التعليم، ويمكِّنوا عملاءهم من إدارته:
إذا كانت وقائع التاريخ قد لقَّنت أعداءَ الأمة درسًا خلاصته: أنَّ الأمة لن تركع لغازٍ مهما كانت قُوته، طالما كانت مُتمسكة بدينها؛ لذا فقد عملوا على تغيير أسلوبِ غزوهم، ووضعوا خُطة جديدة، تسعى هذه الخطة إلى ترويض أبناء الأُمَّة على قبول الغزاة.
والمحاولات الضيِّقة لا تُجدي سريعًا مع المستعمرين، إذًا كان لا بُدَّ أن يقوموا بعمليات واسعة النِّطاق، وهذه لا تتم إلاَّ بالسيطرة على العملية التعليميَّة، فمن خلال منهجٍ معدٍّ بإتقان من سن الطُّفولة إلى نهاية المرحلة الجامعية، يتخرَّج حفيد أبطال الإسلام، من أمثال أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والقعقاع، وأبي عبيدة، وخالد… وهو ظبي جفول وديع قد قلّمت هذه المناهج أظافره، وخَضَّدت شوكته؛ إنَّها تلك الخطة الخبيثة التي أجملها الأستاذ محمد إقبال في قوله:
لَيْسَ يَخْلُو زَمَانُ شَعْبٍ ذَلِيلٍ … مِنْ عَلِيمٍ وَشَاعِرٍ وَحَكِيمِ
فَرَّقَتْهُمْ مَذَاهِبُ الْقَوْلِ لَكِنْ … جَمَعَ الرَّأْيَ مَقْصِدٌ فِي الصَّمِيمِ:
َعَلِّمُوا اللَّيْثَ جَفْلَةَ الظَّبْيِ وَامْحُوا … قِصَصَ الْأُسْدِ فِي الْحَدِيثِ الْقَدِيمِ
هَمُّهُمْ غِبْطَةُ الرَّقِيقِ بِرِقٍّ … كُلُّ تَأْوِيلِهِمْ خِدَاعُ عَلِيمِ
هذا هدفهم، وتلك نتيجة خطتهم:
“تعليمُ اللَّيث الإسلامي جَفْلة الظبي، ومحو قصة أُسْدِ الإسلام من العلماء والزُّهَّاد والمجاهدين من تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة.
وأنتجت خطط التربية ذلك الظبي الجَفُول، الذي لم يَعد يقتحم، واستبدل التلفُّت بالعزم، وتعلم المسارعة إلى الهرب، إنَّهم هذا الجيل من أبناء المسلمين، شبل أسد تَحوَّل إلى ظبي وديع، وحر استرقوه ففرح”[1].
إنه التخطيط الخبيث الساعي إلى قتل الرجولة، وحب التميُّز في أبناء الأمة، ويرحم الله الشاعر “أكبر الإله أبادي” حينما قال عن خطورة هذه المدارس والكليات والمناهج التي أعدَّها الأعداء لقتل رجولة أبناء الأمة: “يا لَبلادة فرعون الذي لم يصلْ تفكيرُه إلى تأسيس الكليات، وقد كان ذلك أسهلَ طريق لقتل الأولاد، ولو فعل ذلك لم يلحقه العارُ وسوء الأحدوثة في التاريخ!”.
وحتى تسير الخطة في خطواتها المرسومة دون تعثُّر؛ لا بد من تمكين صنائع المستعمرين من دعاة التغريب من مراكز التوجيه الثَّقافي، وفي المقابل إبعاد كل مُستعصٍ على الترويض متنَزه عن العمالة، عن طريق الخطة، وتنحيته عن المراكز القيادية الثَّقافية، فإذا تمكن هؤلاء (دعاة التغريب) من كراسي التوجيه الثقافي، كان عليهم أن يقوموا بتدريس المنهج المعد (المفرغ من مضامينه الإسلامية) بإخلاصٍ وتفانٍ، بل بزيادة في الإخلاص، وردًّا لجميل أصحاب الفضل عليهم في وصولهم إلى هذه الكراسي، بالرَّغم من وجود الأجدر بها منهم، كان عليهم أن يقوموا بعملٍ آخر، ألاَ وهو:
استقدام مستشرقين لتدريس بعض المواد التي تُمثل أخصَّ خصائص هُويتنا وذاتيتنا، بالرغم من وجود الأَكْفاء عندنا، ولعلَّ من هذا القبيل استقدامَ الدكتور طه حسين للمستشرق “كازانوفا” مدرس العلوم الشرقية بباريس؛ وذلك ليدرس مادة “فقه اللغة العربية”.
ولم يكتفِ الدكتور طه حسين بذلك، بل إنه لَيقول عن “كازانوفا” هذا:
“أريد أن يعلم الناس أنِّي سمعت هذا الأستاذ “كازانوفا” يفسر القرآن الكريم تفسيرًا لغويًّا خالصًا، فتمنيت لو أتيح لمناهجه أنْ تتجاوز باب الرواق العباسي ولو خلسة؛ ليستطيع علماء الأزهر الشريف أنْ يدرسوا على طريقة جديدة نصوصَ القرآن الكريم من الوجهة اللغوية الخالصة على نحو مفيد حقًّا”[2].
ولعلَّ السؤال الذي يتبادر إلى الذِّهن:
كم – يا مَن ترى – كان يظهر عندنا كتابات أمثال “في الشعر الجاهلي” لو حدث ذلك؟ لا شكَّ أن الكثير من الكتابات التي كانت تظهر مُتطاولة على ثوابت الإسلام والهادمة لثقافة الأمة – لو حدث ذلك – ستكون أضعاف أضعاف عددها الكائن بالفعل.
ولقد كان لمثل هذه الأعمال – استقدام المستشرقين ليدرِّسوا ثقافتنا – أعظم الأثر في نفوس النابهين والغَيورين على هوية الأمة، وكان ذلك بالطبع يدفعهم إلى كشف زَيْف التغريبيين وفساد أعمالهم.
ولعلَّ من هذا القبيل قولَ الشيخ (محمود أبو العيون) – رحمه الله – في مُواجهته ونقده للدكتور طه حسين في استقدام “كازانوفا”: “أشدّ ما أحسنت إلينا – أيها الأستاذ – بهذا الاستكشاف الحديث، حقًّا إننا في حاجة إلى مثل هذا العالم اللغوي (الأعجمي) الجليل؛ ليدرس لنا كتاب الله وسنة رسوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وفي حاجة ماسَّة إليه لتدريس الشريعة الغرَّاء وأصولها المستنبطة من الكتاب والسنة، وفي حاجةٍ أمسَّ إلى مثله يُعلمنا البلاغة؛ لأنه يعرف لغةَ القرآن وأسرارَ النزول، أين نحن يا مَن ترى؟ وفي أيِّ عالم نعيش؟ لا شَكَّ أننا في عالَم وهمٍ وخيالٍ، لقد سُلِبنا العقولَ، وحجبنا عن الإدراك، وعمينا عن الحقائق، وأصبحَ الأعجمي بدويًّا قحًّا يعلم كتابَ الله كما أنزل، وأصبح العربي أعجميًّا لا يعرف من لغة العرب شيئًا، والأمر يومئذ لله!”[3].
ومما لا شكَّ فيه أنَّ أمثال “كازانوفا” حينما تتاح لهم الفُرصة؛ ليدرسوا للأجيال المسلمة الناشئة، فإنه لن يترك الفُرصة تَمر دون أن يشوه عندهم الإسلام: عقيدة، وشريعة، ولغة، وتاريخًا، بل إن أول ما سيقومون به هو عملية تجهيل العلم، وربطه بالإلحاد والكفر بالله – سبحانه وتعالى – على خلاف ما هو متعارَف عليه في الإسلام، بل إنَّ عملهم – ولا يزال – عملاً شموليًّا يسعى لهدم العملية التعليميَّة من جميع أركانها، وذلك من خلال وضع الكثير من العوائق والتحديات في طريقها، والتي من أهمها:
محاولات هدم أركان العملية التعليمية:
سعى أعداء الإسلام لهدم أركان العملية التعليمية في بلاد الإسلام، وقد اتَّخذوا لذلك عدة خطوات، من أهمها:
أولاً: السعي لهدم المنهج الدراسي وتفريغه من مضامينه الإسلامية:
اتَّخذ الأعداء عدة وسائل – منذ سيطرة الغرب على عالمنا الإسلامي – لتفريغ المنهج الدراسي من مضامينه وقيمه الإسلامية، وكان من أهم هذه الوسائل:
أولاً: تجهيل العلم بإبعاده عن الله (أو تلحيده بمعنى أصح):
فالمعروف أنَّه منذ بعث الله رسوله محمدًا – صلَّى الله عليه وسلَّم – والعلم في الإسلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإيمان والعقيدة والأخلاق، وفي عالمنا الإسلامي لا تعرفُ الأمة – في ظل الإسلام – ذلك الخصام الذي وقع بين رجال الدِّين وعلماء الكونيَّات في الغرب، فعالم الدين عندنا هو عالم فلك ورياضيَّات وطب وغير ذلك.
ومما لا شك فيه أنَّ هذا الارتباط بين الدين والعلم هو عاملُ دفع للأمام وتوافُق وانسجام في شخصية المسلم؛ إذ عدم الارتباط بين الدِّين والعلم يُحدث في نفس الإنسان ما يشبه الانفصام بين عقيدته وأبحاثه، ومثل هذا لا يتأتَّى منه عمل نافع.
ومن هنا بدأ الأعداء يَفصلون العلومَ والمناهج عن الدِّين، حتى وصل الأمر ببعض العملاء أن جعل دراسة اللغة من أجل الدين سببًا من أسباب ابتذالها[4].
وبدأت النظريَّات الإلحادية تتطرق إلى المناهج الدراسيَّة، وكان من هذا القبيل: تدريس نظرية “دارون” القائلة بتسلسُل الإنسان في نشأته من كائنات دُنيا حتى صار قردًا، ثم بالارتقاء مع الزمن وصل إلى إنسان، والعجيب أنْ تُدرَّس هذه الخرافات المضادة للدِّين، وهي مغلفة بستار زائف من البحث العلمي.
فهل إذا درس التلميذ هذه النظرية تحت اسم “البحث العلمي”، هل تظل عقليته راسخة؟ أم أنَّه يبدأ في التشكك في صحة النُّصوص الدينية؟! وهذا ما حدث بالفعل مع بعض الذين قرؤوا كتاب دارون، وكتابات شبلي شميل، وسلامة موسى، ويَعقوب صروف، مِمَّن اعتنقوا مذهبَ دارون ودعوا إليه، ولعلَّ الأستاذ إسماعيل مظهر كان أحدَ هؤلاء الذين قرؤوا فوقعوا في الشك والاضطراب، حتى يقول عن قراءته لكتاب شبلي شميل “فلسفة النشوء والارتقاء”: “فأحدثت قراءتها في ذهني من الانقلاب ما يعجز قلمي عن التعبير عنه أو وصفه”، ثم يلخص نتيجة خَوضه في بحر الأفكار المادية قائلاً: “على أنِّي إن خرجت من كل ما قرأت، واستجمعت من الآراء والنظريَّات بفكرة يصح أنْ يقال فيها: إنَّها الفكرة المسلطة الآن على مشاعري وإحساساتي، فهي فكرة تتراوح بين الشك واليقين” [5].
وكذلك الذي يقرأ في مذكرات الأستاذ محمد لطفي جمعة، وكيف تأثر بكتابات دارون، وشبلي شميل، ويعقوب صروف – يدرك مدى هذا التأثُّر في سن الصبا، ولعلَّ هذا التأثر هو الذي كان يدفعه لمحاولات الجمع بين مذهب دارون ونصوص الدين – بالرغم من عدم إمكانية الجمع – في قضية خلق الإنسان[6].
وهذا أيضًا الدكتور مصطفى محمود، يتحدَّث عن نفسه في سِنِّ الصِّبا، فيقول: “وغرقتُ في مكتبة البلدية بطنطا وأنا صبيّ، أقرأ لشبلي شميل، وسلامة موسى، وأتعرَّف على فرويد، ودارون”، ثم كان ما كان من تأثُّره بالفِكرة المادية: “لنرفضَ الغيبيات، ولنكفَّ عن إطلاق البخور، وترديد الخرافات، مَن يعطينا دبَّاباتٍ وطائرات، ويأخذ منا الأديانَ والعبادات؟!”[7].
وهؤلاء الأساتذة الثلاثة – إسماعيل مظهر، ومحمد لطفي جمعة، والدكتور مصطفى محمود – قد منَّ الله عليهم بالانخراط في تيَّار الأصالة، والدِّفاع عن ثوابت الأمَّة بعد ذلك، وإن كنا قد ذكرْنا بعضَ كتاباتهم المبكِّرة، فما ذلك إلا لأنَّها تمثل طورًا فكريًّا قد مرُّوا به هم، وغيرهم من الشباب الذين حاولوا التعمُّق في الفِكر المادي، وقرؤوا لدعاته.
وأليس من قبيل “تجهيل العلم”، وتشكيك الناشئة في مُسلَّمات دينهم أن يكتب الدكتور طه حسين كتابه “في الشعر الجاهلي”، ويُدرِّسه للطلبة، وينكر فيه وجودَ سيدنا إبراهيم وإسماعيل – عليهما السلام – مغلِّفًا هذا الفكر في ثوب الاعتماد على ما أثبتَه البحث الحديث – على حدِّ زعمه – في وجود خلاف جوهري بيْن لُغة العدنانيِّين والقحطانيِّين، فيقول: “فواضحٌ جدًّا لكلِّ مَن له إلمام بالبحث التاريخي عامَّة، وبدرس الأساطير والأقاصيص خاصَّة: أنَّ هذه النظرية مُتكلَّفة مصطنعة في عصور متأخِّرة، دعتْ إليها حاجة دينيَّة، أو اقتصادية أو سياسية، للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يُحدِّثنا عنهما أيضًا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يَكْفي لإثبات وجودهما التاريخي”؟![8].
فإذا دَرَّسَ الأستاذ هذا الفكر، وغلَّفه بغلاف البحث العلمي، ألاَ يَفتح المجال أمامَ الطلبة أن يُعمِّموا هذا الضلال، لا على قصَّة واحدة من قصص القرآن، بل على كلِّ القصص القرآني؟! وهذا ما حَدَث بالفعل، وهذا ما قام به الطالِب محمد أحمد خلف الله في رسالته للدكتوراه، والمسماة “الفن القصصي في القرآن الكريم”، حيث ذهب إلى أنَّ “ما بالقصص القرآني من مسائلَ تاريخية ليستْ إلا للصور الذهنية لِمَا يعرفه المعاصرون للنبي – عليه السلام – عن التاريخ، وما يعرفه هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحقَّ والواقع، كما لا يلزم القرآن أن يردَّها إلى الحقِّ والواقع؛ لأنَّ القرآن كان يجيء في بيانه المعجِز على ما يعتقد العربُ، وتعتقد البيئة، ويعتقد المخاطَبون”[9]، ومعنى هذا: أنَّ القصص القرآني ليس من قبيل الحقائق التاريخيَّة، وإنما هو ترديدٌ للقصص المتعارَف عليه بين أهل الجاهلية، وإن كانتْ هذه القصص خرافات، فقد قرَّر القرآن هذه الخُرافات!!
ومِن عجيب ما يُذكر: أنَّ الدكتور المشرف على هذه الرسالة الدكتور (أمين الخولي) دافَع عن فكرة الرِّسالة الضالة دفاعًا شديدًا، حتى قال: “إنها لحقّ، ألْقوا بي في النار”، ولَمَّا أصرَّتِ اللجنة المناقشِةُ رفْضَ الرسالة؛ لِمَا فيها من تكذيب لمصداقية القصص القرآني للواقع التاريخي، انتقدها الكاتبُ الكبير الأستاذ توفيق الحكيم – نعم، فهؤلاء رُوَّاد التنوير عندنا!! – ولم يكتفِ بالنقد، بل لقد استعْدَى على الأساتذة المناقِشين رئيسَ الوزراء في ذلك الوقت قائلاً له: “فالأمر خطيرٌ يا رئيس الحكومة، إلى حدٍّ أطالبك معه بواحد من أمرين، لا ثالث لهما: إما أن تدرأَ في الحال الخطر المحيق بهذه المناورة الفكرية والرُّوحيَّة……… وإمَّا أن تستقيل”[10].
فانظر كيف لا يتوقَّف الأمرُ على ترويج الضلال، بل إنَّه يمتد لحالة الإرهاب الفِكري لكلِّ مَن يوجهه، فإذا كانتْ هذه هي الثقافةَ التي تبثُّها المدارس والجامعات في نفوس الطلاَّب، فهل يبقى للهُويَّة الإسلامية أثرٌ يُذكَر في نفوس الأجيال المُقبِلة؟!
إن أبْسط وصْفٍ للهيئة التعليمية التي تتبنَّى نشْرَ هذه المناهج: أنَّها هيئة خائنة للأمَّة في أثمنِ ما تملك من كنوز، وأعزِّ ما تملك من ثروة؛ لأنَّ كنوز الأرض لا تساوي شيئًا بدونها، إنها الثروة البشرية بما تنطوي عليه مِن قُوى مادية، ومِن مَلَكاتٍ عقليَّة وخلقيَّة.
هذه النظرة العميقة للمؤسَّسة التعليمية – وللمدرسة بصفة خاصَّة – هي التي ينطلق من خلالها الكيانُ الصِّهْيَونيُّ في إنشائهم لأجيالهم.
يقول اليهودي “ساشر”: “إنَّنا لا ننظر في إيجاد مدرسة في فلسطين كمجرَّد وسيلة لتعليم عدد من الطلاَّب اليهود هناك، بل أبعد مِن ذلك، إنها رمزُ المهمة العظيمة الملقاة على عاتقنا في تربية ذاتنا…. إنها رمزٌ لإعادة بناء أجيالنا بناءً قوميًّا، ووعْد بالاستمرار القومي في المستقبل”.
وقال جاكوب كلاتزمان: “تؤلِّف دباباتُ سنتوريون عاملاً من عوامِل الأمن والسلامة على المدى القريب، ولكنَّ المدرسة والجامعة هي العوامل الأكثر أهميَّةً بالنِّسبة للمستقبل البعيد”.
هذه نظرة أعدائنا إلى المدرسة والجامعة، وهذه نظرةُ القائمين عليها في بلادنا، ومِن ثَمَّ كان للقِسِّ زويمر أن يفخر قائلاً: “لقد قضيْنا على برامج التعليم في الأقطار الإسلامية منذ خمسين عامًا، فأخرجْنا منها القرآن، وتاريخ الإسلام، ومِن ثَمَّ أخرجْنا الشباب المسلمين من الوسائط التي تخلق فيهم العقيدة والوطنية، والإخلاص والرجولة، والدِّفاع عن الحق، والواقع أن القضاء على الإسلام في مدارس المسلمين هو أكبرُ واسطة للتبشير، وقد جِئْنا بأعظمِ الثمرات المرجُوة منه”[11].
وإذا كانتْ هذه هي الحالةَ الفِكرية التي وصل إليها بعضُ الطلاَّب الذين يتلقَّوْن العلم من خلال المناهج الدراسية – في أقطارنا الإسلامية – فما بالنا بِمَن يذهبون إلى الغرب بعد أن يرضى المستعمِرون عنهم، ويأخذونهم في بعثات دراسيَّة في بلادهم؟! وما هو – يا ترى – الإعدادُ الذي يعدُّه الغرب لهم، والمناهج التي تُدرَّس لهم، والدور الذي يُطلَب منهم بعدَ ذلك؟
جاء في كتاب “المشكلة الشرقية “: “لا شكَّ أنَّ المبشِّرين فيما يتعلق بتخريب وتشويه عقيدة المسلمين قد فَشِلوا تمامًا، ولكن هذه الغاية يمكن الوصولُ إليها من خلال الجامعات الغربية، فيجب أن تَختارَ طلبةً من ذوي الطبائع الضعيفة، والشخصية الممزَّقة، والسلوك المنحلِّ من الشرق، ولا سيَّما من البلاد الإسلامية، وتمنحهم المِنحَ الدراسية، حتى تبيعَ لهم الشهادات بأيِّ سعر؛ ليكونوا المبشِّرين المجهولين لنا، لتأسيس السلوك الاجتماعي والسياسي، الذي نصْبوا إليه في البلاد الإسلاميَّة.
إنَّ اعتقادي لقويٌّ بأنَّ الجامعاتِ الغربيةَ يجب أن تَستغلَّ استغلالاً تامًّا جنونَ الشرقيِّين للحصول على الدرجات العِلمية والشهادات، واستعمال أمثال هؤلاء الطلبة كمبشِّرين ووُعَّاظ ومدرِّسين لأهدافنا ومآربنا باسم تهذيب المسلمين والإسلام”[12].
فهذا هدفٌ يسعَوْن إليه، وهناك هدفٌ آخرُ أَوْجزه اللورد كرومر مِن هؤلاء المبعوثين عندما قال: “إنَّ الشباب الذين يتلقَّوْن علومَهم في إنجلترا وأوربا يَفقِدون صلتَهم الثقافية والرُّوحيَّة بوطنهم، ولا يستطيعون الانتماءَ في نفس الوقت إلى البلد الذي منَحَهم ثقافته، فيتأرجحون في الوسط، ويتحوَّلون إلى مخلوقات شاذَّة ممزَّقة نفسيًّا”[13].
وهل هناك خيرٌ يرجى للأمَّة من وراء إنسان أصبح ممزَّقًا نفسيًّا؟! بل أوليستْ هذه كذلك أعظمَ خسارة تخسرها الأمَّة، حينما يتحوَّل أبناؤها إلى هذه الحالة؟!
ثانيًّا: تحدِّي غرْس ثقافة الاستسلام من خلال المنهج الدراسي:
كان للسيطرة والهيمنة الأمريكيَّة على دول العالَم الإسلامي – وخاصَّةً الدولَ العربية – أعظمُ الأثر في تفريغ المناهج الدراسيَّة مِن كل ما يَغْرس في نفوس الناشئة الرجولةَ وحبَّ الجهاد، وحبَّ الدِّفاع عن الأوطان، ووضعوا مكانَ ذلك ما يغرس في نفوس الشباب الخنوعَ والاستسلام، تحت مسميات كاذبة، مثل السلام والأخوة بين البشر، والمحبة بيْن الناس، وغير ذلك.
وقد مهَّدَتْ لذلك – وبالأخص في مصر – هيئةُ المعونة، عندما أنشأَتْ شُعبة تطوير المناهِج والبرامج التعليمية عام 1987، ومعظم خُبرائها من الأمريكان، ويحصلون على 70 ٪ من أموال المعونة، وقد قامتْ هذه الهيئة بحذف 30 ٪ من المناهج تحت مسمَّى حذْف الحشو؛ مما أدَّى إلى غياب الفِكر والمادة العِلميَّة من المنهج.
وبداية من أغسطس عام 1992، تم تطوير 57 كتابًا بمختلف مراحل التعليم، وخاصَّة مواد اللُّغة العربية، والتربية الدينية، حيث شَهِد كتاب التربية الدينية للصف الخامس تشويهاتٍ شديدةً أدَّت إلى ثورة في الأزهر، ومركز البحوث التربوية.
وتولَّى مرْكز تطوير المناهج برئاسة الدكتورة كوثر كوجك استكمالَ لعبة التغيير في المناهج، حيث كشف تقريرٌ سِريٌّ للمركز عن قيام فريق أمريكي برئاسة “يرالد تيرث”، وعضوية “د.بيتر نومان دوجوان” بمراجعة ووضْع 70 كتابًا في مختلف الفِرق الدراسية في التعليم العام، كما وضعوا دليلاً لإعداد المناهج والموادِّ التعليمية، أسموه “مصفوفة المدى والتتابع”، وظلَّ هذا المركز يَعقد حلقاتٍ نقاشية مع الخبراء الأمريكان، ومؤلِّفي الكتب المدرسيَّة؛ لتحديد التعديلات الجديدة المصبوغة بالصِّبغة الأمريكية.
وفي عام 1996 ظهرتِ التغييرات بشكل عملي في جميع المناهِج، ولجميع سنوات التعليم الأساسي، حيث تمَّ خفضُ حجم المناهج، مع تضمين جميع الكتب للمفاهيم والقضايا والتوجُّهات التي تريدها أمريكا، بل وسارتِ المناهج في اتجاه التطبيع مع إسرائيل، حيث الدعوةُ للسلام، والتربية من أجل السلام، والتآخِي والتسامح بين الشعوب[14].
ولقد كشفتْ دراسةُ الدكتور علي الجمل – أستاذ تدريس المناهج بتربية عين شمس – وعنوانها “تدريس التاريخ في القرن الواحد والعشرين” عن أنَّه: منذ اتَّجهت الدول العربية إلى السلام مع إسرائيل – بخاصَّة مصر – بدأتْ مناهجُ التاريخ تخدُم هذه الفِكرة، وترتَّب عليه تغيُّرٌ في المناهج الدراسية، واختفى منها كلُّ ما يحضُّ على الجهاد والتضحية باعتبارها مصدرًا للعنف والتطرُّف، وبث كلِّ معاني الحبِّ بهدف إعداد جيل مسالِم يدعو للحبِّ والسلام، ولا يعرف شيئًا عن عدوِّه، ومِنْ ثَمَّ غابتْ عن مناهج التاريخ الكثيرُ من المبادئ والمواقف والأحداث، التي تستطيع الإسهامَ في إعداد المواطِن ذي الوعي المستنير، القادر على الدِّفاع عن وطنه وقتَ الحرْب، وتنميته وقت السلم.
وتقول الدراسة: إنَّ السؤال الذي يطرح نفسَه هو: هل سنظلُّ نغرس في نفوس أبنائنا السلامَ فقط، ونهمل إعدادَهم على التضحية والفِداء، والدِّفاع عن الأرض والوطن الذي يُنتهَك في كلِّ شبر من أرض الإسلام؟!
ويتساءل متعجِّبًا في دراسته: كيف نربِّي أبناءنا على السلام فقط، ويربِّي أعداؤُنا أبناءَهم على قتْلنا، وسَفْك دمائنا؟!
فلو نظرْنا إلى النظام التربوي الإسرائيلي نَجِد ظاهرةَ التعصُّب الصِّهْيوني واضحةً في مناهجهم، وأنَّ التوجُّه العنصري ضدَّ العرب واضحٌ في تلك المناهج، فتعرِض العربيَّ على أنه متخلِّف في مقابل اليهودي المتقدِّم.
ويقول الأستاذ علي الجمل في دراسته: إنَّ الموضوعاتِ التي تعرِضها مناهج التربية والتعليم في إسرائيل ليستْ نكتة أو فكاهة، بل حقيقة تربوية أدَّتْ إلى مجازرَ عسكرية، ومطاحنَ بشرية، يتربَّى بنو إسرائيل على إدارتها وإشاعتها، ومنها مسألة حسابية، تقول: هناك 100 عربي قتلْنا منهم 30، فكم الباقي الذي يلزمنا قتلُه؟ [15].
ونحن ما زالتْ مناهجنا لا تعرف غير: الأُخوة بين البشر، السلام العالمي، المساواة، وغير ذلك من الركائز التي يدعمون من خلالها ثقافةَ الاستسلام، وقلْم الأظافر، والترويض والتدجين للأجيال المسلِمة.
ثالثاً: تحديات تواجه التلميذ:
التلميذ هو الهدف والغاية من وراءِ العملية التعليمية؛ لذا فقد وضعتِ التدابير المُحكَمة كي يتحوَّل إلى نموذج مهزوز، مفرَّغ من القيم الإسلامية والرجولة، بل وجَعْله يرى كلَّ غربي على أنه مظهر الحضارة، بل والنموذج الذي ينبغي أن يُحتذَى.
وفي المقابل ينظر إلى كلِّ إسلامي على أنَّه مظهرُ التخلُّف والجمود، أوَليستْ هذه النتيجة التي ذكَرَها اللورد كرومر حينما قال عن الشباب الذين تثقَّفوا على يدِ الغربيين: “يتأرجحون في الوسط، ويتحوَّلون إلى مخلوقات شاذَّة ممزَّقة نفسيًّا”؟!
وهي النتيجة التي ذكرها – على سبيل الافتخار بإنجازهم – القِسُّ زويمر حينما قال: “لقد قضيْنا على برامج التعليم في الأقطار الإسلامية منذ خمسين عامًا، فأخرجنا منها القرآن وتاريخ الإسلام، ومن ثَمَّ أخرجْنا الشباب المسلمين من الوسائط التي تخلُق فيهم العقيدةَ والوطنية، والإخلاص والرجولة، والدِّفاع عن الحق”.
والواقع: أنَّ المؤامرة على ركن “التلميذ” في العملية التعليمية قد امتدتْ لتشمل:
أولاً: قتْل المواهب الإبداعية لدى التلميذ:
وفي سبيل تحقيق ذلك فقد عَمَد الأعداءُ وعملاؤهم إلى تنحية كلِّ ما مِن شأنه أن ينمِّي مواهبَ التلميذ، ويغرس في نفسه حبَّ إعادة أمجاد أجداده المسلمين.
يتحدَّث الأستاذ فهمي هويدي عن نموذج في هذا الصَّدد في إحدى الدول العربية، تمَّ فيه حذْف عِدَّة دروس كانت مقرَّرة على التلاميذ، يقول: أثار انتباهي بشدَّة مضمونُ تلك الدروس المحذوفة، فأحدها تحدَّث عن القعقاع بن عمرو التميمي، الذي اشتهر بالجِهاد والقوَّة، وكان إضافةً مهمَّة لقوَّة ونصْر أي جيش ينخرِط فيه… ثمة درس آخَرُ عنوانه “حاجة الشرق إلى التربية الحربية” تحدَّث عن أهمية التسليح كي لا نكونَ نهبًا للظالم، وفريسةً للمعتدي، وأشار إلى أنَّ التربية الحربية التي يجب الالْتزام بها في الشرق ينبغي أن تكونَ على أحدث نهْج، وأفضل نُظم الحرب؛ لأنَّ القُنبلة لا تُواجَه بالسيف.
وهناك درس آخر بعنوان “على غار حراء” تحدَّث الدرس عن الإسلام دِين العلم، وفيه ردٌّ على الذين ادَّعَوْا أنَّ رسالة الإسلام هي شِرعة السيف وحْدَه.
ومن المحذوفات أيضًا: وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، حين أمَّرَه على الجيش المتجه إلى العراق، ومما ورد في الكتاب قولُ عمر: “ولا تؤت بأسير ليس له عَقْد – أو عهد – إلاَّ ضربت عنقه لتُرهبَ به عدوَّ الله”.
ومن المحذوفات كذلك درسان يتحدَّثان عن علوم العَرَب، وأثرها في نهضة أوربا، ودرس آخر موضوعه: الموسوعات العربية في العصر المملوكي، ودراسة في كتاب “صبح الأعشى”، وقد تضمن استعراضًًا للفساد، وتدهور القيم الأدبية، وأشار أنه بفساد السلطة ينتشر الجهل، وتنهار الأمم، كما أنَّه تحدَّث عن نِفاق البعض الذي يؤدِّي إلى تصويب الخطأ الذي يرتكبه رؤساءُ القوم، وتحسين القبيح.
وبعدَ أن استعرض الأستاذ فهمي هويدي الموضوعاتِ المحذوفةَ، قال: “إذا صحَّ أن النصوص المحذوفة بالمضمون الذي سبق ذِكْرُه – وأغلب الظنِّ أنه صحيح – فإنَّنا نكون بصدد نموذج استبعدتْ منه المعاني التالية:
قيمة الشجاعة والبطولة في درس القعقاع، قيمة الإعداد تحسبًا لاحتمالات العدوان، وضرورة توفير القُدرة العسكرية للأمَّة في درس “حاجة الشرق إلى التربية الحربية”، أهمية التعلُّق بالعِلم والتمكُّن من السلاح للتغلُّب على الذين يُعطِّلون سعينا إلى السلام، مع احترام أصحاب العَهْد في درس “غار حراء”، والاعتزاز بما حقَّقَه العرب من نهضة في الماضي واستفاقتهم في الحاضر، والتنبيه إلى أنَّ مِن شأن فساد السلطة انتشارَ الجهل، وانهيارَ الأمم، مع التحذير من النِّفاق في الحياة العامة في الدرس الأخير المتعلِّق بالموسوعات العربية.
حين يُدقِّق المرء في مضمون تلك النصوص، والمعاني والقِيم التي تبثُّها في مدارك الطلاب والطالبات، يلاحظ أنَّ الذي حُذِف هو بالضبط ما يُرجَى من العملية التعليمية أن توصلَه، أو تزرعه في نفوس الأجيال الجديدة.
لا نعرف المعاييرَ التي على أساسها تَمَّ الحذْفُ، كما أننا لا نستطيع أن نُعمِّم تلك المعايير، أو نفترض ما حَدَث – في هذه الدولة العربية – تَكرَّر بنفس الأسلوب في بقية الدول العربية، مع ذلك فبوسعنا أن نُقرِّر أمرين:
أولهما: أنَّ النموذج الذي بين أيدينا يذهب في مراميه إلى أبعدَ بكثير مِن تجفيف منابع التطرُّف، أو مكافحة الإرهاب، بل هو أقربُ إلى تجفيف الشخصية نفسِها، وتحويلها إلى نموذج باهِت، مهزوز القِيَم، عاجز عن أن يكون غيورًا على أمَّته، أو إيجابيًّا في مواقفه، أو حتى معتزًّا بهُويته.
أما الأمر الثاني: فهو أنَّ عملية مراجعة المناهِج الدراسية شملتْ جميعَ الدول العربية، وأنها كانت أحدَ المطالب التي ضغطتْ لتحقيقها الإدارةُ الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر في إطار ما سُمِّي حرْبَ الأفكار، التي استهدفتْ تغيير المدارك والعقول؛ لكي تصبحَ أكثر استعدادًا للتكيُّف مع أوضاع الهيمنة الأمريكيَّة والإسرائيلية على المنطقة”[16].
فانظر كيف يجتهدون في حذْف كلِّ ما مِن شأنه أن يُخرِج مسلمًا مثقَّفًا، مستنيرًا واعيًا، قادرًا على العطاء، معتزًّا بتاريخه، معتزًّا بهُويته.
ثانيًا: غرْس قيم الفكر الغربي في نفوس التلاميذ:
لم يَكتفِ الأعداءُ وعملاؤهم بعملية مسْخ المناهج، ولا بتجفيف مواهبِ التلميذ الذاتية – بدل تنميتها – بل لقد سَعَوْا إلى غرْس قِيم الفكر الغربي في نفوس التلاميذ منذ سِنٍّ مبكِّرة.
ولعلَّ كلَّ هذه الخُطوات هي ما أطلق عليها علماؤنا: “سياسة التفريغ والملء”، فهم يُفرِّغون عقل التلميذ من قيمه الإسلامية، حتى إذا أصبح هذا العقل صفحةً بيضاء، قاموا بتلقيحه بقِيَم الفكر الغربي.
وانظر إلى هذه الخُطوة:
تقول جريدة “آفاق عربية”: “أكَّدتْ مصادرُ بوزارة التربية والتعليم بمصر: أنَّ الوزارة ستعقد اتفاقيةً مع الوكالة الأمريكية للتنمية، سيتمُّ بموجبها تعميمُ مشروع أمريكي جديد تحت عنوان “مكتبتي العربية”، حيث سيتمُّ توزيع كتب ذات طباعة فاخِرة ملونة، مترجمة عن كتب أمريكية تتبنَّى قِيَمًا غربية؛ لترويجها بين تلاميذ الصفَّيْن الثالث والرابع بالمرحلة الابتدائية، وتناقش الكتبُ الموضوعاتِ الجنسيَّة.
جديرٌ بالذِّكْر: أنَّ هذا المشروع لم يقتصرْ على مصر، بل سيُعمَّم على كل الدول العربية، ويستهدف ثلاثة آلاف مدرسة عربية، وسيتمُّ من خلاله توزيعُ مليون كتاب على 120 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و6 آلاف معلِّم ومعلِّمة”[17].
وبالإضافة إلى ذلك، ولتتم عملية “غسيل المخ”، أو”ملء الفراغ” على خير وجهٍ؛ قاموا بتلك الخُطوة التي تَرْمِي إلى رصْد مائة مليون جنيه بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي؛ لتنفيذ برنامج لإعداد وتنمية القادة من خِرِّيجي المدارس المصرية، ويستوعب هذا البرنامج 162 طالبًا وطالبة؛ وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس في خلال ثلاث سنوات، واشترط على المرشحين أن يكونوا من الحاصلين على 85 ٪ على الأقل في الثانوية العامة، ودرجات عالية في اللغة الإنجليزية، وسيُلحق المتميِّزُون بعد البكالوريوس بالجامعات الأمريكية، وسيتمُّ إلحاق قادة المستقبل هؤلاء بالولايات المتحدة لفَصْل دراسي كامل[18].
بل انظر إلى خطورة هذه الخُطوة على عقول أبناء المسلمين وهُويَّتهم الإسلامية، والتي حذَّر منها أهلُ الغَيْرة على ثقافة الأمَّة وقيمها، وكان من بينهم الأستاذ علي لبن الذي تقدَّم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم: يقول: إنَّ إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التربية والتعليم أرسلتْ خطاباتٍ إلى جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر، تطلب فيها من جميعِ المدارس الإعدادية والثانوية ترشيحَ عدد 30 طالبًا وطالبة من المتفوِّقين، ممن تتراوح أعمارُهم ما بين سن 15 و18 سنة للسَّفَر والإقامة المجانية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لمعايشة بعضِ الأُسَر هناك لمدَّة لا تقلُّ عن عام.
وكشف الأستاذ علي لبن عن أنَّ هذه المِنحة المجانية تقف وراءَها منظَّمة عالمية، مقرُّها نيويورك تُسمَّى (الشبكة العالمية للتربية والمصادر “iearN”)، وأنَّ مؤسسها يُدعَى “بيتر كوين”، وهو يهودي الأصل، ودخلتْ مصر عن طريق التعاقد مع وزارة التربية والتعليم عام 1999م، وتضمُّ في عضويتها اثنين من السِّفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح الأستاذ علي لبن: أنَّ من أهداف الشبكة غرْسَ ما يُسمَّى بقِيم التسامح والإخاء العالمي بغَضِّ النظر عن الدِّين والجنس، واعتقاد أنَّ العالم كله أسرة واحدة كبيرة، لا يمكن أن تتجزأ، وهي نفس أهداف الماسونية العالمية التي تتعارض مع ثوابتِنا الإسلامية الصحيحة، فضلاً عن سعيها إلى طَمْس هُويتنا، ومَحْو خصوصيتنا الدِّينيَّة والثقافية[19].
أرأيتَ ما يُعدُّ لأبنائنا التلاميذ؟! أترى أنَّ هؤلاء يعودون وهم يعتزُّون بدِينهم ووطنهم وثقافتهم؟! أم أنهم يعودون لا يُمجِّدون ولا يعرفون سوى الغَرْب وثقافة الغرب، والخضوع للغرب؟! بل إنهم بعد أن يُصبِحوا قادةً للمجتمع يقومون بكَبْت كلِّ صوت، أو فكر يُخالِف أهدافَ الغرب وأغراضه.
نعم، إنها النتيجةُ الحتمية التي تنتجها التربيةُ الغربية – إلا ما رحم ربُّك – وانظر إلى هذه الإجابة مِن جان بول سارتر عن سؤال وُجِّه إليه، ألاَ وهو: كيف يظهر المفكِّر في الشرق الإسلامي؟
فأجاب: “كنَّا نحضِّر أبناء رؤساء القبائل وأبناء الأشراف والأثرياء والسادة مِن أفريقيا وآسيا، ونطوف بهم بضعةَ أيام في لندن وباريس وأمستردام، فتتغيَّر ملابسُهم، ويلتقطون بعضَ أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة، ويرتدون السترات والسراويل، ويتعلَّمون لُغتَنا وأساليب رقصنا، وركوب عرباتنا، وكنَّا نُروِّح بعضهم في أوربا، ونلقِّنُهم أسلوبَ الحياة على أثاث جديد، وطرز جديدة من الزِّينة، واستهلاك أوربي، وغذاء أوربي، كما نضع في أعماق قلوبهم أوربا، والرغبة في تحويل بلادِهم إلى أوربا، ثم نُرسِلُهم إلى بلادهم، حيث يُردِّدون ما نقوله بالحَرْف تمامًا، مثل الثقب الذي يتدفَّق منه الماء في الحَوْض، هذه أصواتُنا تخرج من أفواههم، وحينما كنا نتحدَّث كنَّا نسمع انعكاسًا صادقًا وأمينًا لأصواتنا من الحلوق التي صنعناها، وكنَّا واثقين أنَّ هؤلاء المفكِّرين لا يملكون كلمةً واحدة يقولونها، غيرَ ما وضعنا في أفواههم، ليس هذا فحسبُ، “بل سَلَبوا حقَّ الكلام مِن مواطنيهم”[20].
لعلَّ هذه الكلماتِ تبيِّن لنا سببَ حرص الغرب على مِثْل هذه البعثات المجانية لأبناء المسلمين في هذه السِّنِّ المبكرة، بل ودمجهم في أُسَر أمريكية أو غربية، لها فِكرُها وقيمها، وتقاليدها المغايرة تمامًا لقِيَمنا الإسلامية، إنهم بحقٍّ قادة المستقبل بأيدٍ وفِكر أمريكي وغربي، أُعِدُّوا إعدادًا خاصًّا؛ ليكونوا في المستقبل – بعد أن يصبحوا القادة – أبواقًا تُردِّد ما يقال لها من الغرب، وسلاحًا يسحقُ كلَّ صوت يخالف ما يريده الغرب.
الركن الثالث: تحديات في مواجهة المعلم:
وركن (المعلم) في العَملِيَّة التعليميَّة لا يقلُّ أهميةً عن رُكْني (المنهج، والتلميذ)، ولمكانة المعلِّم وأثره في بناء المجتمع، فقدْ حثَّ الإسلام على احترامه وتكريمه، إذ بدون احترامه وتكريمه لن يُخرِجَ ما عنده من علوم ومعارفَ، ولله درُّ القائل:
إِنَّ الْمُعَلِّمَ وَالطَّبِيبَ كِلَيْهِمَا ♦♦♦ لاَ يَنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ يُكْرَمَا
وممَّا لا شكَّ فيه: أنَّ عدم احترامه، ومِنْ ثَمَّ عدم نصحه، يُحدِث انقطاعًا في التراكم الثقافي بين أجيال الأمَّة، ولا يخفى أثرُ هذا الانقطاع على تقدُّم الأمة وتحضُّرها، ولعلَّ هذا الأمرَ هو الذي جعل الحكوماتِ الواعيةَ الجادة في إيجاد نهضة حقيقية تبدأ أوَّلاً بإعطاء المعلِّم مكانتَه في المجتمع، ونحن في هذا الصدد نتذكَّر على الفَوْر اليابان؛ تلك الدولة التي ضُرِبت بالقنبلة الذرية، وبالرغم من ذلك تصبح في مدَّة عقدين من الزمان من أكثر دول العالم تقدُّمًا، وما ذلك إلاَّ لأنها اهتمتْ بالمعلِّم، فأعطتْه مرتَّبات الوزراء، ومنحتْه صلاحياتِ وكلاء النيابة. أما المعلم عندنا:
أولاً: تجد وسائلَ الإعلام تسعى جاهدةً لضرب قِيمته في المجتمع، مِن خلال إظهاره مُزدرى الشكل والهيئة، كما تسعى لضرْب قِيمته في المدرسة، وداخل الفصل بين التلاميذ، وليستْ مسرحية “مدرسة المشاغبين” خافيةً على أحد، والإنسان يتساءل: كيف تنهض أمَّةٌ تغرِس في نفوس الطلاَّب أن يتعاملوا مع المعلِّم بهذه الكيفية؟!
وكم كان عرْض هذه المسرحية سببًا في تطاول الطلاَّب على الأساتذة!
ثانيًا: ضعْف راتب المعلِّم؛ مما يجعل – مع غلاء المعيشة – الكثيرين منهم يُقصِّرون في الشرْح في الفصل المدرسي؛ كي يَحملَ الطلاَّبَ على الدروس الخصوصية، وفي مقابل ضعْف راتب المدرِّس تجد ما يُشبه الجنون في الإنفاق على الأفلام والكُرة، وغير ذلك.
وممَّا لا شكَّ فيه: أنَّ هذا الوضع المزرِي للمعلِّم أدبيًّا وماديًّا أدَّى بالطبع إلى غياب الاحترام والتقدير اللَّذين كان يحظَى بهما في الماضي، وممَّا ساعد على انتشار هذه الظاهرة (عدم احترام المعلم) ما حاولتِ المؤسَّسات التعليمية تقريرَه – وبقُوَّة – وهو منْع التأديب المتمثِّل في الضرب (غير المبرِّح)، بل وأصبح تأنيبُ الطالب وزجره وتقويمه جريمةً نكراء، فكان لا بدَّ أن تبدأ ظاهرةُ التطاول على المعلِّم، بل وصل الأمر إلى الاعتداء عليه داخلَ المدرسة أو خارجَها، بل ربَّما يقف المعلِّم أمام القضاء كسائر المجرمِين؛ لأنَّ طالبًا قد اشتكاه، ومما لا شك فيه أنَّ هذا الوضع يصرِف المعلِّم عنِ الاهتمام بأداء واجبِه، ومِنْ ثَمَّ تتقوَّض أُسس التربية، وقواعدُ الأخلاق، وينقطع سَيْل التراكم المعرفي، فتتخلف الأمَّة عن ركْب الحضارة.
ثالثًا: إبعاد المدرِّسين الملتزمين دينيًّا، وتحويلهم إلى إداريِّين:
وتُعتبر هذه الخطة من أخبث ما دبَّرَه أعداؤنا، ونفَّذه عُملاؤهم في بلادنا؛ إذ الثابت أنَّ المعلِّم المتديِّن انطلاقًا من إدراكه لواجبه ومسؤوليته أمامَ الله، فإنَّه يجتهد في توصيل مادته العِلمية لأولاد المسلمين، ثم انطلاقًا من غَيْرته الدينيَّة، فإنَّه يسعى جاهدًا في غَرْس مبادئ الإسلام في نفوس التلاميذ، وتعريفهم بعَظمة الإسلام، ولَفت أنظارهم إلى المؤامرة على عالَمنا الإسلامي، وكلُّ ذلك يخشاه أعداؤنا، ويخافون مِن خروج أجيال مسلِمة تعي ذلك، ومن هنا فقد حَرِصوا على إبعاد كلِّ المدرسين الذين يتأتَّى منهم إفساد خطتهم.
وإذا كانت حكوماتُنا تجتهد في إبعاد المتدينين مشاركةً منهم في سياسة “تجفيف المنابع الدينية”، فهل تُلام سلطاتُ الاحتلال اليهودي في فلسطين إذا قامتْ بفصل مجموعات من المعلِّمين النشطِين فصلاً تعسفيًّا، كمحاولة منها لقطْع أرزاقهم، وحرمان الأجيال المسلِمة من التربية الإسلامية الصحيحة، وترْك هذه الأجيال تتخبَّط في ظلمات الجهل؟ بالطبع لا يُلام الصهاينة؛ إذ إنَّهم رأوا حكوماتِنا قد سبقتهم في هذا الاكتشاف، وحازوا قَصَبَ السَّبْق في هذه المنطقة الإسلامية بعدَ مجرِمي الشيوعية في روسيا، وما فعلوه في المسلمين هناك كي يُجفِّفوا منابع الإسلام هناك على المدى البعيد، ولعلَّ هذا الكلام يقودنا إلى الحديث عن خطَّة تجفيف المنابع الإسلامية في روسيا، وكيف سار على نهجها عملاءُ الاستعمار في بلادنا الإسلامية.
وهذا موضوع حديثنا القادم إن شاء الله – تعالى.