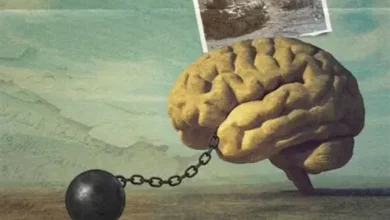الهوية الإسلامية والمؤامرة عليها (3)
نبذة عن تاريخ المؤامرة على الهوية الإسلامية
تم فضل الله، وعظُم إحسانه على خلقه ببَعْثَة خاتم رُسُله، وإظهار دينه على جميع الخلق، وكان لانتصار الإسلام على أصحابِ الدِّيانات والهويات الأخرى أعظم الأثر في نُفُوسهم، فكان منهم مَن أحسَّ بعظمة الإسلام، فدخله بنفسٍ راضية، واجتهد في تعلُّم العربية، بل أقبلَ عليها بشَغَف؛ ليفهم القرآن الكريم وأحاديث رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ومنهم من أكل الحقد قلبه، ولكنه لإدراكه قوة الإسلام، علم أنَّ السبيلَ للقضاء على قوة المسلمين ليس في مُواجهتهم بالسلاح، وإنَّما في استخدام المكر والحيلة، فأخذ يتظاهر بالإسلام، ومن خلال هذا التظاهُر أخذ ينشر أفكارَه القديمة، وآراءه التي تفرق وحدة المسلمين، وتضعف قوتهم.
وقد اتَّخذ هذا الأسلوب بعضُ اليهود وبعض النصارى الذين أكل الحقدُ قلوبَهم؛ بسبب انتصار الإسلام عليهم، وإجلاء الرسول لهم من المدينة، ووصيته في آخر كلام له بإخراج يهود الحجاز ونصارى نجران من اليمن من جزيرة العرب، وقد تم إخراجهم في عهد عمر – رضي الله عنه – واختار لهم أرضًا جديدة بين الشام والعراق.
وكان ممن أكل الحقدُ قلبه كذلك، ولم يستطعْ أن ينتقمَ لدولته التي قوَّض الإسلام أركانها: بعضُ أهل الفرس، وبعض أهل الروم، وبالأخص وهم كانوا ينظرون إلى العرب بعين الازدراء والاحتقار، ولعلَّ مما يلفت النَّظر لمدى هذا الاحتقار تلك الكلمة الخبيثة، التي قالها ملك الفرس لما وصله كتابُ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقال: “عبدي يكتب إليَّ”، وما كتبه يزدجرد إلى سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قائد معركة القادسية، يقول له: “إنَّ العرب مع شرب ألبان الإبل وأكل الضب بلغ بهم الحال إلى أن تمنَّوا دولة العجم، فأفٍّ لك أيها الدهر الدائر”.
بدأ هؤلاء الأعداء المتسترون في الإسلام يضعون الخطط؛ للتخلُّص من هذا الدين القوي، الذي قوَّض أركان دولتهم، والذي لا يُمكنهم مواجهته بالسِّلاح، وإنَّما عليهم أن يواجهوه بتدبير خبيث يتم في السرِّ وفي مأمن من ملاحقة الدَّولة الإسلامية اليقظة، وإليك بعضَ نماذج هذا الكيد المستتر:
أولاً: الحركات الباطنية أولى حلقات المؤامرة على الهوية الإسلامية.
بدأت هذه الحركات في وقت مُبكر، وفي تستر كامل؛ نظرًا لضعفها، وإدراكًا منها لوعي المجتمع، وقوة إحساسه بأي أمر دخيل يُخالف هُوِيَّته وعقيدته.
وكانت حركة السبئيِّين، بقيادة “عبدالله بن سبأ” اليهودي هي أولى هذه الحركات ، التي بدأت محاولات تشويه الهوية الإسلامية، من خلال المبادئ التي أخذ ابن سبأ ينشرها، وهي أنه وجد في التوراة أنَّ لكل نَبِيٍّ وصيًّا، وأن عليًّا وصيُّ محمد، وأنه خير الأوصياء، كما أن محمدًا خير الأنبياء، ثم إن محمدًا سيرجع إلى الحياة الدنيا، ويقول: عجبت لمن يقول برجعة المسيح، ولا يقول برجعة محمد، ثم تدرج إلى القول بألوهية عليٍّ – رضي الله عنه.
ولقد همَّ سيدنا علي بقتله، فنهاه عن ذلك عبدالله بن عباس – رضي الله عنه – فنفاه إلى المدائن، ولما استشهد سيدنا علي، استغلَّ ابن سبأ ألَمَ الناس لفقده، وعاد إلى أباطيله مدعيًا أن المقتول ليس عليًّا، وإنَّما هو شيطان تصوَّر صورته… إلى غير ذلك1.
ثم على منهاج ابن سبأ تتابعت الحركات الباطنية، التي رأت أنَّ خير وسيلة للقضاء على الإسلام هي تشويهه في نفوس أتباعه، تحت ستار من المكر والدَّهاء.
وكان من هذه الحركات كذلك:
الراوندية: التي نسبت إلى مدينة راوند، التي اتَّخذها أتباع الحركة مقرًّا لهم.
وقد بدأ أتباع الحركة أعمالَهم بالترويج للمُعتقدات الفارسية، وقد مكن الله – عزَّ وجلَّ – أبا جعفر المنصور أن يقضيَ عليهم.
ثم ظهرت “الخرَّمية”، وهي حركة أخذت اسمها من زوجة مزدك زعيم الإباحية القديم عند الفرس، واسمها “خُرَّما”.
وقد استطاع الخليفةُ المعتصم أن يقضيَ عليهم بعد قتل زعيمهم “بابك الخرمي”.
• وكذلك ظهرت حركة الزنج (256 هـ)، وحركة القرامطة (277 هـ)، وسار على نهج هذه الحركات (إخوان الصفا)، و(الإسماعيلية)، تلك الحركات التي أرادت أن تقضيَ على مفهوم الإسلام الصحيح بدعوى أنَّ القرآن له ظاهر وباطن، ومُحاولة نشر عقائد المجوس والزرادشتية بين المسلمين؛ سعيًا لبث الفرقة بين المسلمين، ومن ثم يتخلصون من الإسلام دون مُواجهة بالسلاح.
وبالرغم من خطورة هذه الحركات، إلا أن يقظة المجتمع الإسلامي حُكامًا ومحكومين لم تُمكِّنها من الوصول إلى هدفها الخبيث.
وكما كان الحكام يواجهون أتباعها بالسَّيف، فقد كان العلماء يواجهونهم فكريًّا، ويظهرون للمسلمين ضلالَهم وأهدافهم، ولعلَّ كتابَ الإمام الغزالي “فضائح الباطنية” كان حلقة من حلقات المواجهات الفكرية، التي أظهرت زيفَهم وخطورتهم على الإسلام والمسلمين.
ثانيًا: ترجمة كتب الفلسفة الإلهية عند اليونان:
من المعروف أنَّ السلفَ الصالح – رضوان الله عليهم – لما انفتحوا على حضارات ما قبل الإسلام، أخذوا منها النافع المفيد، وتركوا ما يتعلق بعقائدهم، ووثنياتهم، وفلسفاتهم الجدلية العقيمة، التي لا نفعَ يُرجى من ورائها.
لقد اجتهدوا في أخذ ما يتعلَّق بالعلوم المادية من طبٍّ، ورياضيات، وفلك، وكيمياء؛ وذلك سيرًا على منهجِ القرآن في الأمر بالنَّظر في الأشياء؛ ﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: 101].
ظل الأمر على ذلك حتى أواخر العصر الأموي، وأوائل العصر العباسي، ثم بدأت تتوارد على العقل المسلم الفلسفة الهندية، والفلسفة اليونانية، ولما كان الكثير من الطوائف المجوسية واليهودية والنصرانية قد دخلت في الإسلام، وكان الكثير يتظاهر بالإسلام، ويبطن دينه، فقد بدأ كل هؤلاء ينشرون بين المسلمين ما يشككهم في عقائدهم، وكانت فرقة المعتزلة قد ظهرت، وبدأت تنهج النهج العقلاني في الردِّ على هذه الفرق، ومن ثم رأوا – المعتزلة – أنه لا بد من دراسة الفلسفة اليونانية؛ حتى يتمكنوا من الرد عليها، ولما طَمَّ سيل الإلحاد والزندقة في العصر العباسي، ووجد الخلفاء العباسيون أَثَر المعتزلة في مُواجهة هذه الطوائف، وقوة تفنيدهم لحجج الزندقة، فقد قاموا بتشجيعهم، بل لقد وصل الأمرُ بالمأمون أنه كان يعدُّ نفسه من علماء المعتزلة.
وكان ينهج نهجهم في هذا الاتِّجاه العقلاني، الذي جعلوا العقل فيه أساس بَحثهم، بل وحكموه في كل شيء، حتى أوَّلوا النص؛ كي يتَّفق مع العقل، بل يُمكننا أن نقول: لقد وصلوا إلى درجة تقديس العقل، ولا يستطيعُ أحد أن ينكر فضلَ المعتزلة في دفاعهم عن الإسلام، وتفنيدهم للأسس التي ترتكز عليها الفرق الضَّالة التي كانت تستتر في زيِّ الإسلام، وتُحاول أن تقوض بنيانه بتلك الفلسفات الملحدة.
ولكن مما يؤسف له أنَّ المعتزلة لم يلبثوا أن وصلوا إلى درجة الغُلُو في نظرتهم للعقل، وكان ذلك إيذانًا بتلاشيهم من ميدان البقاء؛ لأنَّهم أصبحوا لا يُمثلون (الهوية الإسلامية) القائمة على السهولة واليُسر؛ حيث أخرجوا الإسلام من حالته الفطريَّة إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية2.
وكان هذا الوضع من تدبير أعداء الإسلام، وإن كنت تَعْجَب من هذه العبارة الأخيرة، فانظر إلى هذه الحادثة التي ذكرها العلاَّمة مُحب الدين الخطيب – رحمه الله – يقول: “إنَّ قصة المسلمين مع الفلسفة اليُونانية قصة مَليئة بالفواجع والنَّكبات، والغريب جدًّا أنه لا يزال الكثير من مُثقفينا يعتقد أن سبب نهضة المسلمين يعود إلى هذه الفلسفة، مع أنَّها كانت من أعظم أسباب نزاعهم وبُعدهم عن دينهم، وضياع مجدهم، وقد تَحقَّق فيهم خبرُ أحد الأحبار، وتفصيل ذلك – كما رواه العلاَّمة الشيخ محمد السفاريني -: “قال العلماء: إنَّ المأمون لما هادن بعضَ ملوك النصارى – أظنُّه صاحب جزيرة قبرص – طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيتٍ لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصَّه من ذوي الرأي، واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا واحد، فإنه قال: جهِّزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلاَّ أفسدتها، وأوقعت بين علمائها”.
ومن الجدير بالذِّكر أن أولئك النصارى قد طمروا هذه الفلسفة تحت الأرض تخلُّصًا من شرها؛ لما لمسوه من فسادها، وهدمها للدين والفضيلة.
أجل، قد تَحقق في المسلمين تنبؤ الحبر، فما كاد علماء المسلمين – بعد أن بلغ مجد الإسلام ذِرْوَته في القوة والفتح والعلم – يشتغلون بفلسفة اليونان، حتى راحوا يؤوِّلون نصوص الشريعة الإسلامية؛ حتى تتَّفق مع هذه الفلسفة، فمسخوا الإسلام، وأخذوا يزعمون أنَّ للإسلام ظاهرًا وباطنًا، وظاهره للعامة، وباطنه للعلماء والحكماء، وأخذوا يشتغلون بعلم الكلام يسمونه ظلمًا وعدوانًا بـ”علم التوحيد”، ولا يكاد يكون فيه من التوحيد إلا الاسم، أما محتواه، فهو الفلسفة نفسها”3.
ولقد كان لإعلاء المعتزلة شأن العقل، ورفعه إلى درجة التقديس؛ إيذانًا بخروجهم عن روح الهوية الإسلامية القائمة على السهولة واليُسر، والخالية من التعقيدات الفلسفية – أعظمُ الأثر في مواجهة العلماء لهم، واجتهاد أئمة الإسلام أمثال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم في الردِّ عليهم ومُواجهة تلك الفلسفات الدَّخيلة على هوية الأمة، والتي لم يألفها السَّلف الصالح – رضوان الله عليهم.
يقول الشيخ محمد الغزَّالي – رحمه الله -: “أين كانت الخلافة العبَّاسية في أثناء الهجوم على الفكر الإسلامي بهذه الطَّريقة الوضيعة؟ لم تكن تكترث بالنَّتائج، وعندما تحركت الخلافة تَحرَّكت؛ لتنصر انحراف المعتزلة في بعض القضايا الكلامية، وأمرت بسجنِ وجلد ابن حنبل، الذي يُعَدُّ زعيمَ المحافظين في ذلك الوقت… على أنَّ علماء الإسلام، ووراءهم السواد الأعظم من الأمة قاوَموا هذا الغشَّ المفروض على ثقافتهم الدينية مُقاومة ناضجة، وأمكن حصر الإسرائيليَّات، والنصرانيَّات، والإغريقيات، وكل القمامات الفكرية، التي أرادت الالتصاق بالرِّسالة الخاتمة، وتم تحذير الناس منها”4.
ثالثًا: الهجوم المسلح (صليبي ووثني تتري):
تعرض العالَمُ الإسلاميُّ لعدة قرون مُتوالية لهجمة صليبيَّة وثنية شرسة، تدفقت إلى عالمنا الإسلامي مُتعاونة مُتعاضدة من عدَّة اتجاهات:
من الشمال عن طريق بيزنطة، ومن الشرق بالغزو التَّتري المغولي، الذي تآمر مع الصَّليبيِّين لمدة (190 عامًا) من سنة 616 – 807 هـ، والتي كان أقواها حملة جنكيز خان، وهولاكو، وتيمورلنك، ومن الغرب عن طريق الأندلس بغزو الفرنجة والإسبان.
وقد كان الغرضُ الأساسيُّ لهذه الهجمة هو القضاء والمحو التَّام لمعالم الإسلام، ولقد تكشفت الأحداثُ والوقائع عن مدى ترصُّد ومراقبة القوى المعادية لأحوال العالم الإسلامي، حتَّى إذا تأكدوا من حدوث أمرين بدؤوا في هجومهم:
الأول: ضعف الجبهة الداخليَّة وتفككها.
والثاني: وجود تناقُض بين قيم الإسلام وأعمال المسلمين وأخلاقهم؛ إذ إنَّ التوافق بين قيم الإسلام وأخلاق المسلمين من أقوى الدِّلالات على القوة المنبعثة من قوة العقيدة والإيمان.
نعم، إذا تَمزَّقت الوحدة، ووقع الصراع بين أجزاء العالم الإسلامي، ثم ضعفت القوة الرادعة – كان ذلك مقدمة لتجمُّع الأعداء للانقضاض، ولكن اللافت للنَّظر في خط سير تاريخنا الإسلامي تلك الظاهرة العجيبة “ظاهرة الانبعاث الداخلي”، سواء في مجال المواجهة المسلحة للغزو الخارجي، أم في مَجال الفكر لمواجهة الانحرافات الطارئة على الدين.
لم يقف عالم الإسلام صامتًا، ولم يستسلم، بل واجه العَدَاء بالمقاومة والوحدة والقتال، واستطاعَ أن يديلَ القوى الصَّليبية الشَّرسة، وأنْ يصهر القوى التَّترية المغولية في بوتقته، حتى أصبحت هذه القوى التي جاءت تريد القضاء على الإسلام من أقوى وأضخم القوى التي حملت راية الإسلام فيما بعد؛ حيث تحولوا إلى مسلمين مُخلصين.
ولقد أصبح هذا الحدث الضَّخم (هجوم التتار على بغداد أولاً، ثم إسلامهم وحملهم راية الإسلام ثانيًا) من أقوى الأمثلة على قُدرة الهوية الإسلامية على إخضاع الهويات الأخرى وصهرها لها، حتى وإن كان المسلمون في حالة ضعف وانهزام.
ثم كان لظهور المماليك والعثمانيِّين، وحملهم راية الإسلام – أعظمُ الأثر في كسر الغرور الصليبي، وبالأخص بعد فتح القسطنطينيَّة على يد القائد الشاب محمد الفاتح، ولكن أنَّى للحقد الصليبي أن ينام أو يقر له قرار؟!
لقد تتابعت الحملات تتدفَّق تريد القضاء على الإسلام، إلاَّ أن الأعداء كانوا يدركون أنَّهم لن يبقوا في هذه البلاد أبدَ الدَّهر، مهما تغلَّبوا على أهلها المسلمين في فترات معينة، طالت هذه الفترات أم قصرت.
لذا؛ فقد عملوا على تسليم مقاليد الحكم في هذه البلاد الإسلامية لشخصيات مُوالية لهم من أبناء هذه البلاد، تعمل هذه الشخصيات – بتوجيه الاستعمار – على إخراج أجيال مفرَّغة من ثقافتها الإسلامية، ومن انتمائها إلى دينها وعقيدتها، ثم ما تلبث أن تتولى هذه النوعيات المفرَّغة مقاليد التوجيه الثَّقافي والصَّدارة الإعلامية، ومن ثم يتمكَّن الاستعمار من السيطرة على البلاد الإسلامية، وطمس معالم هويتها، فهم وإن كانوا قد رحلوا بأجسامهم وسلاحهم، فقد بقُوا بعقولهم وعملائهم.
ولقد كانت هذه الخطة الخبيثة أقوى أثرًا على الهوية الإسلامية من الهجمات الشرسة المدججة بالسلاح، إنَّها خطة “الغزو الفكري”، تلك المؤامرة الحديثة، التي وضعها الأعداء للقضاء على الهوية الإسلامية.
رابعًا: الغزو الفكري والتَّغريب ومُحاولات القضاء على الهوية الإسلامية:
كان فشل الصليبيِّين في الحملات التي شنُّوها على عالمنا الإسلامي سببًا في التفكير لتغيير أسلوب الغزو ووسائله؛ حيث أدرك الصليبيُّون أنَّ عقيدة المسلم ودينه يَحملانه على بذل النَّفس والنفيس في سبيل المحافظة على مُقدساته، وأرضه، وعرضه من الغازي المحتل.
وقد كانت بدايات التفكير في تغيير أسلوب الغزو حينما أُسر قائد الحملة الصليبية “لويس التاسع”، وسجنه المصريون في المنصورة، واستطاعَ أن يفدي نفسه بمال كثير.
وحينما كان لويس هذا قابعًا بين جدران سِجْنه، أدرك أنَّ الغزوَ المسلح لن يستطيع الانتصار على المسلمين؛ لذلك فكَّر في طريقة أخرى خلاصتها: إبعاد المسلم عن دينه، وتفريغه من عقيدته، بذلك يُمكن تحويل أحفاد الأسود إلى ظِبَاءٍ جَفُولَةٍ، لا تعتز بدينها ولا تحرص على حفظ عرضها ووطنها من الأعداء، بل إنَّهم يرون التمديُن والترقي في التشبه بغير المسلمين.
وحينما يُمكَّن لهذه الشخصيَّات من قيادة البلاد الإسلامية، فإنَّهم سوف ينوبون عن أعدائهم في القضاء على الهُوية الإسلامية، والقضاء على حملة الإسلام، تحت مُسمَّيات خادعة مثل: “القضاء على الإرهاب، والتخلص من الرجعية، ومحاربة الجمود… إلخ”.
حرص الأعداء على إرسال بعضِ الأفراد (مستشرقين) يدرسون الثَّقافة الإسلامية دراسة وافية، ثم يقومون بإثارة الشُّبهات ضدها، ولكنَّهم وجدوا أنَّ الأُمَّة لا تثق فيما يصدر عنهم ولا تتأثَّر به، إذًا كان لا بد أمامهم من استقطاب بعض الأفراد من أبناء الأمة، فهؤلاء لو تَمَّ استقطابهم، فسيكونون بمثابة الثقوب، التي يدخل منها الأعداء إلى ثقافة الأمة، كما تدخل الحشرات إلى جسم الشجرة الوارفة، وتظل تسعى حتى تصل إلى النَّواة، فتفسد الشجرة كلها.
بدايات حصول الغرب على هذه الشخصيات التي أعدُّوها لتنفيذ الخطة:
لما بدأ الضعف يَدِبُّ في جسم الدولة العثمانية، التي ظلَّت تحمل راية الإسلام في وجه الأعداء عدة قرون، وبسبب البُعد عن تعاليم الإسلام، وعدم الأخذ بالأسباب في جوانب الحياة، والثِّقة الزائدة بالنفس، وعدم الاكتراث بالأعداء، وفي المقابل كان العدو المحيط بالدولة يتربَّص بها الدَّوائر بكلِّ جهده في إعداد نفسه؛ ليثأر لكرامته بعد تجرع كأسِ الذُّل بفتح القسطنطينية، وتحويل أكبر كنيسة بها إلى مسجد.
فلما أحس بعضُ سلاطين آل عثمان بالخطر، وفي مُقدمتهم محمود الثاني، الذي تُوفي في عام 1839م، حاول أن ينهضَ بالدولة، وكان يوقن إيقانًا تامًّا – كما يقول باول شمتز – “أنَّ أوربا لا يُمكن أن تُضرَب وتُرَدُّ إلى ديارها إلاَّ بسلاح أوروبي، وبغير هذا لا يستطيع الشرق أن يقفَ أمامها ويوقف زحفَها.
وبهذا بذل جهده، وحاول بكلِّ الوسائل أن يُحقق لبلده المستوى الحضاري الأوروبي؛ كي يستطيع مقابلة هذا الخطر الداهم، ويكون لديه إمكانية ردعه، والوقوف أمامه، وكان ينقص هذا دراسة أحوال وظروف الشَّعب الذي أُريدَ رفعُ مستواه.
فممَّا لا جدالَ فيه حتمية وجود أرض خصبة لبذر هذه الحضارة، وإلاَّ يبست قبل أن تنبت، ويَعتريها الذبول إن نبتت بين شعبٍ لا يَملك مقومات رعاية الحضارة، وليست لديه رغبة تقبلها؛ أي: لا بد من وجود عوامل تتناسَب مع إرادة التطوُّر، وتساعد على دفعها ورعايتها، فحياة شعوب الشرق اتَّسمت بالجمود، لا تعرف له بديلاً، ولم يكن من السهل إثناء الشَّعب عما اعتاده، أو تغيير هذه العادات، فمحمود الثاني حاول وضع الحضارة الأوروبية على أرز شرقي يبس وتحجَّر، وصار غير مستساغ”5.
ولقد قام الحكام بعملين يتطلَّعون من ورائهما إلى النهوض بالأمة:
الأول: إرسال بعثات إلى الغرب:
لقد حاول الحكام إرسال بعض الشخصيات؛ كي تتزود بخبرة الغرب، وتأتي وهي مزودة بالعلم والحضارة، ولكن هذه الشخصيَّات ذهبت وهي مفرغة من عقيدتها، فكان من السَّهل أن تتلقفهم المحافل الماسونية، ومن ثم فقد وقعوا فريسةً في أيدي أعداء الإسلام، وقاموا بإعدادهم؛ كي يقطع الشجرة أحد فروعها، ومن ثم فقد عادت هذه الشخصيات وهي مُتنكرة لا تحمل لأمتها انتماء.
والثاني: استقدام خبراء من الغرب:
وأمَّا بالنسبة للخبراء الذين قدموا من الغرب؛ كي يطوروا الدولة العثمانية جاؤوا بامتيازاتٍ تثبِّت أقدامهم؛ بحيث لم تستطع الدولة أن تتخلص منهم؛ يقول باول شمتز: “إنَّ العقل الأوروبي الذي استعانت به تركيا ليساعدها على تنفيذ البرامج الإصلاحية؛ كي تستطيع الدِّفاع عن نفسها، وتتمكَّن من الوقوف ضِدَّ الهجوم عليها – لا يستطيع أحد التخلص منه أبدًا، لقد أُعْطِيَ من الامتيازات، ونال من الفرص ما يُمكِّنه من تثبيت أقدامه فوق هذه الأرض”6.
وقد حدث في كثير من البُلدان الإسلامية مثل ما حدث في تركيا، إلاَّ أن مصر لمكانتها الثَّقافية لاقت من عناية الأعداء وحرصِهم على السيطرة عليها – وبالأخص السيطرة الثقافية – ما لم تلقَه دولة أخرى، وترتب على ذلك فقدان مصر سيادتها، وسقطت أمام البريطانيِّين عام 1882م، ومنذ أن سيطر الخبراء الغربيُّون وتلاميذهم من التغريبيِّين على مقاليدِ البلاد الإسلامية، وبالأخصِّ في الناحية الثقافية، فقد حرصوا على إخراج أجيال لا تعرف دينَها، ولا تعتزُّ بالانتماء إلى عقيدتِها ولغتها ووطنها، ولا تعتز بتاريخها وتراثها، هذا ولما كان للهُوية الإسلامية خمسة أركان، وهي: الدين، اللغة، الأخلاق، التاريخ، التراث، فقد اجتهد الأعداء في السَّعي لطمس هذه الأركان؛ كي يطمسوا هوية الأمة ومشخصاتِها بين الأمم، وسوف نتناول وسائلهم في سعيهم الدائب لتحقيق هذا الهدف الخبيث.
- ينظر: “تاريخ المذاهب الإسلامية”، الشيخ محمد أبو زهرة، ص 35 ، 36 طبعة دار الفكر العربي. ↩︎
- ينظر: “أخطاء المنهج الغربي الوافد”، أ/ أنور الجندي، ص 129 ، 130، طبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت. ↩︎
- “العواصم من القوا صم”، تحقيق: الشيخ محب الدين الخطيب، ص 265 ، 266. ↩︎
- “الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر”، محمد الغزالي، ص33، ط3، مطبعة وهبة 1990. ↩︎
- “الإسلام قوة الغد العالمية”، باول شمتز، نقله إلى العربية د محمد شامة، ص 76، طبعة مكتبة وهبة. ↩︎
- المرجع السابق، ص79. ↩︎