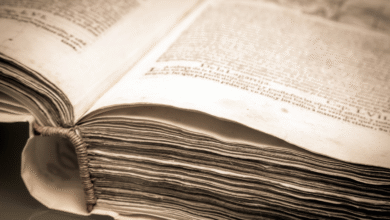القواعد الثمان الكافية في الرد على زنادقة مركز تكوين الملاحدة
هذه ثماني قواعد مهمة تبيِّن منهج العلماء في التعامل مع السُّنَّة النبوية، وتبين بُعْدَ زنادقة مركز تكوين عن المنهج العلمي للعلماء في دراسة السنة المطهرة والسيرة النبوية، وفيها كفاية في الرد على منهجهم التشكيكيِّ لِما ثبت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وقد تبين أنهم من الذين قال الله عنهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 11، 12]، ويحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
وهذه هي القواعد:
القاعدة الأولى: تكذيب الخبر مع احتمال صدقه ضلالٌ مبين:
قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: 52]، والحديث الصحيح وحيٌ من الله؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، وروى أحمد في مسنده (22215)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2178)، عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما أَقُولُ ما أُقَوَّلُ))؛ أي: أقول لكم ما أوحاه الله إليَّ، وروى أحمد في مسنده (17174)، وأبو داود في سننه (4604) بسند صحيح، عن المقدام بن معديكرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألَا إني أُوتيت القرآنَ ومثله معه، ألَا يُوشِكُ رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه)).
قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود (7/ 348): “وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادِم للنص، لكفى ذلك في رد القياس، ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس، وبالله التوفيق”.
وما أكثر ما يرُدُّ زنادقة مركز تكوين كثيرًا من الأحاديث الصحاح لأدنى شبهة، ولو أنصفوا لوجدوا أن احتمال صدقها قوي جدًّا، والشبهة في ردها ضعيفة جدًّا.
فطريقة العلماء ليست التكذيب والإنكار بما لم يُحِطِ الإنسان بعلمه؛ ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: 39]، ولا الجزم في مقام الاحتمال المعتَبَر؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: 36]؛ أي: لا تَقُلْ ما لا تعلم؛ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (5/ 75): “نهى الله تعالى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهُّم والخيال؛ كما قال تعالى: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات: 12]، وفي الحديث: ((إياكم والظنَّ؛ فإن الظنَّ أكْذَبُ الحديث))”.
وقد قرن الله من يكذِّب بالصدق بمن كَذَبَ على الله، وحكم عليهما جميعًا بأنهما ظالمان؛ فقال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ * وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر: 32، 33].
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، وخبر المتخصصين في علم ما، لا يَصِحُّ أن يردَّه الجاهلون بذلك العلمِ بالظَّنِّ.
فمثلًا: قواعد أهل الطب لا يُقبَل ردُّها من الجاهلين بالطب، وقواعد النحاة لا يردها الجاهل بالنحو، وهكذا ما صحَّحه المحدِّثون من الأحاديث لا يُقبَل ردها بالظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئًا، ونقول لمن أراد أن يُشكِّك في حديث في الصحيحين أو في غيرهما مما صححه أهل الحديث: لن يُقبَل ذلك منك إلا إذا أتيتَ بحُجَّة بيِّنة، بحسب القواعد التي وضعها أهل الحديث رحمهم الله، فإنهم لا يُضعِّفون الحديثَ إلا لطعن في أحد الرواة، أو لسقط في الإسناد، فأثْبِتْ لنا أن أحد رواة الحديث غير ثقة، أو أنه أخطأ في روايته، أو أثْبِتْ لنا أن هناك سقطًا في الإسناد وانقطاعًا، وإلا فاسكت خيرًا لك.
فطريقة أهل الحديث أنهم يجمعون طرق الحديث، فيتبين لهم الصواب من الخطأ، وبجمعهم للروايات يتبين لهم حال الرواة في الحفظ والإتقان، فمن وافق من الرواة أصحابَه الذين يشاركونه في الرواية عن شيخهم، تبيَّن لهم ضبطه وإتقانه، فإن خالفهم بالزيادة والنقصان والخطأ، تبيَّن لهم ضعف حفظه، فإن أضاف إلى ذلك تفرُّده بروايات عن شيخهم الواحد، ولم يذكرها غيره من طلاب ذلك الشيخ، تبيَّن لأهل الحديث كذِبُ ذلك الراوي، أو اتهموه بالكذب بحسب إكثاره من التفرد، وبحسب مروياته، ومخالفته لأقرانه الذين يَرْوُون عن شيخ واحد.
قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه (1/ 7): “وعلامة المنكر في حديث المحدِّث، إذا ما عُرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايتُه روايتَهم، أو لم تَكَدْ توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجورَ الحديث، غيرَ مقبولِهِ”.
والمحدِّثون لا يقبلون الحديث إذا كان مخالفًا لكتاب الله تعالى، ولا يُجوِّزون العمل به، فلهم نظر في متون الحديث، كما لهم نظر في أسانيدها، وقد فصل ذلك الشيخ الدكتور محمد لقمان الهندي في كتابه القيم: “اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا، ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم”، ومِنَ الناس مَن يظنُّ بعض الأحاديث الصحيحة مخالِفةً للقرآن الكريم، وهي لا تخالفه في الحقيقة، بل قد يوجد في القرآن ما يدل عليها بالنص أو الإشارة، فانظر مثلًا بحثي: “12 دليلًا من القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيمه”، وهو – بحمد الله – منشور في شبكة الألوكة وغيره.
القاعدة الثالثة: إذا تعارض نصَّان ثابتان يُجمَع بينهما ولا يُكذَّب أحدهما:
إذا تعارض نصان ثابتان سواء كانا آيتين، أو آية وحديثًا، أو حديثين، فإن العلماء يقولون: يُجمع بينهما، فإن لم يمكن يُنظَر الناسخ من المنسوخ، فإن لم يُعرَف المتقدم من المتأخر يُرجَّح بينهما، فإن لم يمكن الترجيح، فأهل العلم يقولون: نتوقف، وفوق كل ذي علم عليم.
فهذه طريقة أهل العلم قديمًا وحديثًا، أما طريقة أهل الأهواء، فالتكذيب والردُّ لِما يظنونه لا يدخل عقولهم.
وطريقتهم هذه مُبتدَعة ومتناقضة، وقد تُوصلهم إلى الكفر إن أعملوها في نصوص القرآن الكريم، وهم إن لم يُعْمِلوها في القرآن، وأعملوها في السنة، تناقضوا؛ فإن القرآن والسنة الصحيحة كلاهما وحيٌ، وكلاهما حق، وإن صدَّقوا ببعض الآيات القرآنية وإن لم تدخل عقولهم، فلماذا لا يقبلون بعض ما في السنة مما لم يدخل عقولهم؟
وهذا التناقض الواضح يكفي في بيان بطلان منهجهم؛ فإن في القرآن العظيم أشياءَ تُحيِّر العقل، ويجب الإيمان بها، وإن لم تدخل عقولنا، وسأذكر ثلاثة أمثلة من سورة واحدة وهي سورة الكهف:
- قصة أصحاب الكهف العجيبة؛ وفيها قال تعالى: ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ [الكهف: 25]، وهذا شيء عجيب جدًّا، قد لا يدخل عقول الكفرة، ولكننا نؤمن به ولا نشك فيه لقول الله، ولو جاءت هذه القصة في حديث صحيح، لَما شَكَكْنا فيه أيضًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يُوحَى.
- قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام فيها عجائب كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ [الكهف: 61]؛ أي: أحياه الله بعد موته، واتخذ طريقًا في البحر؛ حيث حَبَسَ الله جرية الماء فصار هناك نفقًا في مكان دخول الحوت البحر، وهذا شيء عجيب جدًّا كما قال فتى موسى: ﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف: 63]، فهل يدخل هذا العقل؟ نعم، يدخل عقول المؤمنين، ومن كذَّب بهذا كفر، ولو كان هذا في حديث صحيح لآمَنَّا به، ولم نَقُل: هذا من الإسرائيليات، كما هو منهج المشككين في السنة النبوية.
- قصة ذي القرنين وبنائه الرَّدمَ؛ قال تعالى حاكيًا عنه: ﴿ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ [الكهف: 96، 97]، وهذا أمر عجيب جدًّا يُحيِّر العقول، ولكن ليس محالًا، فالله آتى ذا القرنين من كل شيء سببًا، ونحن نؤمن بهذه القصة التي أخبرنا الله عنها، ولا نشُكُّ فيها، ومن شكَّ فيها وقال: هذا من أساطير الأولين، فقد كَفَرَ، ولو كانت هذه القصة في صحيح البخاري ومسلم، لَسَمِعْنا زنادقة مركز تكوين يسارعون بقولهم: هذا من خرافات الأولين، هذا لا يدخل العقل، ولا يمكن أن نصدِّقه أبدًا.
القاعدة الرابعة: باجتماع النقل الصحيح والعقل الصريح تُدرَك الحقائق الشرعية:
شريعةُ الإسلام توافق العقل الصريح، وتهتم به، وترفع منزلته ومكانته، وتصرف طاقته فيما يفيد، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى التفكر واستعمال العقل؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: 3]، وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: 4]، وباجتماع النقل الصحيح والعقل الصريح تُدرَك الحقائق الشرعية، فلا النقل وحده يفيد فاقد العقل، ولا العقل وحده يفيد فاقد النقل، فلا بد من اجتماعهما، وبنقص واحد منهما تنقص المعرفة بالحق.
وليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح من القرآن والسنة ما يُوجِب مخالفة الشرع أصلًا؛ قال ابن تيمية كما في مجموعة الرسائل والمسائل (3/64-65): “كل ما يدل عليه الكتاب والسنة، فإنه موافق لصريح المعقول، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيرًا من الناس يغلطون إما في هذا، وإما في هذا، فمن عرَف قولَ الرسول ومراده به، كان عارفًا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول، ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إليَّ من حفظه؛ أي: معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه، والفقه فيه معرفة مراد الرسول، وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية، أحب إليَّ من أن تُحفَظ من غير معرفة وفقه، وهكذا قال علي بن المديني وغيره من العلماء، فإنه من احتجَّ بلفظ ليس بثابت عن الرسول، أو بلفظ ثابت عن الرسول، وحَمَلَه على ما لم يدل عليه، فإنما أُتِيَ من نفسه، وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحًا، لم تكن إلا حقًّا لا تُناقِض شيئًا مما قاله الرسول، والقرآن قد دلَّ على الأدلة العقلية التي بها لم تكن إلا حقًّا، وتوحيده وصفاته، وصدق رسله، وبها يُعرَف إمكان المعاد، ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تُعلَم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس”؛ [انتهى مختصرًا].
القاعدة الخامسة: إنْ تعارَضَ النقل والعقل في الظاهر قُدِّم النقل على العقل:
إنْ تعارَضَ النقل والعقل في الظاهر، قُدِّم النقل على العقل؛ لأن النقل عِلْمُ الخالق الكامل، والعقل علم المخلوق القاصر، وهذا التعارض يكون بحسب الظاهر لا في حقيقة الأمر؛ فإنه لا يمكن أبدًا حصول تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، وإذا وُجِد تعارض، فإما أن يكون النقل غير صحيح، أو العقل غير صريح؛ قال ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية (ص35): “ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كلُّه حقٌّ يُصدِّق بعضه بعضًا، وهو موافق لفطرة الخلائق، وما جُعِلَ فيهم من العقول الصريحة، والقصود الصحيحة، لا يخالف العقل الصريح، ولا القصد الصحيح، ولا الفطرة المستقيمة، ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يظن تعارضها: مَن صدَّق بباطل من النقول، أو فهِم منه ما لم يدل عليه، أو اعتقد شيئًا ظنَّه من العقليات وهو من الجهليات، أو من الكشوفات وهو من الكسوفات، إن كان ذلك معارضًا لمنقول صحيح، وإلا عارض بالعقل الصريح، أو الكشف الصحيح، ما يظنُّه منقولًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون كذبًا عليه، أو ما يظنه لفظًا دالًّا على شيء، ولا يكون دالًّا عليه”.
والعقل كالبصر، والنقل كالنور؛ لا ينتفِع الْمُبْصِرُ بعينه في ظلام دامس، ولا ينتفع العاقل بعقله بلا وحي، وبقدر النور تهتدي العين، وبقدر الوحي يهتدي العقل، وبكمال العقل والنقل تكتمل الهداية والبصيرة، كما تكتمل الرؤية حين الظهيرة، فالمؤمنون أبْصَرُ الناس بالحقائق الشرعية؛ لجمعِهم بين النقل الصحيح والعقل الصريح؛ قال تعالى: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 122]، وقال سبحانه: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [محمد: 14].
القاعدة السادسة: يجب اتباع الوحي وعدم الاستغناء عنه بالعقل وحده:
يجب اتباع الوحي وعدم الاستغناء عنه بالعقل وحده، ومن قال: إنه يهتدي إلى الله بعقله المجرد بلا وحي، فهو كمن قال: إنه يهتدي إلى طريقه بعينه المجردة بلا ضياء، وكلٌّ منهما جاحد لقطعيٍّ ضروري، والأول بلا دين، والثاني بلا دنيا، والأول بلا بصيرة، والثاني بلا بصر؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46].
والوحي هو الذي يهدي الأنبياء، ويهدي أتباعهم؛ ويدل على هذا قول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سبأ: 50]، وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: 54]، فلا هدايةَ إلا لمن اتَّبع الوحي، ومن لم يَتَّبِعْهُ فقد ضلَّ ضلالًا مبينا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].
وقد ضلَّ مَن يقول: لا أُصدِّق بأيِّ حديث إلا إذا أدركه عقلي، وما لا يدركه لا أؤمن به، فإن هذا قدَّم العقل القاصر الناقص الذي يجهل أكثر مما يعلم على الحديث الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالمؤمن العاقل يُقدِّم الحديث الصحيح على كل عقل، فما لا يُدركه العقل لا يعني عدم وجوده، ولكنه هو غير مدرِك له، فللعقل حدٌّ ينتهي إليه، كما أن للبصر حدًّا ينتهي إليه، لا ينتهي الكون والوجود بنهايته، وللسمع حدًّا لا تنتهي الأصوات بنهايته؛ فللنملة صوت لا يُسمَع، وفي الكون فضاء وكواكب ونجوم لا تُرى.
ومعلوم أن النصوص الشرعية منها ما يفهمه غالب الناس، ومنها مما لا يفهمه إلا العلماء، ومنها ما لا يفهمه ويعرف دلالته إلا الراسخون من أهل العلم، فيكون موقفنا هو العمل بالْمُحْكَم والوقوف عند المتشابه، والمتشابه: هو ما لا يعلمه إلا الراسخون من أهل العلم، وأما جَعْلُ هذا المتشابه أصلًا، أو التشكيك في المحكمات بضربها بالمتشابهات، فهذا سبيل أهل الغي؛ يقول الله سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7].
والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بحال، ومتى توهَّم مُتوهِّمٌ أن نصًّا من النصوص الشرعية الثابتة خالَفَ العقل، فلْيَتَّهِمْ عقله هو، والشريعة الإسلامية – بحمد الله – تأتي بما تَحَارُ فيه العقول، ولا تأتي أبدًا بما تحيله العقول، كما قرر ذلك المحققون من العلماء، بمعنى أن الشريعة لا تأتي بما تَعُدُّه العقول السليمة أمرًا مستحيلًا.
ويجب التسليم أن للنقل الصحيح أخبارًا وأحكامًا، سواء عرفنا العلة أو لم نعرفها، ويجب على المسلم أن يُقدِّم قول الله ورسوله على كل قول، وعلى كل قياس، وعلى كل ذوق، وعلى كل استحسان؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1]؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: 1]: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، وقال الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، وقال سفيان الثوري: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: 1] بقولٍ ولا فعل، وقال الزهري رحمه الله: مِنَ الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم.
القاعدة السابعة: خطورة الظن السيئ بالعلماء الراسخين:
قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات: 12]؛ قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية: “ما نجمت العقائد الضالَّة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة”، ثم قال ابن عاشور ناصحًا من يظنون الظنون السيئة: “ليقدِّر الظَّانُّ أن ظنَّه كاذب، ثم لينظر بعدُ في عمله الذي بناه عليه، فيجده قد عامَلَ به من لا يستحق تلك المعاملة من اتهامه بالباطل؛ فيأثم مما طوى عليه قلبه لأخيه المسلم، وقد قال العلماء: إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز… وإن كان اعتقادًا في أحوال الناس، فقد خسِر الانتفاع بمن ظنه ضارًّا، أو الاهتداء بمن ظنه ضالًّا، أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلًا، ونحو ذلك”؛ [التحرير والتنوير (26/ 251، 252)].
فالواجب على المسلم أن يعرف قدر العلماء، فقد رفع الله منزلتهم في القرآن، وعلى المسلم أن يسأل المتخصصين في كل علم عما يُشكِل عليه منه؛ كما قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].
وإن من الضلال المبين أن يحتقرَ غيرُ المتخصص في علمٍ ما أهلَ العلم المتخصصين فيه، الذين أفْنَوا أعمارهم فيه، ويظن هذا المتعالم نفسَه أعلمَ من أولئك العلماء أجمعين، كالذين يطعنون في كتب السنة النبوية، ويتطاولون على أئمة الحديث كالبخاري وغيره من علماء الأمة، فنحذرهم أن يكونوا ممن ذمهم الله بقوله: ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ [النجم: 23]، وننصحهم بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظنَّ، فإن الظن أكذب الحديث))؛ [رواه البخاري (6064) ومسلم (2563)].
ونقول لهم: هَبْ أن البخاري الذي تطعنون فيه فاسق، ألم يأمركم الله بالتبيُّن من خبر الفاسق في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]؟
فالله لم يأمرنا بردِّ خبرِ الفاسق قبل التبين، بل أمرنا بالتأكد والتحري من صحة خبره، فإن ظهر لنا بعد التثبُّت والبحث أن خبرَه كاذب، فَلْنَرُدَّه على علمٍ، أما المسارعة بالتكذيب، فهذا من صفات الكافرين والمنافقين؛ قال الله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ﴾ [يونس: 39]، وقال سبحانه عن المنافقين: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: 10]، بضم الياء، وفتح الكاف، وتشديد الذال المكسورة، كما في قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وأبي جعفر، ويعقوب، وقال عز وجل: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ﴾ [الزمر: 32]، فاحذر – يا مسلمُ – أن تكون من أظلم الناس بتكذيب حديث صحيح.
فننصح كل من يطعن في صحيح البخاري بالتبيُّن كما أمر الله، ونقول ناصحين له: إنك لو بحثت في أحاديث صحيح البخاري، لَوجدتَ أنه قد رواها غير البخاري، ممن كانوا قبله، أو معاصرين له، أو جاؤوا بعده، فلا معنى لتكذيبك خبرَهُ، فتبيَّنْ بارك الله فيك؛ حتى لا تصيب قومًا من العلماء بجهالتك، فتندمَ يوم القيامة.
وندعو كل الطاعنين في كتب السنة النبوية، المحتقرين لعلماء الأمة، إلى التوبة من مخالفة كتاب الله فيما أمر من التبين، وفيما نهى عن ظن السوء، ومن ذلك الظن السيئ بعلماء الأمة الراسخين الذين نقلوا لنا العلم النافع، من القرآن الكريم وقراءاته وتفسيره، والسنة النبوية وشرحها، والفقه والسيرة النبوية والتاريخ، واللغة والنحو والأصول، وغير ذلك من العلوم النافعة التي حفظها الله لنا بجهود العلماء الراسخين.
القاعدة الثامنة: تشابُهُ طريقة الطاعنين في القرآن الكريم، وطريقة الطاعنين في السنة النبوية:
مِنْ مَكْرِ المستشرقين وخُبْثِهم عندما ينفِّرون الناس من القرآن الكريم أنهم يُظهِرون أنه كتاب مليء بالخرافات، وبما يخالف العقل، فيذكرون لهم آيةَ يأجوج ومأجوج، والردم الذي بناه ذو القرنين، ويذكرون آية إتيان عرش بلقيس في طرفة عين إلى النبي سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويذكرون آية الدابة التي ستخرج من اﻷرض وتُكلِّم الناس آخر الزمان، ويقولون: أين يأجوج ومأجوج؟ وكيف يمكن مجيء عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في طرفة عين؟ وكيف تكلم الناس دابة؟ وبأي لغة تخاطبهم؟
وبهذا المكر والخداع يَفْتِنون الذين لا يعرفون القرآن، ويُوهِمونهم أن آيات القرآن كله مثل هذه اﻵيات التي لم يفهموها، ولو أن من لا يعرف القرآن قرأ القرآن الكريم الذي هو أكثر من (6000) آية، لتَبَيَّن له مكرُهم وخبثهم؛ حيث تركوا كل آيات القرآن الواضحة، واختاروا تلك اﻵيات التي لا يفهمها بعض الناس؛ لينفِّروا الناس عن القرآن كله.
ولو سأل الجاهل بالقرآن أهلَ العلم من المفسرين، لَوَجَدَ الجواب عن كل آية أشكلت عليه.
وهكذا نجد الطاعنين في السنة يحذُون حَذْوَ الطاعنين في القرآن، ويقتدون بهم في طريقتهم الماكرة الخبيثة؛ لينفِّروا الناس من السنة النبوية، فيُظهرون أن صحيح البخاري – مثلًا – مليء بالخرافات، وبما يخالف العقل والشرع، فيبحثون فيه عن بعض اﻷحاديث التي لا يفهمها العوام، ويُهوِّلون الكلام حولها؛ مثل تهويل المستشرقين حول تلك اﻵيات القليلة؛ ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [البقرة: 118]، فيَفْتِنون بذلك من يسمعهم من العوام وغير المتخصصين في علم القرآن والسنة، والله المستعان.
ولو أن من لا يعرف صحيح البخاري قرأ صحيح البخاري – وعدد أحاديثه (2500) حديث تقريبًا من غير تكرار – لتبيَّن له مكرهم وخبثهم؛ حيث تركوا كل أحاديث صحيح البخاري، واختاروا تلك اﻷحاديث القليلة التي يُدَنْدِنون حولها؛ لينفِّروا الناس عن السنة النبوية كلها.
ولو سأل غير المتخصص في الحديث علماءَ الحديث المتخصصين، لَوَجَدَ الجواب الشافيَ عن كل حديث منها، بل قد ألَّف العلماء التآليف الكثيرة في بيان تلك اﻷحاديث التي فيها إشكال؛ مثل: كتاب “تأويل مختلف الحديث” لابن قتيبة، وكتاب “شرح مشكل اﻵثار” للطحاوي، وكتاب “كشف المشكل من حديث الصحيحين” لابن الجوزي.
وأختم كلامي بوصية قرآنية، ووصية نبوية، فيهما الكفاية:
الوصية الأولى: قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 153]، فالصراط المستقيم هو الإسلام، الطريق الواضح الذي سار عليه النبيون والصِّدِّيقون، والشهداء والصالحون، ونسأل الله في كل ركعة أن يهدينا إلى ما هداهم إليه، والسُّبُل هي الشُّبُهات والشهوات، وما من سبيل إلا وعليه شيطان إنسيٌّ أو جنيٌّ، يدعو إليه كشياطين مركز تكوين الذين هم في صور إنسٍ، وقلوبهم قلوب الشياطين، ومن أخطر السُّبُل التي تبعدنا عن طريق الإسلام دعاةُ الإلحاد والتشكيك في الإسلام، كالقائمين على مركز تكوين، وقد تبين لعامة المسلمين أن قصدهم تكوين الإلحاد.
الوصية الثانية: روى أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وصححه، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه من يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثاتِ الأمور، فإن كلَّ مُحْدَثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة)).