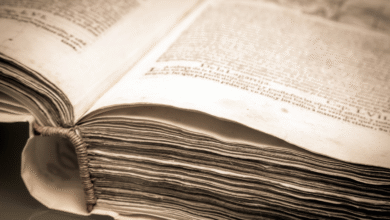الرد على من يطعن في عمر بن الخطاب
الحمد لله الذي له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ أما بعد فإن بعض الناس قد طعنوا في شخصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فأصبح من الواجب الردُّ على هذه الطعون، فأقول وبالله تعالى التوفيق والسداد:
فضائل عمر بن الخطاب:
- روى البخاري عن أبي هريرة قال: “بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال: ((بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرتُ غيرتَه، فولَّيت مدبرًا))، فبكى عمر، وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟!”؛ (البخاري، حديث: 3680).
- روى البخاري، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينا أنا نائم شربت – يعني: اللبن – حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري، أو في أظفاري، ثم ناولت عمر))، فقالوا: فما أوَّلته؟ قال: ((العلم))؛ (البخاري، حديث: 3681).
- روى البخاري، عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إيهًا – عجبًا – يا بن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطانُ سالكًا فجًّا قط إلا سلك فجًّا غير فجِّك – طريقك -))؛ (البخاري، حديث: 3683).
- روى البخاري عن أنس بن مالك، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أُحُد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برِجله قال: ((اثبُت أُحُد، فما عليك إلا نبيٌّ أو صدِّيق أو شهيدان))؛ (البخاري، حديث: 3686).
- روى البخاري عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدَّثون، فإن يك في أمتي أحَدٌ، فإنه عمر))؛ (البخاري، حديث: 3689).
- روى البخاري عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينا أنا نائم، رأيت الناس عُرضوا عليَّ وعليهم قُمُصٌ؛ فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعُرض عليَّ عمرُ وعليه قميص اجتره))، قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: ((الدين))؛ (البخاري، حديث: 3691).
- روى البخاري عن عمر بن الخطاب قال: “وافقتُ اللهَ في ثلاث؛ قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلًى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البَرُّ والفاجر، فلو أمرتَ أمهاتِ المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب، قال: وبلغني معاتبةُ النبي صلى الله عليه وسلم بعضَ نسائه، فدخلتُ عليهن، قلت: إن انتهيتن، أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرًا منكن؛ حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أمَا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ﴾ [التحريم: 5]”؛ (البخاري، حديث: 402).
الطعون ضد عمر بن الخطاب والرد عليها:
سوف نذكر بعض الشبهات والطعون التي ذكرها بعضُ الناس في شخصية عمر بن الخطاب، ونذكر ردَّ العلماء عليها.
الشبهة الأولى:
قال الطاعنون: “سمَّوا عمر الفاروق، ولم يسموا عليًّا عليه السلام بذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((هذا فاروق أمتي؛ يفرق بين أهل الحق والباطل))، وقال عبدالله بن عمر: ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم عليًّا عليه السلام”.
الرد على هذه الشبهة:
هذان الحديثان، لا شكَّ عند أهل المعرفة بالحديث أنهما حديثان موضوعان مكذوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُروَ واحد منهما في شيء من كتب العلم المعتمدة، ولا لواحد منهما إسنادٌ معروف، ولا وجود لهذين الحديثين، لا في كتب الأحاديث الصحيحة، ولا كتب الأحاديث الموضوعة؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ4 صـ286).
الشبهة الثانية:
قال الطاعنون: “إن عمر بن الخطاب قال: متعتان كانتا محلَّلتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليها “.
الرد على هذه الشبهة:
تعريف المتعة:
المتعة: اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج، وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد.
الرد من عدة وجوه:
أولًا: نفترض أن عمر قال قولًا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين.
روى مسلم عن مطرف بن عبدالله بن الشِّخِّير، عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها رجل برأيه ما شاء؛ (مسلم حديث: 1226).
وأهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: روى النسائي عن أبي وائل، أن رجلًا من بني تغلب يقال له: الصبي بن معبد، وكان نصرانيًّا فأسلم، فأقبل في أول ما حج، فلبى بحج وعمرة جميعًا، فهو كذلك يلبي بهما جميعًا، فمر على سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فقال أحدهما: لأنت أضل من جملك هذا، فقال الصبي: فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فقال: هُديت لسُنة نبيك صلى الله عليه وسلم؛ (حديث صحيح؛ صحيح سنن النسائي، للألباني، جـ2 صـ264).
ثالثًا: كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يأمرهم بالمتعة، فيقولون له: إن أباك نهى عنها، فيقول: إن أبي لم يُرد ما تقولون، فإذا ألحُّوا عليه قال: أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تتَّبعوا أم عمر؟
رابعًا: كان مراد عمر رضي الله عنه أن يأمرهم بما هو الأفضل، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج، فأراد ألا يجعل البيت خاليًا طول السَّنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، والاعتمارُ في غير أشهر الحج أفضلُ من المتعة مع الحج في أشهر الحج، باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم.
خامسًا: قال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى:﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196]، قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلِك؛ (أضواء البيان، للشنقيطي جـ4 صـ374).
أراد عمر وعلي رضي الله عنهما أن تسافر للحج سفرًا، وللعمرة سفرًا.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: ((أجرك على قدر نَصَبك))، فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله، فأنشأ العمرة منها، واعتمر قبل أشهر الحج، وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله، ثم حج، فهاهنا قد أتى بكل واحد من النُّسكينِ من دويرة أهله، وهذا إتيان بهما على الكمال، فهو أفضل من غيره؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ4 صـ186: 180).
الشبهة الثالثة:
قال الطاعنون: “إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته: إنه يهجر”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من عدة وجوه:
الهجر: هو الهذيان والتخريف.
روى البخاري عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ((ائتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا))، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ، فقالوا: ما شأنه، أهجر، استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، فقال: ((دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه))، وأوصاهم بثلاث، قال: ((أخرِجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم))، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها؛ (البخاري، حديث: 4431).
أولًا: أن هذه اللفظة (أهجر) لا تثبت عن عمر رضي الله عنه أصلًا، وإنما قالها بعض من حضر الحادثة من غير أن يعيَّن؛ وإنما الثابت فيها: (فقالوا: ما شأنه، أهجر؟) هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد.
ثانيًا: الثابت الصحيح من هذه اللفظة أنها وردت بصيغة الاستفهام هكذا (أهجر؟)، وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايات بلفظ (هجر، ويهجر)، فقد نص شراح الحديث على أن الاستفهام هنا جاء على سبيل الإنكار على من قال: (لا تكتبوا).
ثالثًا: على فرض صحة رواية (هجر) من غير استفهام، فلا مطعن فيها على قائلها؛ لأن الهجر في اللغة يأتي على قسمين:
- قسم لا نزاع في عروضه للأنبياء، وهو عدم تبيين الكلام لبحة الصوت، وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان، كما في الحميات الحارة.
- وقسم آخر: وهو جريان الكلام غير المنتظم، أو المخالف للمقصود على اللسان لعارض بسبب الحميات المحرقة في الأكثر، وهذا لا يجوز في حق الأنبياء؛ لأنهم معصومون عن ذلك.
فلعل القائل هنا أراد القسم الأول، وهو أنا لم نفهم كلامه بسبب ضعف نطقه صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا قوله بعد ذلك: (استفهموه).
رابعًا: يحتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت عن قائلها عن دهش وحيرة أصابته في ذلك المقام العظيم، والمُصاب الجسيم، كما قد أصاب عمر وغيرَه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا؛ فقائلها معذور أيًّا كان معناها؛ فإن الرجل يعذر بإغلاق الفكر والعقل؛ إما لشدة فرح أو حزن، كما في قصة الرجل الذي فقد دابته، ثم وجدها بعد يأس، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطَأَ من شدة الفرح.
خامسًا: هذه اللفظة صدرت بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، فلم ينكِروا على قائلها، ولم يؤثموه، فدلَّ على أنه معذور على كل حال، ولا ينكِر عليه بعد ذلك إلا مفتونٌ في الدين، زائغ عن الحق والهدى، كما هو حال هذا المسكين المعرِّض نفسَه لما لا يطيق؛ (مختصر التحفة الاثني عشرية؛ للدهلوي صـ250: 248).
الشبهة الرابعة:
قال الطاعنون: “قال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتةً؛ أي: فجأةً من غير تريث ولا مشورة، وقى الله المسلمين شرَّها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه؛ وكونها فلتةً يدل على أنها لم تقع عن رأي صحيح، ثم سأل وقاية شرِّها، ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلها، وكان ذلك يوجب الطعن فيه “.
الرد على هذه الشبهة:
قول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتةً؛ معناه: أنها وقعت فجأةً لم نكن قد استعددنا لها ولا تهيأنا؛ لأن أبا بكر كان متعينًا لذلك، فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس؛ إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها، وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه، كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر، فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه، وعمر لم يسأل الله وقاية شرها، بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ8 صـ278).
الشبهة الخامسة:
قال الطاعنون: “روى أبو نعيم في كتابه “حلية الأولياء” أن عمر قال عند احتضاره: يا ليتني كنت كبشًا لقومي فسمنوني ما بدا لهم، ثم جاءهم أحبُّ قومهم إليهم فذبحوني، فجعلوا نصفي شواءً، ونصفي قديدًا، فأكلوني، فأكون عذرةً، ولا أكون بشرًا، وهل هذا إلا مساوٍ لقول الكافر: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ [النبأ: 40]؟”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من وجهين:
أولًا: هذه من مناقب عمر بن الخطاب، وهذا القول يدل على شدة خوف عمر من الله تعالى؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية جـ6 صـ10: 5).
روى البخاري عن المسور بن مخرمة، قال: لما طُعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يُجزِّعه (أي: يزيل جزعَه): يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راضٍ، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راضٍ، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنَّهم وهم عنك راضون، قال: أمَّا ما ذكرتَ من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذاك مَنٌّ مِن الله تعالى مَنَّ به عليَّ، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك مَنٌّ مِن الله جل ذكره منَّ به عليَّ، وأما ما ترى من جزعي، فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه؛ (البخاري، حديث: 3692).
ثانيًا: قولهم: “وهل هذا إلا مساوٍ لقول الكافر: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ [النبأ: 40]؟”، فهذا إخبار عن حالهم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية، وأما في الدنيا، فالعبد إذا خاف ربَّه كان خوفه مما يثيبه الله عليه، فمن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة، فهو كمن جعل الظلمات كالنور، والظلَّ كالحَرُور، والأحياء كالأموات، ومن تولى أمر المسلمين فعدل فيهم عدلًا يشهد به عامتهم، وهو في ذلك يخاف الله أن يكون ظلَم، فهو أفضل ممن يقول كثير من رعيته: إنه ظلم، وهو في نفسه آمنٌ من العذاب، مع أن كليهما من أهل الجنة؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية جـ6 صـ16: 15).
الشبهة السادسة:
قال الطاعنون: لما وعَظت فاطمة أبا بكر في فدك، كتب لها كتابًا بها، وردَّها عليها، فخرجت من عنده، فلقيها عمر بن الخطاب، فحرق الكتاب، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من وجهين:
أولًا: هذا من الكذب الذي لا يشك فيه عالم، ولم يذكر هذا أحدٌ من أهل العلم بالحديث، ولا يُعرف له إسناد، وأبو بكر لم يكتب فدكًا قط لأحد؛ لا لفاطمة، ولا غيرها، ولا دعت فاطمةُ على عمر.
ثانيًا: ما فعله أبو لؤلؤة المجوسي كرامة في حق عمر رضي الله عنه، وهو أعظم مما فعله ابن ملجم بعلي رضي الله عنه، وما فعله قتلة الحسين رضي الله عنه به؛ فإن أبا لؤلؤة كافرٌ قتل عمر، كما يقتل الكافر المؤمن، وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية جـ6 صـ31: 30).
الشبهة السابعة:
قال الطاعنون: “إن عمر بن الخطاب عطل حدود الله، فلم يُقم الحد على المغيرة بن شعبة”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من وجهين:
أولًا: جماهير العلماء مؤيدون ما فعله عمر في قصة المغيرة بن شعبة؛ حيث اتهم بعض الناس المغيرة بارتكاب جريمة الزنا، وأن البيِّنة إذا لم تكمل، أقيمَ الحد على الشهود، ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد.
ثانيًا: الذي فعله في قصة المغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، وأقروه على ذلك، وعليٌّ منهم، والدليل على إقرار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد، أعاد أبو بكرة القذف، وقال: والله لقد زنى، فهمَّ عمر بجلده ثانيًا، فقال له علي: إن كنت جالده فارجم المغيرة، يعني أن هذا القول إن كان هو الأول، فقد حد عليه، وإن جعلته بمنزلة قول ثانٍ فقد تم النصاب أربعة، فيجب رجمه، فلم يحده عمر، وهذا دليل على رضا عليِّ بن أبي طالب بحدهم أولًا دون الحد الثاني، وإلا كان أنكر حدهم أولًا، كما أنكر الثاني؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ35: 34).
الشبهة الثامنة:
قال الطاعنون: “كان عمر بن الخطاب يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، وكان يعطي عائشة وحفصة من المال في كل سنةٍ عشرةَ آلاف درهم”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من وجهين:
أولًا: أما حفصة، فكان ينقصها من العطاء لكونها ابنته، كما نقص عبدَالله بن عمر، وهذا من كمال احتياطه في العدل، وخوفه مقامَ ربه، ونهيه نفسَه عن الهوى.
ثانيًا: كان عمر يرى التفضيل في العطاء بالفضل، فيُعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعظَمَ مما يعطي غيرَهن من النساء، كما كان يعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثر مما يعطي أعدادهم من سائر القبائل، فإذا فضل شخصًا كان لأجل اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لسابقته واستحقاقه، وكان يقول: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، وإنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته، فما كان يعطي من يُتهمُّ على إعطائه بمحاباة في صداقة أو قرابة، بل كان ينقص ابنَه وابنته ونحوهما عن نظرائهم في العطاء، وإنما كان يفضل بالأسباب الدينية المحضة، ويفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع البيوتات ويقدِّمهم؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ35: 34).
الشبهة التاسعة:
قال الطاعنون: “كان عمر بن الخطاب قليل المعرفة بالأحكام؛ أمر برجم حامل، فقال له علي بن أبي طالب: إن كان لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأمسك، وقال: لولا عليٌّ لهلك عمر”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من وجهين:
أولًا: هذه القصة إن كانت صحيحةً، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل، فأخبره علي بن أبي طالب بحملها، ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل، فعرَّفه بعض الناس بحالها، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس المغيبات، ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود، وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم، وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية.
وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم، فلما ذكَّره عليٌّ ذكَر ذلك؛ ولهذا أمسك، ولو كان رأيه أن الحامل تُرجم لرجمها، ولم يرجع إلى رأي غيره، وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية، لما قالت: إني حبلى من الزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذهبي حتى تضعيه)).
ثانيًا: لو افترضنا أنه خفي على عمر علم هذه المسألة حتى عرفه، لم يقدح ذلك فيه؛ لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمة، يعطي الحقوق، ويقيم الحدود، ويحكم بين الناس كلِّهم، وفي زمنه انتشر الإسلام، وظهر ظهورًا لم يكن قبله مثله، وهو دائمًا يقضي ويفتي، ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك، فإذا خفيت عليه قضيةٌ من مائة ألف قضية، ثم عرفها، أو كان نسيها فذكَرَها، فأيُّ عيب في ذلك؟!
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد خفي عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف ذلك، ومنها ما مات ولم يعرفه؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ43: 41).
الشبهة العاشرة:
قال الطاعنون: “أمر عمر بن الخطاب برجم مجنونة؛ فقال له عليٌّ رضي الله عنه: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك، وقال عمر: لولا عليٌّ لهلك عمر”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من عدة وجوه:
أولًا: قولهم: “قال عمر: لولا عليٌّ لهلك عمر”؛ هذه الزيادة ليست معروفةً في هذا الحديث.
ثانيًا: رجم المجنونة لا يخلو: إما أن يكون لم يعلم بجنونها، فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ناسيًا ذلك فذكر بذلك.
ثالثًا: العقوبات تكون لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقَب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هو من العدوان.
والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((مُرُوهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع))، والمجنون إذا اعتدى، ولم يندفع اعتداؤه إلا بقتله، قُتل، بل البهيمة إذا اعتدت ولم يندفع اعتداؤها إلا بقتلها قُتلت، وإن كانت مملوكةً لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ46: 45).
الشبهة الحادية عشرة:
قال الطاعنون: “قال عمر بن الخطاب في خطبة له: من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾ [النساء: 20]؟ فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر”.
الرد على هذه الشبهة:
هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه، ورجوعه إلى الحق إذا تبيَّن له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة، ويتواضع له، وأنه معترف بفضل الواحد عليه، ولو في أدنى مسألة، وليس من شرط الأفضل ألا ينبهه المفضول لأمر من الأمور، فقد قال الهدهد لسليمان صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ [النمل: 22]، وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم للخضر: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف: 66]، والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ77: 76).
الشبهة الثانية عشرة:
قال الطاعنون: “ولم يُقم عمر بن الخطاب حد الخمر على قدامة بن مظعون؛ لأنه تلا عليه: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ﴾ [المائدة: 93]، فقال له علي بن أبي طالب: ليس قدامة من أهل هذه الآية، فلم يدر كم يحده، فقال له أمير المؤمنين: حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذَى، وإذا هذَى افترى”.
الرد على هذه الشبهة:
هذا من الكذب البيِّن الظاهر على عمر رضي الله عنه؛ فإن علم عمر بن الخطاب بالحكم في مثل هذه القضية أبينُ من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله، وكانوا يضربون فيها تارةً أربعين وتارةً ثمانين، وكان عمر أحيانًا يعزر فيها بحلق الرأس والنفي، وكانوا يضربون فيها تارةً بالجريد، وتارةً بالنعال والأيدي وأطراف الثياب؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ83: 82).
الشبهة الثالثة عشرة:
قال الطاعنون: “أرسل عمر بن الخطاب إلى حامل يستدعيها، فأسقطت جنينها خوفًا من عمر، فقال له الصحابة: نراك مؤدبًا ولا شيء عليك، ثم سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأوجب الدية على عاقلة عمر”.
الرد على هذه الشبهة:
هذه مسألة اجتهاد اختلف فيها العلماء، وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة رضي الله عنهم في الحوادث، يشاور عثمان، وعليًّا، وعبدالرحمن بن عوف، وابن مسعود، وزيد بن ثابت وغيرهم؛ حتى كان يشاور ابن عباس، وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه؛ ولهذا كان من أسَدِّ الناس رأيًا، وكان يرجع تارةً إلى رأي هذا، وتارةً إلى رأي هذا، وهذا لا عيب فيه؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ88: 87).
الشبهة الرابعة عشرة:
قال الطاعنون: “أمر عمر بن الخطاب برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فقال له علي بن أبي طالب: إن خاصمتك بكتاب الله تعالى خصمتك، إن الله يقول: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، وقال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]”.
الرد على هذه الشبهة:
كان عمر يستشير الصحابة؛ فتارةً يشير عليه عثمان بما يراه صوابًا، وتارةً يشير عليه علي، وتارةً يشير عليه عبدالرحمن بن عوف، وتارةً يشير عليه غيرهم، وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38]؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ93).
الشبهة الخامسة عشرة:
قال الطاعنون: “كان عمر بن الخطاب يفضل في الغنيمة والعطاء، وأوجب الله تعالى التسوية”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من عدة وجوه:
أولًا: أما الغنيمة، فلم يكن يقسمها هو بنفسه، وإنما يقسمها الجيش الغانمون بعد الخُمُس، وكان الخمس يرسل إليه، كما يرسل إلى غيره، فيقسمه بين أهله.
ثانيًا: لم يقل عمر ولا غيره: إن الغنيمة يجب فيها التفضيل، ولكن تنازع العلماء: هل للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض، إذا تبين له زيادة نفع؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، إحداهما: أن ذلك جائز، وهو مذهب أبي حنيفة.
روى مسلم عن سلمة بن الأكوع (في غزوة الغابة): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان خيرَ فُرساننا اليوم أبو قتادة، وخيرَ رجَّالتنا سلمةُ))، قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمينِ: سهمَ الفارسِ، وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعًا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء (بعير النبي صلى الله عليه وسلم) راجعين إلى المدينة؛ (مسلم حديث: 1807).
وذلك لأن سلمة بن الأكوع أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأت به غيرُه.
والقول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي، ومالك يقول: لا يكون النفل إلا من الخُمُس، والشافعي يقول: لا يكون إلا من خمس الخمس؛ فهذه مسألة اجتهاد، فإذا كان عمر يرى التفضيل للمصلحة، فهو الذي ضرب الله الحقَّ على لسانه وقلبه.
ثالثًا: أما التفضيل في العطاء، فلا ريب أن عمر كان يفضِّل فيه، ويجعل الناس فيه على مراتب، وهذا اجتهاد منه، وروي عن عمر أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بابًا واحدًا؛ أي: نوعًا واحدًا (يسوِّي بين جميع الناس في العطاء)، وكان أبو بكر يسوي في العطاء، وكان عليٌّ يسوي أيضًا، وكان عثمان يفضل، وهي مسألة اجتهاد، فهل للإمام التفضيل فيه للمصلحة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، والتسوية في العطاء اختيار أبي حنيفة والشافعي، والتفضيل قول مالك؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ102: 100).
الشبهة السادسة عشرة:
قال الشيعة الروافض: “كان عمر بن الخطاب يقول بالرأي والظن”.
الرد على هذه الشبهة:
القول بالرأي لم يختص به عمر رضي الله عنه، بل عليٌّ كان من أقولهم بالرأي، وكذلك أبو بكر وعثمان وزيد وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بالرأي؛ أي: بالاجتهاد في الأمور التي ليس فيها نص من القرآن أو السُّنة.
روى أبو داود، عن قيس بن عباد، قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهْدٌ عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم رأي رأيته؟ فقال: “ما عهد إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه رأيٌ رأيته”؛ (حديث صحيح؛ صحيح أبي داود، للألباني، حديث: 3900).
ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذمومًا، فلا لوم على من قال به؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ6 صـ113: 111).
الشبهة السابعة عشرة:
قال الطاعنون: “قول عمر بن الخطاب: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يمت، هذا يدل على قلة علمه”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من وجهين:
أولًا: كون عمر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فهذا كان ساعةً، ثم تبين له موته، ومثل هذا يقع كثيرًا؛ قد يشك الإنسان في موت ميت ساعةً وأكثر، ثم يتبين له موته، وهذا ليس عيبًا، وعلي بن أبي طالب قد تبين له أمور بخلاف ما كان يعتقده فيها أضعاف ذلك؛ بل ظن كثيرًا من الأحكام على خلاف ما هي عليه، ومات على ذلك، ولم يقدح ذلك في إمامته؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية جـ8 صـ301: 300).
ثانيًا: إن ذلك القول قد يكون صدر من عمر رضي الله عنه من شدة دهشته بموت الرسول، وكمال محبته له صلى الله عليه وسلم؛ حتى لم يبق له في ذلك الحين شعورٌ بشيء، وكثيرًا ما يحصل الذهول بسبب تفاقم المصائب وتراكم الشدائد؛ لأن النسيان والذهول من اللوازم البشرية؛ ألا ترى أن يوشع بن نون – مع كونه نبيًّا معصومًا – نسي أن يخبر موسى بفقد الحوت مع المكتل، بل إن موسى صلى الله عليه وسلم – مع كونه من أولي العزم – قد نسي معاهدته مع الخضر على عدم السؤال ثلاث مرات، وقال تعالى في حق آدم صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: 115]؛ (مختصر التحفة الاثني عشرية؛ للدهلوي صـ252).
الشبهة الثامنة عشرة:
قال الطاعنون: “ابتدع عمر بن الخطاب صلاة التراويح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعةً بدعةٌ، وصلاة الضحى بدعة، فإن قليلًا في سنة خيرٌ من كثير في بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار))، وخرج عمر في شهر رمضان ليلًا فرأى المصابيح في المساجد، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع، فقال: بدعة ونعمت البدعة، فاعترف بأنها بدعة”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من عدة وجوه:
أولًا: ما الدليل على صحة هذا الحديث؟ وأين إسناده؟ وفي أي كتاب من كتب الحديث روي هذا؟ ومن قال من أهل العلم بالحديث: إن هذا صحيح؟
الثاني: جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون أن هذا من الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدنى مَن له معرفة بالحديث يعلم أنه كذب لم يروه أحد من المسلمين في شيء من كتبه؛ لا كتب الصحيح ولا السنن ولا المسانيد، ولا يعرف له إسناد؛ لا صحيح ولا ضعيف، بل هو كذب بيِّن.
الثالث: أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلُّون بالليل في رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صلى بالمسلمين جماعةً ليلتين أو ثلاثًا، وقول عمر: (نعمت البدعة هذه)؛ يقصد بالبدعة هنا: معناها اللغوي؛ أي: العمل البديع.
الرابع: لو كانت صلاة التراويح بدعة لأبطلها عليُّ بن أبي طالب لمَّا صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة، فلما كان جاريًا في ذلك مجرى عمر دلَّ على استحباب ذلك؛ (منهاج السنة؛ لابن تيمية، جـ8 صـ308: 304).
روى البيهقي عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: “دعا القرَّاء في رمضان، فأمر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعةً”، قال: وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم؛ (السنن الكبرى؛ للبيهقي جـ2 صـ699).
روى البيهقي عن عرفجة الثقفي قال: “كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إمامًا، وللنساء إمامًا” قال عرفجة: “فكنت أنا إمام النساء”؛ (السنن الكبرى؛ للبيهقي جـ2 صـ695).
الشبهة التاسعة عشرة:
يقول الطاعنون: “ابتدع عمر بن الخطاب وقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثًا”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من عدة وجوه:
أولًا: لم يبتدع عمر ذلك، وما كان عمر ليبتدع، بل لا يُعرَف في الصحابة مبتدع.
ثانيًا: ما فعله عمر يعتبر من السياسة الشرعية، لا من التشريع، وبينهما فرق:
التشريع: هو سَنُّ أمر لم يكن في شريعة الإسلام، كأن يأتي أحد فيسن ويشرِّع للناس الحج لغير مكة؛ كالحج إلى كربلاء، أو إلى النجف! أو فرض خمس في أموال الناس، ونحو ذلك!
والسياسة الشرعية: أن يأخذ الناس بالحزم في أمر مشروع.
فللحاكم أن يأخذ الناس بالسياسة الشرعية، ويلزمهم بأمر رآهم توسعوا فيه، ولهذا أصلٌ في السنة النبوية.
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال»، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تُواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيكم مثلي؟ إني أبِيتُ يطعمني ربي ويسقينِ))، فلما أبَوا أن ينتهوا عن الوصال، واصَل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: ((لو تأخر لزدتكم))؛ كالمنكِّل بهم حين أبَوا؛ (البخاري حديث: 6851، مسلم حديث: ١١٠٣).
ثالثًا: من باب السياسة الشرعية إلزام الناس بالطلاق الثلاث؛ أي: إيقاعها، وهذا ليس تشريعًا؛ فإن التشريع لو أن أحدًا قال: يزاد طلقة رابعة – مثلًا – فإن هذا هو التشريع، أما إلزام الناس بأمر مشروع، فهذا ليس من باب التشريع، إنما هو من باب السياسة الشرعية، والناس إذا رأوا أنه ضيق عليهم في أمر كان لهم فيه سَعة، كان أدعى للزجر، وهذا الذي ذهب إليه عمر.
روى مسلم عن ابن عباس، قال: “كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدةً، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم”؛ (مسلم حديث: 1472).
رابعًا: هذا الأمر قد وافق الصحابةُ عليه عمرَ بن الخطاب، وهم متوافرون.
خامسًا: لم يزعم عمر بن الخطاب نسخ العمل بالثلاث أن تكون واحدة، وإنما أخذ بذلك، وهذا كالذي يأخذ بأمر واحد من كفارة اليمين، أو يصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية؛ فالذي يكفِّر عن يمينه بالإطعام، ويلتزم هذا، لا يعتبر مشرعًا، وإنما أخذ ببعض ما شرع مما له فيه اختيار، وكذلك الذي يصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة، لا يعتبر معطلًا لما شرعه الله، وإنما أخذ ببعض ما له فيه خيار، وكذلك القول بالنسبة للطلاق الثلاث، وما اختاره عمر فيها؛ (شبهات طال حولها الجدل صـ703: 699).
الشبهة العشرون:
قال الطاعنون: “أدخل عمر قول: الصلاة خير من النوم، في الأذان”.
الرد على هذه الشبهة:
هذا كذب وافتراء على عمر بن الخطاب؛ لأن قول: الصلاة خير من النوم، من السُّنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى أبو داود عن أبي محذورة، قال: قلت: يا رسول الله، علِّمني سنة الأذان؟ قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: ((تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله))؛ (حديث صحيح؛ صحيح أبي داود، للألباني حديث: 472).
الشبهة الحادية والعشرون:
يقول الطاعنون: “أراد عمر بن الخطاب أن يحرق بيت فاطمة الزهراء”.
الرد على هذه الشبهة:
سبحانك هذا بهتان عظيم!
الرد من عدة وجوه:
أولًا: نريد سندًا صحيحًا لهذه الرواية؟
ثانيًا: هل يظن أحد من المسلمين أن يفعل عمر بن الخطاب ذلك بأهل بيت نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ (مختصر التحفة الاثني عشرية؛ للدهلوي صـ252).
ثالثًا: محبة عمر بن الخطاب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثابتةٌ ومعلومة لكل مسلم.
روى أحمد عن زيد بن أسلم قال: لمَّا بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليٌّ والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها، فبلغ عمر فدخل على فاطمة، فقال: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك، وكلمها، فدخل عليٌّ والزبير على فاطمة، فقالت: انصرفا راشدين، فما رجعا إليها حتى بايعا؛ (فضائل الصحاب؛ لأحمد بن حنبل صـ364).
رابعًا: محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ثابتة:
(1) روى البخاري عن ابن أبي مُليكة، أنه سمع ابن عباس، يقول (وهو يتحدث عن موت عمر): وضع عمر على سريره فتكنفه الناس (أحاطوا به) يدْعون ويصلُّون قبل أن يُرفع وأنا فيهم، فلم يرعني (يفاجئني) إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر، وقال: ما خلفت أحدًا أحب إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرًا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر))؛ (البخاري حديث: 3685).
(2) إن من دلالة محبة أهل البيت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تسمية أبنائهم باسمه؛ حبًّا وإعجابًا بشخصيته، وتقديرًا لما أتى به من الأفعال الطيبة والمكارم العظيمة، ولما قدَّم إلى الإسلام من الخدمات الجليلة، وإقرارًا بالصِّلات الودية الوطيدة التي تربطه بأهل بيت النبوة، والرحم والصهر القائم بينه وبينهم، فأول من سمَّى ابنه باسمه أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب، سمى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية عمرَ، وتبعه الحسنُ بن علي في ذلك الحبِّ لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ فسمى أحد أبنائه عمرَ أيضًا، وكذلك الحسين بن على سمَّى عمرَ، ومن بعد الحسين ابنه علي الملقَّب بزين العابدين سمَّى أحد أبنائه باسم عمر، وكذلك موسى بن جعفر الملقب بالكاظم سمى أحد أبنائه باسم عمر.
فهؤلاء الأئمة من أهل البيت الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعالم منهج أهل السنة والجماعة بسيرتهم العطرة – يُظهِرون لعمر الفاروق ما يكنُّونه في صدورهم من حبِّهم وولائهم له بعد وفاته بمدة، وقد جرى هذا الاسم – وكذلك أبو بكر وعثمان – في ذرية أهل البيت ممن ساروا على مذهب الحق، وهو منهج أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا؛ (علي بن أبي طالب؛ لعلي محمد الصلابي صـ146).
(3) قال حفص بن قيس: سألت عبدالله بن الحسن عن المسح على الخفين، فقال: امسح؛ فقد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قلت: إنما أسألك أنت تمسح؟ قال: ذاك أعجز لك، أُخبرك عن عمر، وتسألني عن رأيي؟! فعمر كان خيرًا مني، ومن ملء الأرض، فقلت: يا أبا محمد، فإن ناسًا يزعمون أن هذا منكم تقية؟ قال: فقال لي – ونحن بين القبر والمنبر -: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانية، فلا تسمعن عليَّ قول أحد بعدي؛ (النهي عن سب الأصحاب؛ لمحمد بن عبدالواحد المقدسي، صـ70 رقم: 24).
الشبهة الثانية والعشرون:
قال الطاعنون: “ضرب عمر بن الخطاب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسقطت ولدها محسنًا، وهو في بطنها”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من عدة وجوه:
أولًا: نريد من الطاعنين أن يأتوا بإسناد صحيح لهذه الرواية، إن كانوا صادقين!
ثانيًا: الدليل على كذب هذه الرواية أن محسنًا قد ولدته فاطمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا: هذه الرواية فيها اتهام مباشر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالجبن، وأنه كان يخاف من عمر بن الخطاب؛ (علي بن أبي طالب؛ لعلي محمد الصلابي صـ142).
الشبهة الثالثة والعشرون:
قال الطاعنون: “إن عمر بن الخطاب لم يعط أهل البيت سهمهم من الخُمس الثابت بقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: 41]، فقد خالف حكم الله تعالى”.
الرد على هذه الشبهة:
الرد من عدة وجوه:
أولًا: سبحانك هذا بهتان عظيم! إذا لم يكن عمر بن الخطاب هو الذي يحكم بشرع الله تعالى، فمَن يحكم؟!
ثانيًا: فعلُ عمر موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو بكر وعمر يخرجان سهم ذوي القربى من الخمس، ويعطيانه لفقراء أهل البيت ومساكينهم، كما كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (مختصر التحفة الاثني عشرية؛ للدهلوي صـ255).
ثالثًا: روى الطحاوي عن ابن إسحاق، قال: سلك عليُّ بن أبي طالب في سهم ذوي القربى لما ولي الخلافة – مسلكَ أبي بكر وعمر؛ (إتحاف المهرة؛ لابن حجر العسقلاني جـ11 صـ616رقم: 14739).
الشبهة الرابعة والعشرون:
قال الطاعنون: “لما أقبل الناس لمبايعة أبي بكر الصديق، كادوا يطؤون سعد بن عبادة بأقدامهم، فقال أصحاب سعد: انتبهوا، لا تطؤوا سعدًا بأقدامكم، فقال عمر: اقتلوه، قتله الله، ثم قام عمر على رأس سعد فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تسقط أعضاؤك، فأخذ قيس بن سعد بن عبادة بلحية عمر، وقال له: لو مسست من أبي شعرةً، ما رجعت إلى دارك سالمًا؛ فقال أبو بكر الصديق: مهلًا يا عمر، الرفق هنا أبلغ، فأعرض عمر عن سعد، وانصرف”.
الرد على هذه الشبهة:
سبحانك هذا بهتان عظيم على عمر بن الخطاب! والرد من عدة وجوه:
أولًا: نقول لهؤلاء الطاعنين: نريد منكم أن تأتوا بسند صحيح لهذه الرواية، إن كنتم صادقين.
ثانيًا: لم يطلب عمر بن الخطاب قتل سعد بن عبادة، وذلك بدليل ما رواه البخاري عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب قال (وهو يتحدث عما حدث في سقيفة بني ساعدة): قال أبو بكر الصديق: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايِعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدَّم فتُضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، أحبَّ إليَّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إليَّ نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن؛ فقال قائل من الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش، فكثر اللغط (الصوت والضجيج)، وارتفعت الأصوات، حتى فَرِقْتُ (خشيت) من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعتْه الأنصار، ونزونا (وثبنا عليه) على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة (خذلتموه وأعرضتم عنه)، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة؛ (البخاري حديث: 6830).
ثالثًا: قول عمر: (قتل الله سعد بن عبادة) مقصود به أن الله تعالى هو الذي قدر خذلان سعد بن عبادة، وعدم صيرورته خليفة، أو أن يكون المقصد بقول عمر الدعاء على سعد بن عبادة؛ لأن موقفه كان ربما أحدث فُرقة في المسلمين؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ7 صـ39).
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.