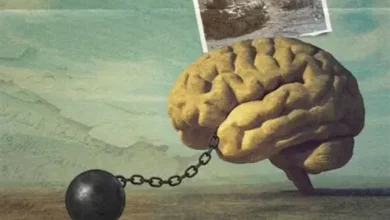درء بعض الشبهات حول تعريف الصحابي
وَرَدَت في كتب علم مصطلح الحديث عدَّةُ تعريفاتٍ للصحابيِّ، تختلف فيما بينها بعض الاختلاف النظريِّ، بمعنى أنَّه اختلاف لا ينبني عليه تصحيحُ حديثٍ ما أو تضعيفه، وبالتالي لا ينبني عليه تحليلٌ أو تحريم أو إنزال حكم فقهيٍّ على أحد أفعال المكلَّفين.
لكن كل التعريفات تتفق على وجود ركنين فيمن يوصَف بأنَّه صحابيٌّ؛ أولهما: أن يكون مؤمنًا بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ليخرج الكفار والمنافقون من هذا التعريف، وثانيهما: لقاؤه بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، مع وجود اختلافٍ بينهم في تحديد مدَّة هذا اللقاء.
ويوجِّه البعض مجموعةً من الإشكاليات والأسئلة حول شرط الإيمان؛ نحاول مناقشتها فيما يلي:
يقولون أولًا: إن الإيمان أمر قلبيٌّ لا نستطيع معرفته، وبالتالي فمعرفة الصحابيِّ مستحيلة.
ويقولون ثانيًا: إنَّ الله سبحانه وتعالى نفى معرفةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمنافقين من أهل المدينة حين قال: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: 101]، فمن باب أولى أن نجهلهم نحن ولا نعرفهم.
ويقولون ثالثًا– بناءً على ما سبق -: لا ينبغي أن نأخذ بغير الحديث المتواتر الذي يرويه جَمْعٌ يستحيل تواطؤه على الكذب.
والرد على الإشكال الأوَّل – وهو أنَّ الإيمانَ قلبيٌّ – في نقاط:
أولًا: إنَّ الإيمان ليس شرطًا في تحديد وإثبات صفة الصحابيِّ لشخصٍ من المعاصرين للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو شرط شامل لكلِّ تصرُّفات المسلم.
فمِن شروطِ الإمام في الصلاة – مثلًا – أن يكون مسلمًا، وبناءً على هذا الاعتراض سنقول بأنَّ صلاة الجماعة ملغاةٌ؛ لأنَّ الإيمان أمر قلبيٌّ لا نستطيع معرفته، وبالتالي لا نستطيع الصلاة خلف أيِّ إنسان إلا إذا شقَقْنا عن قلبه، وحتى حل التواتر المذكور في (ثالثًا) لن يفيد هاهنا، إلا أن يقول أحدُهم: نعيد الصلاة مرَّات كثيرة خلف أئمَّة كُثُر؛ حتى يتحقَّق عدد التواتر.
ومن شروط الزوج في الإسلام أن يكون مسلمًا، فلا يحل للمسلم أن يزوِّج ابنته لشخصٍ غيرِ مسلم، فهل سيقول هؤلاء لمن يريدون خطبة بناتِهم: أثْبِتُوا لنا أنَّكم مسلمون مؤمنون؛ فالإيمان عمل قلبيٌّ؟!
وهكذا أمثلة كثيرة لأفعال وعبادات مبنيَّة على إيمان الطرف الآخَر الذي نتعامل معه، فهل يطرُد المعترض – ومَن يشاركه الرأيَ – حجَّتَهم التي بنوا عليها تشكيكَهم في السُّنَّة النبويَّة، أم أنَّ الأمر مختصٌّ بالسُّنَّة فقط دون سواها، وما الدليل على التفريق؟
فهذه الحجَّة إذًا يقِرُّ مثيرُها بسلوكه اليوميِّ وتعاملاته مع الناس بأنَّها سفسطةٌ لا أكثر.
وبإمكاننا لو اعتبرناها قضيةً صحيحةً أن نجعلها مقدِّمة للتوقُّف في حال مثيرها نفسه، والتساؤل عن كونه مؤمنًا أم كافرًا؛ فإيمانه هو أيضًا عمل قلبيٌّ لا نستطيع معرفته، فدعك يا هذا من تحديد المؤمنين من الصحابة، وأَثْبِتْ لنا أنَّك مؤمن بالله ورسوله؛ فإيمانك أنت أيضًا عمل قلبيٌّ.
ثانيًا: إنَّ الإيمان عمل قلبيٌّ لا ريب، لكنَّ آثاره لا تترتَّب عليه إلا إذا وجدنا من العمل ما يصدِّقها ويثبت صحَّتها.
وهذا الأمر مشترَك في كلِّ الأعمال القلبية؛ كالحب والبغض مثلًا، نستطيع التيقُّن من وجودها من خلال أفعال المتصفين بها، فمَن يُكثِر من قراءة القرآن والصلاة، نستطيع معرفة عملِ قلبِه الذي هو حبُّ القرآن، ومَن بذل جهده ووقته للتشكيك في سُنَّة النبيِّ صلى الله عله وسلم وفي عدالة أصحابه، نستطيع كذلك بكلِّ سهولةٍ معرفةَ بُغضه لسنَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من خلال تصرُّفه هذا.
فنستطيع إذًا معرفة هذا العمل القلبيِّ من خلال الأفعال الظاهرة، ونحن مطالبون بالأحكام الظاهريَّة فقط، أمَّا ما في القلوب، فحكمه عند علَّام الغيوب.
وبمراجعة سيرة رواة الأحاديث من الصحابة، نستطيع معرفةَ ممارستِهم لأفعالٍ تدلُّ على وجود الإيمان في قلوبهم، كما استطاع معاصروهم تحديدَ ذلك.
ثالثًا: أحكام النبيِّ صلى الله عليه وسلم على المعاصرين له تنقسم إلى ثلاثةِ أقسام، ودليل الحصر في هذه الأقسام الثلاثة هو القسمة العقليَّة، والأقسام هي:
- مَن وَصَفَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالكفر، فهذا لا شك في كفره وفي أنه ليس من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
- مَن وَصَفَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإيمان وشهد له بذلك، وهذا أيضًا لا شك في إيمانه، فما دام الإيمان عمل قلبيٌّ لا يعلمه إلا الله تعالى كما يقول المعترض، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا أَثْبَتَه لشخصٍ، فهذا يدلُّ على أنه عرَف وجوده بواسطة الوحي الإلهيِّ، فلا يكون إلا صدقًا، والنفي الوارد في الآية قضيَّة جزئيَّة سالبة لا يمكن تعميمها لتصبح قضيةً كليةً أو في قوَّة الكلية.
والغالبية الساحقة من الصحابة الذين رَوَوا لنا الأحاديث هم من هذه الفئة الثانية، والأدلَّة على إيمانهم موجودةٌ في كتب المناقب والسِّيَر في كتب الحديث، وفي كتب التراجم، والجزم بإيمانهم من المتواتر المعنويِّ الذي لا يحتاج لاستدلال.
- مَن لم يصفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإيمانٍ أو كفرٍ مِن معاصريه، وهؤلاء نسبتهم – كما سبق في رواية الحديث – قليلة وضئيلة جدًّا، وغالب ما يرْوُونه يشاركهم في روايته الصحابةُ المكثرون الذين لا نشكُّ في إيمانهم.
فلماذا نفترض أنَّ الجميع من الفئة الثالثة فحسب، ونتجاهل وجود فئتين أُخْرَيَين؟
ومن المهمِّ أن نشير إلى أنَّ غالبية الأحاديث التي يتداولها أعداء السُّنة فيما بينهم مما يشترك في روايته السُّنَّة والشيعة، فيرويه السُّنَّة عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ويرويه الشيعة عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومَن تتبَّع عَرَفَ ذلك، وليس المقصود إقرار الشيعة على منهجهم، ولكن ندينهم من بعض ما جاء فيه.
أمَّا الإشكال الثاني، وهو الاستدلال بآيةِ سورة التوبة: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: 101].
فالرد عليه في نقاط
أولًا: ليتك أيها المعترض أكملتَ نَصَّ الآية ولم تورد نصفَها الأوَّل فقط؛ كشأن المستدلِّ على حرمة الصَّلاة بقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون: 4]، ويترك: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: 5].
النص الكامل للآية: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: 101]؛ فالآية إذًا تنفي علم النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنافقين وقتَ نزولها، لكنها تخبر كذلك بأنَّ الله سيعذِّبهم مرَّتين قبل عذاب يوم القيامة.
فمَن لم نستطع أن نُثْبِت حصولَ هذين العذابين له، فلا نستطيع الزعم بأنه من هؤلاء المنافقين.
ثانيًا: لا بدَّ من جمع كلِّ الآيات المتعلِّقة بمحلِّ النزاع، فإن كانت هذه الآية تنفي معرفةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهم وقتَ نزولها، فثمَّة آياتٌ أخرى تؤكِّد معرفتَه بأشخاصهم فيما بعد هذا.
يقول تعالى في سورة محمد: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 30]؛ فهذه الآيات تخبر بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سيعرف أشخاصَ هؤلاء المنافقين، بل وتحدِّد الوسيلةَ التي سيعرفهم بها، وهي لحن قولهم، وسبحان مَن جَعَلَ لحنَ القول فاضحًا للمنافقين في كلِّ زمان!
وقد أجمع السُّنَّة والشيعة على معرفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنافقين فيما بعد، وتمييزهم عن غيرهم فردًا فردًا، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّة وقرائنَ كثيرةٍ؛ منها قصة الثلاثة الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوكَ، وورد فيها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَبِل اعتذار كلِّ مَن اعتَذَرَ مِن المنافقين ما عدا هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم لم يكونوا من المنافقين.
أمَّا عند الشيعة، فإنَّ الولاية التكوينيَّة كافية في معرفة ما تخفيه الصدور من نوازع الخير والشر، فضلًا عن الإيمان والكفر؛ فاتفق الطرفان مع اختلاف المناهج.
والنقطة الثانية في الرد على الإشكال الأوَّل نافعةٌ لرد هذا الإشكال الثاني أيضًا، ومحصلتها أنَّ عدم معرفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بحال البعض لا يعني رد شهادته بالإيمان للبعض الآخَر؛ فهو لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه.
أمَّا الإشكال الثالث، وهو اللجوء إلى المتواتر دون الآحاد، ففيه مغالطة قبيحة، وهي مغالطة الحصر الكاذب.
فالمعترض يجعل اليقينيَّاتِ منحصرةً في المتواترات فقط دون غيرها، ويتجاهل أنَّ اليقينيات تضمُّ نوعًا آخَر، هو خبر الآحاد المحتف بالقرائن الدالَّة على صحَّته.
فإذا وصلني مثلًا عن طريق عددٍ كبير يصل لحدِّ التواتر بوجود حريقٍ في مكانٍ قريب مني، تيقَّنت بناءً على هذا الإخبار بوجود الحريق، وكذلك سأتيقَّن منه إذا وَرَدَني الخبر عن أشخاص عددهم يقلُّ عن التواتر ووجدت قرينةً تؤكِّد قولَهم؛ مثل: وجود دخان ورائحة تدلُّ على وجود الحريق.
فأحاديث الآحاد التي احتفت بها القرائن يقينية أيضًا، ومن القرائن سكوت باقي المتلقِّين للحديث من الصحابة عن تكذيب القائل والرد عليه إذا كان يخالف ما عندهم، فسكوتُهم إذًا إقرارٌ بصحَّة ما سمعوه مِن نقلٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وثمة قرائن أخرى كثيرة مبثوثة في كتب علم مصطلح الحديث ترفع حديثَ الآحاد الصحيح لدرجة القطع واليقين، وكثير من ذلك موجودٌ في كتب علم المنطق وفلسفة المعرفة أيضًا.
والدعوة للأَخْذ بالأحاديث المتواترة فقط دون غيرها هي دعوة من دعاوى زنادقة العصر، الساعين لهدم الإسلام عن طريق التشكيك في السُّنَّة؛ اتباعًا لسنن سلفهم من المنافقين في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيتظاهر الواحد منهم بغيرته على السُّنَّة وحرصِه على الدين، وغايةُ كلامه خروجٌ من الملَّة وكفر بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فالأحاديث المتواترة لفظًا عددُها يقارب الثلاثمائة حديث فقط كما جَمَعَها الإمام السيوطي، وغالبه مما يُنكره زنادقة عصرِنا مِن دعاة التنوير؛ كالحديث عن الصراط والحوض والميزان وغير ذلك.
والتواتر ليس شرطًا مِن شروط الصحَّة والحجيَّة أبدًا، فما هو إلا نوعٌ من أنواع المقبول وأعلاها درجةً، وهذا لا ينفي وجود غيره.
والله يتولَّانا ويتولَّاكم.